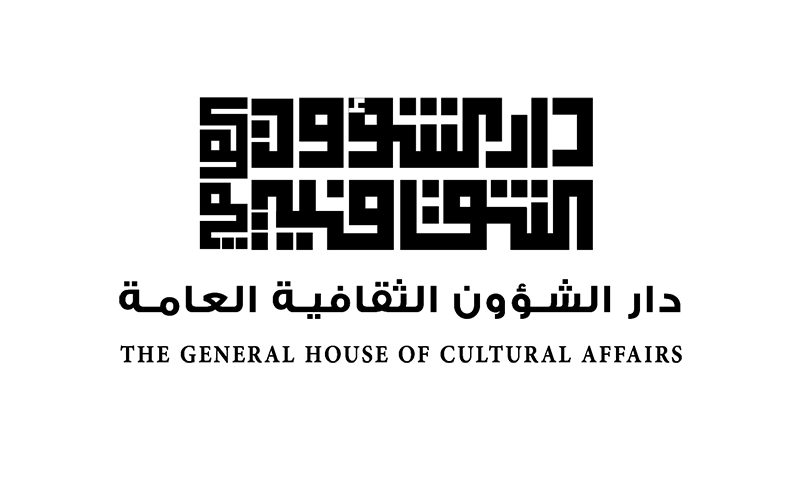![]()
الموقف الثقافي في حوار موسّع مع عبدالله إبراهيم

الموقف الثقافي في حوار موسّع مع عبدالله إبراهيم
أجرى الحوار د. مناف الموسوي
-أبدأ معكم بالسؤال عن "البيان النقدي" الذي أعلنتموه في ربيع 1988 داعين فيه إلى تجديد المنهج النقدي في الدراسات الأدبية، وتأسيس "جماعة النقد الجديد في العراق". كيف تقيّمون ذلك البيان بعد أكثر من ثلاثين عاما على صدوره؟ وهل استطاع أن يحقّق أهدافه في الانتقال بالنقد العراقي من الدراسات السياقية الى الدراسات النصية ؟
* ليس ينبغي الادّعاء بأن بيانا نقديا واحدا له القدرة على إجراء تحويل جذري للمناهج النقدية السائدة من حال إلى حال أخرى مختلفة؛ فالقول بذلك مغالطة ثقافية يتعذّر قبولها، والحال، فإن النقد التقليدي كان قد شارف على الإفلاس، وأعلن صراحة عن عجزه الإلمام بالظاهرة الأدبية بما يوافق رؤى الحداثة النقدية، واستعصى عليه التوغّل في صلب تلك الظاهرة، والبحث في مستوياتها التركيبية والدلالية والأسلوبية بحثا يراعي طبيعة عوالمها المتخيّلة، ولا يجعل منها تابعا للمرجعية الاجتماعية والتاريخية، فيكون البيان النقدي الذي كتبته قد شارك في زعزعة النظام النقدي الذي انتهى إلى شروحات وانطباعات، ولعلّه حفّز الإرادات الكامنة في نفوس كثير من النقاد للجهر بضرورة تحجيم التركة النقدية القديمة، وإيداعها في سجلّ تاريخ الأدب، والانتقال إلى مرحلة جديدة مختلفة في معالجة الظاهرة الأدبية، وإن كان البيان قد أدى هذا الدور، فيُحمد له ذلك.
- ما الظروف الثقافية التي أحاطت بإصداركم البيان النقدي؟
* إن ظروف كتابة البيان بحاجة إلى توضيح يحول دون تقويل رأيي في الدعوة إلى التجديد، ويبعد عنه سوء التأويل، فلم يكن الإعراض عن المناهج التقليدية، آنذاك، خطرة عارضة خطرت لي، إنما تعبير عن احتجاج على مفاهيم عتيقة استقر معظمها منذ القرن التاسع عشر في الثقافتين الفرنسية والإنجليزية، ووصلت أصداء منها إلى الجامعات العراقية، وشاعت في الوسط الثقافي العربي، وكلها ما وفت بأغراض جيل طالع من النقاد أعلن عن نفسه في أواسط ثمانينيات القرن العشرين. آنذاك كنت شابا جامحا في اندفاعي إلى ساحة الفكر النقدي، ولم أحسب للتراتبية الثقافية حسابا كبيرا، وغفلت عن الشعور بالامتعاض من قبول أيّ جديد، وافتقرت إلى روح المجاملة التي رأيت فيها نوعا من الرياء الذي أبعد ما أكون عنه، فشعرت، كما شعر أقراني، بقصور الفكر النقدي الشائع في العراق، فبدأت التفكير في عام 1987 في تكوين جماعة نقدية تبلور تصوّرا جديدا لوظيفة النقد، وغايتي أن يصدر النقد عن رؤية جديدة للأدب، وأن يقترن بمنهج معبّر عن تلك الرؤية، وأن تكرّس الجماعة جهودها، أول الأمر، لدراسة الأدب العراقي، وقد عرفت باسم "جماعة النقد الجديد". غلب الشاغل المنهجي لديّ على أي شاغل آخر، ومن طباعي أخذ أيّ ثقافيّ أمر مأخذ الجدّ الكامل، ولا أعرف سبيلا أخفّف بها الأعباء التي اقترحها على نفسي في التفكير، وإلى ذلك الطبع الصعب أعزو الانكباب على التأليف من دون هوادة منذ وقت مبكّر من حياتي، ويتّصل الشاغل المنهجي بالتفكير في الطريقة التي أخذت بها باحثا اندرج لتوّه في المجتمع الأدبي والأكاديمي المشبّع بالمناهج الخارجية، وبخاصة الاجتماعية والتاريخية والانطباعية والنفسية.
- إذًا، كيف تطوّر منهجكم الذي أعلن عن نفسه ببيانكم النقدي؟
* من التمحّل الادّعاء بأن البذور النقدية انبذرت كلها بكتابتي للبيان النقدي، فمن عادتي مداومة الانشغال بالأفكار التي أعمل عليها، وبالأحرى تتغلغل في عالمي، فلا تنفكّ عني، ولا أنفكّ عنها. ومن أخصّ ما درجت عليه إعادة النظر فيما أقوم به، فلا أركن إلى نهايته إلا حينما يرجح جديد لديّ، فيما أؤمن بتحديث الأفكار، والمؤالفة معها، ورعايتها حتى تكتمل، ويستقيم أمرها، ولما كان تفكيري متحوّلا، وولعي بالمعارف الجديدة لا يتراجع، فقد كان أفق تفكيري يتوسّع عاما بعد عام، وهو أمر طبيعي لكل مشتغل بالحقول النقدية والفكرية. يصحّ القول بأن عام 1988 من الأعوام الفاصلة في حياتي، ففيه بدأ الاعتراف بي ناقدا في المجتمع الأدبي العراقي الذي لا يمنح الاعتراف لأحد إلا بعد لأي، فيقابل بجفاء من ذلك المجتمع الذي يعدّ الجديد دخيلا، فيقاومه، ويثبط من عزيمة صاحبه، ويخلع عليه الغرور والادعاء، وكانت تلك المدة مصهرًا شهد التفاعلات الأولى للانقسام النقدي في العراق، وارتسم التباين في النظر إلى الظاهرة الأدبية.
ومن ناحيتي اعتبرت قضيتي الرؤية والمنهج قضية إشكالية، وربطتهما بمشروع النقد الجديد الذي شاركني فيه سعيد الغانمي، ومحمد صابر عبيد، وعواد علي، ورميت بتلك القضية في وسط ثقافي بدأ يهجس بالارتياب تجاه المناهج القديمة. ولست أعلم بأنني قد سبقت إلى اقتراح القضية المنهجية بوصفها قضية إشكالية بعد أن ربطتها برؤية الناقد. واعترف بأنني قد عثرت بصعوبة بالغة آنذاك على التفريق بين التصوّر المنهجي، والمعنى الذي أقصد إليه في الظاهرة السردية. في البدء كان التفريق ملتبسا عليّ، ثم عسيرا في بيان حدوده، قبل أن ترتسم أبعاده، فالتصوّر قابل للتطوّر، ومستوعب للتجديد، لأنه يمثل طريقة النظر إلى الظاهرة السردية في سياقها الثقافي الخارجي، أي أنه يراعي الحقبة التاريخية التي تحتضن الظاهرة المدروسة، أما هي فلها هويتها السردية، المتمثلة بأبنيتها، وأساليبها، ودلالاتها، ووظائفها، وبمجمل النسيج الخطابي الذي تظهر به، وتقترن أهمية التصوّر المنهجي بالرؤية التي يصدر عنها الناقد ويجعل من موضوعه قابلا للوصف والتحليل والاستنطاق من غير تقويل، وانتهيت إلى تقسيم شبه منطقي، ومؤداه: لا يمكن أن تنهض عملية نقدية من دون اقتران الرؤية بالمنهج، فلا قيمة نقدية لرؤية لا تستند إلى منهج، ولا قيمة نقدية لمنهج منفصل عن الرؤية. وقرّ الأمر عندي على أن اقتران الرؤية بالمنهج يمكّن الناقد من الاقتراب إلى الظواهر الإبداعية اقترابا منظّما فيه كثير من الدقة ومراعاة طبيعة الظاهرة الأدبية.
- ما دمت انخرطتَ، منذ خطواتك النقدية الأولى في عمل جماعي، فأيّهما أفضل، برأيك، العمل الجماعي أم العمل الفردي في المشاريع النقدية بخاصة، والثقافية بشكل؟
* الجواب على هذا السؤال أشبه بالوقوف أمام مرايا متقابلة تضاعف من أعداد صورة واحدة، وجوابي أن تضافر الجماعة في الجهر بالتغيير أمر محمود في كلّ مطلب غايته الفعلية التغيير نحو الأفضل، وهذا القول لا يغمط حقّ الأفراد في الجهر بآرائهم؛ فالفرد أقدر على صوغ فرضية التغيير من الجماعة، ولكن الجماعة هي المؤهلة لحمل فكرة التغيير، وتوفير ظروف تحقيقها، وبقدر تعلّق الأمر بالعمل النقدي، فلا ينبغي لصوت الجماعة أن يمحو صوت الفرد، ولا يجوز لصوت الفرد أن يشذّ عن الايقاع الجماعي، فالأمر أشبه ما يكون بالأوركسترا التي تعزف في إطار لحني واحد، وكلّ عازف يتولّى دورا فيها بحرية، ولم يغب عنّي ذلك حينما بدأت التفكير بإعداد البيان النقدي، فخلال السنة التي سبقت نشره، كنت شديد الاهتمام بالجماعات النقدية، بداية من الشكلانيين الروس، وجماعة مدرسة براغ، وجماعة النقد الجديد في أمريكا، وجماعة فرانكفورت في ألمانيا، والجماعات البنيوية، والسيمولوجية، والتفكيكية في فرنسا، ومجمل ذلك الاهتمام ظهر في الفصل الأول من كتاب "معرفة الآخر" بالاشتراك مع عواد علي وسعيد الغانمي، وهو الفصل الذي تولّيت أنا كتابته.
ولم أهمل دور الجماعات الأدبية في الثقافة العربية الحديثة، مثل جماعة المهجر، وجماعة الديوان، وجماعة أبوللو، وجماعة مجلة شعر، ولكنني لم أعرّف بها لشيوع أمرها، فالجماعة تيار يهجس بالتغيير، ويتطلّع إلى المستقبل، ومع ذلك، فلا بد أن يكون للناقد صوته الفردي في إطار الجماعة؛ فالتغيير لا يستدعي الكتم، بل الجهر، واندغام الصوت الفردي في الشبكة الجماعية لا يحقّق الغاية المرجوّة من التغيير، ولا بأس من الاشتراك برؤية للأدب، وبمنهج معبّر عن تلك الرؤية، مع فسح المجال للعمل الفردي الذي ينشط في صوغ المفاهيم، ويتحرر من العبء الجماعي في التحليل والتأويل، ويكشف تاريخ الجماعات الأدبية والنقدية أنها تجتمع على التغيير، وسرعان ما يكون لكلّ صوت فيها نغمته الخاصة به، ودوره الذي يتصل وينفصل عنها، ولعلّ جماعة النقد الجديد في العراق، وغيرها من الجماعات، تؤكد رأيي هذا، فقد تفرّقت السبل بها، شأن كلّ الأشخاص المكونيّن للجماعات قبلهم، وتوسّعوا في دراساتهم النقدية والفكرية، ولكن تجمعهم رؤية جديدة مرنة للظاهرة الأدبية.
- اقتصرت جماعة النقد الجديد في العراق على جماعة شابة من النقاد الطموحين تكوّنت منكم، ومن سعيد الغانمي، وعواد علي، ومحمد صابر عبيد، لماذا لم يشترك معكم نقاد معروفون، مثل: فاضل ثامر، شجاع العاني، حاتم الصكر، ياسين النصير؟ على الرغم من أنّ آراءهم النقدية، بعد صدور البيان النقدي، بدأت تنسجم مع طبيعة التحول الذي دعا اليه بيانكم، وراحت جماعتكم ترسخه في النقد العراقي عاما بعد عام؟
* لست مخولا للإجابة نيابة عن زملاء لهم دور مرموق في النقد العراقي، ولا أقرّ بحديث النيابة عن أحد، غير أنني أستطيع وصف تضاريس الحركة النقدية العراقية، فقد ارتوى الجيل النقدي السابق لجيلي من ثمالة ما وصل إليه من دراسات أدبية عن الواقعية الموضوعية أو الواقعية الاشتراكية، فالمنزع الماركسي في دراسة الأدب له ظلال واضحة في الثقافة العراقية، وقد تبنّى جملة من المفاهيم عن الشكل والمضمون التي طرحتها الأدبيات الماركسية قبل الحرب العالمية الثانية، وأحدثها عهدا يتّصل بلوكاش في مرحلته الماركسية المتشدّدة، وغاب عنه التطور الجذري الذي طرأ على الدراسات الأدبية عند أقطاب مدرسة فرانكفورت، ولم يسمع أحد بباختين، ولا بغولدمان، وإلى ذلك، ركن النقد العراقي في اتجاه منه إلى انطباعات شارحة رسّخ أهميتها الدكتور علي جواد الطاهر، وواصلها أتباع له منهم عبد الجبار عباس، وباسم عبد الحميد حمودي، وحاتم الصكر، وذلك إلى جوار جهود نقدية استظلت بالمعطى الماركسي اعتمادا على نظرية الانعكاس تولّاها عدد من النقاد، منهم شجاع العاني، وفاضل ثامر، وياسين النصير، وطرّاد الكبيسي، وكانت نهاياتهم في معالجة الظاهرة الأدبية مختلفة عن بداياتهم، فقد انتفعوا من التحديثات المنهجية، وأسهموا فيها، وإلى جوار ذلك كانت هنالك الدراسات التاريخية للظاهرة السردية انصرف لها عبدالإله أحمد، وعمر الطالب، وإنما هذه أمثلة على المسارات العامة الممثلة للنقد العراقي، لكننا نعثر على عشرات المشتغلين بالممارسة النقدية، وبخاصة الأكاديمية التي خلعت قواما متماسكا على النقد في الجامعة، من أمثال جلال الخياط، وعناد غزوان، وداود سلوم، وجميل نصيّف، وفائق مصطفى، وعلي عباس علوان، وناصر حلاوي، ومحسن إطيمش، ويمكن إدراجهم في هذا المسار أو ذاك، ومعظم جهدهم انحبس في الحرم الجامعي، ويتعذر عليّ ذكر قائمة وافية بممارسي النقد في العراق، فقد كانت الصحافة تعجّ بالأسماء النقدية، وانخرط بالنقد عدد من الشعراء والروائيين، واستمرت هذه الحال إلى نهاية ثمانينيات القرن العشرين، إلا أنّ التطوّرات المنهجية الجديدة لم تظهر عند معظمهم إلا بعد أن زعزع النقاد الجدد ركائز النقد القديم.
-قوبلت المناهج النقدية الجديدة بعزوف من الجامعات العراقية التي، شأنها شأن أية مؤسسة، تقاوم الجديد، وتنكفئ على ذاتها ممثلة للبحوث المدرسية التي تنصاع، في غالبيتها، للموروث النقدي، كيف قوبلت آراؤكم النقدية في الجامعة، وقد أصبحتم أستاذا في الجامعة المستنصرية؟
* أخذت الجامعات العراقية بمناهج أعفت نفسها من الغوص في صلب الظاهرة السردية، واكتفت بدراسة الظاهرة الشعرية، فلا عجب أن قوبلت الدراسات الجديدة بصدود كامل، وطالتها الشكوك، وجرى التعريض بأصحابها، والتشكيك بقدراتهم، بل قوبل النقاد الجدد من أقرانهم من الجيل السابق بكثير من الاستياء، وبخاصة الجيل الذي تشرّب بأمشاج الأيديولوجيا الماركسية في نظرتها الآلية للظاهرة الأدبية باعتبارها مسؤولة عن وصف ما يدور في الواقع، أو من المناهج الخارجية التي أسقطت على الظاهرة الأدبية القيم الاجتماعية أو النزعات النفسية، فضيّقوا عليهم سبل النشر، ومنعوا نشر كتبهم، وحالوا دون مشاركتهم في المؤتمرات الأدبية، وأشاعوا عنهم ما أشاعوا من تُهم مزوّرة، وثلبوا في قدراتهم، وبالإجمال، عدّوهم دخلاء على الوسط الجامعي، وغرباء عن الوسط الثقافي، حتى أنّ ناقدا مرموقا مثل الطاهر، اتّهم بعضهم، وبخاصة المعنيين بالدراسات البنيوية، بأنهم عملاء للاستعمار الفرنسي!!.
ولا أقبل لنفسي بعد مرور أكثر من ثلاثين عاما على تلك الحقبة النظر إليها بازدراء أو تبجيل، فتلك حقبة تكوين جيل نقدي تعثّر في مسعاه شأن أي جيل جديد، لكنّه شقّ طريقه باستيعاب بعض معارف عصره، وطرح ما تهرّأ من الأفكار الشائعة عن المادة الأدبية، وأقحم نفسه في المجتمع الأدبي، والمجتمع الأكاديمي، وتجشّم عناء الذم والانتقاص، ومضى في سعي حثيث أثمر، فيما بعد، دراسات معمّقة حفرت في الموروث السردي، قديمه وحديثه، ونتج عن جهوده حفظ النقد التقليدي في أرشيف تاريخ الأدب بعد أن كفّ عن وظيفته في معالجة الظاهرة السردية. ويحتمل أن يجافي هذا الوصف حقيقة ما حدث في رأي أولئك الذين لم يعاصروا ذلك المخاض الثقافي العارم، لكن الشهادة الحية المواكبة لذلك تؤكد الانقسام بين رؤيتين نقديتين للمادة الأدبية دخلتا في صراع أفضى إلى انحسار الرؤية التقليدية للأدب، ومعها المنهجية التقليدية في تحليله، ورسوخ الاتجاهات الجديدة التي كانت مزيجا من مفاهيم وردت إلى الثقافة العربية من الحواضر الغربية، وعملية تفكير جديدة اقتضتها التحولات الثقافية والاجتماعية، فانصهر هذا في ذاك، وأثمر عن منهجية كفوءة عرّضت الظاهرة السردية لفحص غير مسبوق، ومعاينة لم ينتبه إليها قدامى المشتغلين في مضمار الأدب.
لا أريد بهذه التفاصيل القدح في دور الأجيال الرائدة من الأكاديميين الذين ورثوا الطريقة الاستشراقية في معالجة الأدب العربي، وهي الطريقة التي أشاعها طه حسين وأضرابه في الجامعة المصرية، ومنها انتقلت إلى سائر الجامعات العربية، وقوامها الاسترسال في إيراد معلومات تاريخية، وانطباعات نفسيّة عن المادة الأدبية في سياق نشأتها، وتحقيب أطوارها بحسب المراحل السياسية للدول الحاكمة، وهي طريقة ورثها طه حسين عن المستشرقين، وأمست غير قابلة للتعديل سواء في وصف المادة الأدبية أو في بيان تطورها، ولو أحلّ أولئك الروّاد تاريخا يعتمد على تطوّر الأشكال الأدبية، محلّ التاريخ السياسي الخطّي، لكان ذلك أفضل في رصد مظاهر التجديد الذي شهده الأدب العربي طوال ألف وخمسمئة سنة؛ فالطريقة الخطيّة حجبت تطور الأشكال، ولم تهتم بتغيير الأبنية والأساليب إلا ما ندر، ونتج عن ذلك أن حبس التاريخُ الأدبَ، وأغلق عليه باب الأغراض، وأخرج السرد عن الاهتمام، وبه استبدل النثر المسجوع.
قدّمت تلك الطريقة معرفة عامة بالتاريخ الرسمي للدول العربية والإسلامية، واهتمام بأنساب الأدباء، بالأغراض التي برعوا فيها، وإشارة عابرة لاقتحام موضوعات البلاغة العربية فيها من بيان وبديع، ووقع إغفال صريح لتركيب المادة الأدبية، ولوظائفها التمثيلية، ولموقف الأديب من العالم، وباختصار جرى انتزاع الأديب من عالمه الأدبي والزجّ به في العالم التاريخي ليكون شاهدا على أحداث عصره، وهذه مبالغة في الفصل، ومبالغة في الوصل؛ فصل الأديب عن عالمه المتخيّل، ووصله بعالم الواقع، فأعماله صدى مباشر لحياته، وقيمة الممدوحين، والمهجوّين، والمرثييّن، والمتغزّل بهن، غطّت على قيمة الرسالة الأدبية التي صاغها الشاعر، ولكي تعطى الشرعية للنص الأدبي لابد من البحث في حياة الشخص الذي قيلت فيه هذه القصيدة أو تلك. وقد أخذ بهذا النهج الثابت معظم الباحثين في الجامعات العربية، وعلى رأسهم شوقي ضيف، الذي عُمّمت مؤلّفاته في تاريخ الأدب العربي في غير جامعة، وأرغم عشرات الآلاف من دارسي الآداب العربية على اعتبارها المرجع الأول في معرفة آداب أسلافهم، والخروج على تلك الطريقة شاق، وقد لا يحظى بالاعتراف في الوسط الأكاديمي.
- على الرغم من كلّ دعوات التجديد التي ناديتم بها، بما في ذلك نقدكم الصريح للمؤثّر المنهجي الغربي في مشروعكم "المطابقة والاختلاف" مازلنا مستهلكين للنظريات النقدية الوافدة إلينا من الغرب، ما السبب الكامن وراء عدم ظهور نظرية نقدية عربية تعالج الأدب العربي؟
* لا يقع تثمين قيمة النقد بوجود نظرية نقدية أو بعدم وجودها في أدب هذه الأمة أو تلك، فالنظرية إطار افتراضي قد يجهض الغاية المرجوّة من الممارسة النقدية الجادة لأنه سيفي بشروطها، وليس الوفاء لأعراف الظاهرة الأدبية، والقول بنظرية نقدية قول محفوف بالأخطار من كل جانب لأنه ينتهي بحبس ظاهرة عصية على الانحباس في نظام صارم يحول دون تفتحها، ومن ناحيتي، فقد هجرت فكرة النظرية النقدية منذ فترة مبكرة، وصرت أدعو إلى ضرورة أن يعمّق الناقد وعيه بالخطاب الذي يعالجه، ويستعين بعدة منهجية تسعفه في تحقيق ما يريد، وتساعده في جعل الخطاب يفصح عما فيه، ويحذر من حبس الظاهرة السردية في إطار نظرية مغلقة لا تستجيب لطبيعة تلك الظاهرة، وهي طبيعة متنوّعة، وفيها من الخروج على الأعراف الأدبية الشائعة أكثر من الامتثال لها، على أنني لم أنكر مراعاة تلك الأعراف التي بدون الأخذ بها تتفتّت المادة السردية، وتفقد شكلها النوعي.
ومع ذلك، فإنّ حالة الفراغ في الثقافة العربية الحديثة دفعت بالنظريات النقدية للحلول في منطقة خالية من الاجتهاد النقدي المنهجي، فمنذ مطلع القرن العشرين هبّت أمواج متعاقبة من المناهج التاريخية والنفسية والماركسية والبنيوية والتفكيكية والسيمولوجية واللسانية، ووقع تطبيق كثير من فرضياتها على الأدب العربي، وهي بإطارها المستعار لم تنفع الآداب العربية، إنما حجزتها في أطرها النظرية، وكان ينبغي تحرير تلك المناهج من سياقاتها الغربية، والانتفاع بها بما يوافق سياقات الآداب العربية، غير أن هذا التكييف لم يقع، ومكثت قوالب مستعارة وقع تطبيقها بالقوة على مادة أدبية لا تستجيب لها، ويعود ذلك إلى قصور وعي النقاد العرب المهووسيّن بالاستعارة بدل التكييف والتهجين والابتكار، والحال، فقد أخفقت المناهج المستعارة في إثراء الآداب العربية، مع أنها مناهج مهمة جدا في الثقافات الغربية، وبإزاء ذلك بقي النقد العربي يقتات على مقولاتها وفرضياتها، وكان الأجدر به أن يغوص في الظاهرة الأدبية، ويستنتج لها مقولات من صلبها، ويقترح فرضيات منهجية نابعة منها، ولا بأس من الانتفاع، بعد ذلك، بالمشترك النقدي للمناهج الأخرى، فذلك مفيد في تعميق نظرة الناقد إلى الأدب، وتقديري أن كل ذلك أصبح جزءا من تركة الماضي، وصار ينبغي هجره، والانتقال إلى الأخذ بموقف مختلف قوامه تعميق وعي الناقد بالظاهرة الأدبية، والتوغل فيها، بدل وضعها على منضدة التشريح، وتجريب الأدوات المستعارة في تقطيعها.
- ومع ذلك، أفدتم أنتم من المناهج النقدية الغربية التي وجهتم لها النقد في كتابكم "الثقافة العربية الحديثة والمرجعيات المستعارة؟ كيف لك بيان رأيكم في هذا الأمر؟، وكيف جرى توظيف تلك المناهج في مشرق بلاد العرب ومغربها؟
* هذا سؤال صحيح، فخلال الثمانينيات من القرن العشرين بدأت المناهج الشكلية والبنيوية والسيميولوجية والتفكيكية تغزو الثقافة العربية غزوا لا هوادة فيه، فكأنها تجثتّ تركة نقدية فقدت وظيفتها المعرفية، وترمي بها في سجلّات التاريخ، وتنظّف الكتابة النقدية منها، ورافق ذلك احتفاء منقطع النظير بتلك المناهج، احتفاء رافقه زهو، وخيلاء، وغطرسة، واستمرّ الإعجاب بها قرابة عقدين قبل أن يخفت بريقها، ويخبو وهجها. تسلّلت تلك المناهج من بوابة المغرب بترجمات شائهة، وتلخيصات مقتضبة، وتطبيقات مدرسية تفتقر إلى الوضوح، ويعوزها الإفصاح عن مقاصدها التي حملتها في ثقافاتها الأصلية، قبل أن تتوطّن في بلاد أخرى، وفي العراق مرّت تلك المناهج بالغربال الإنجليزي الذي نخلها، وصفّى شوائبها، فلم يقع الانبهار بها كما حدث في البلاد المغاربية.
استقيت معرفتي بتلك المناهج مما كنت أطلع عليه بالإنجليزية أو ما تحصّلت عليه بالترجمة، فكنت أتولاها بالتفكير الذي جعلها منشّطة لي في عملي النقدي، وما قبلت بأن تكون أصفادا تقيّدني، فلا أخذ المفهوم كما وردني في أصله الأجنبي إلا عند الضرورة القصوى بعد الاستيعاب والمناقشة، وأطرح الحذلقات المبهمة المحيطة به غير راغب فيما لا نفع فيه لبحثي. وعلى هذا كانت المفاهيم التي تستبطن تلك المناهج تتعرّض إلى التعديل، والتغيير، والمناقشة، والتقليب، والتكييف، ويعاد توظيفها بما يوافق السياق الذي تندرج فيه، فتكتسب فعلا جديدا لم يكن واردا في الأصل، وبهذه الطريقة فهمت أهمية المشترك الثقافي للمفاهيم السردية في الآداب الإنسانية، فلا تثبت على حال جامدة، إنما تتطوّر بحسب السياق الذي تستخدم فيه، وبالطبع فقد شغلني أمر فعالية المناهج الحديثة في تحليل المادة السردية التي أعمل عليها، فأهتدي بما يفيدني منها، ويعدّل تصوراتي عنها، ولا يرغمني على إعادة تفصيلها في ضوء تلك المفاهيم التي جرى اشتقاقها من مواد سردية مختلفة، فلها سياقات ثقافية خاصة بها، وبهذا خالفت أقراني الذين امتثلوا لسياق السرديات الفرنسية، وعدّوها علما نظريا متعاليا عن المادة السردية المنتجة له بدواعي مراعاة شروط العلوم النظرية، وهو أمر لم أجده فاعلا في الدراسات السردية، وما كانت غايتي الإسهام في تكون علم بل استكناه طبيعة المادة السردية التي أعمل عليها.
ليس في واردي نفي الأثر البنيوي فيما كتبته في مؤلّفاتي الأولى، فلم أكن متزمّتا تجاه المعارف الحديثة في أي وقت من الأوقات، غير أني جعلته مساعدا لي في المعاينة الدقيقة للأبنية السردية، وليس قالبا جامدا، والحقيقة، فقد خيّم الأثر البنيوي في أرض النقد العربي مدة طويلة قبل أن يتفكّك تأثيره، ويذهب معظمه هباء حينما انفرط عقد المعجبين به، وبعد أن تحوّل إلى جملة من الرسوم والأشكال والمعادلات الرقمية، ولم يُثْر الوافد الجديد الذي حملته اللغة الفرنسية إلى أرض المغرب العربي، بل تعثر، وتناثر، بعد ربع قرن من انحسار تأثيره في محضنه الفرنسي. حتى بدا لي أنّ بعض الدراسات البنيوية كانت تغريرا بالقرّاء أو استغلالا لحسن طويّتهم في أفضل الأحوال، تلوذ بتنميق الأسلوب الذي يخفي ضحالة لا تغيب عن خبير. والقوالب الشكلية الجامدة في التحليل النقدي هي التي دفعتني إلى الإعراض عنها. وهي بمجمل ما أطلعت عليه من تطبيقات لم توافق المرامي الشاملة التي قصدت إليها في مشروع دراستي للسرد العربي. وبعد أن لمست جمود القوالب أرشدتني تأمّلاتي إلى الانفصال عن تأثيرها من دون الانقطاع عنها، إذ لم أكترث بالصيغ التحليلية الجاهزة، إنما رحت أبتكر لنفسي صيغا تناسب هدفي وموضوعي، وأخذت في الاعتبار بأنه ليس مطلوبا من الناقد أن يشفى من مؤثّرات عصره كائنا ما كان نوعها، وبإزاء ذلك عليه حماية نفسه من تأثيرها السلبي، ومعلوم بأن سلبيّات "المعارف المهيمنة" في عصر من العصور لا تقلّ أثرا عن إيجابيّاتها، وينصح بتقليل أثر الشطر الأول، والإفادة من أثر الشطر الثاني، وكان الصبر على الإلمام بالظاهرة السردية، وتحديد الغاية من العمل عليها، هو الذي شدّ من أزري في مواجهة الصعاب التي اعترضتني منهجية كانت أم فكرية، وما كان أغناني عن الوقوع في الخطأ، وأنا أتقدّم بخطوتي الأولى في ميدان البحث النقدي.
- ولكن الدارس لمجمل أعمالك النقدية يلاحظ عليك الإفادة المقيّدة من المنهجيات الغربية، وبخاصة مشروعك الفكري "المطابقة والاختلاف" الذي استفاد من منهج التفكيك، فكيف حدث ذلك؟
* نبت اهتمامي بالتفكيك من غير جذر، ثم راح يبحث عن جذر له، فالتفكيك لم يُطرق في الثقافة العراقية، في حدود ما أعلم، في ثمانينيات القرن العشرين، وكان حديث عهد بالثقافة العربية بشكل عام، ولعلّ مصدر اهتمامي به يعود إلى إدراك مبكّر بعدم الانصياع لأي تصوّر نسقي مغلق من الذي أشاعته المناهج الشكلية والبنيوية، إذ عزفت عن الامتثال للنسق الذي قايس فيه الشكلانيون ثم البنيويون بين النص السردي والنموذج اللساني ساعين إلى ضبط العملية النقدية ضبطا مماثلا للضبط اللغوي، وكانت هذه الفكرة مهوى أفئدة النقاد؛ لأنها زعزعت قواعد النقد التقليدي، فكأنها تنوب عما أعجز عن القيام به. ولم يغب عنّي، أيضا، بأن اهتمامي بالتفكيك مصدره رغبتي في ملامسة مظهر جديد من مظاهر الثقافة الغربية، ووجدت أفضل مدخل إليه هو التعريف بمنهج ملأ الأسماع في العالم، ولم يجد له تربة تستقبله في الثقافة العربية إلا على مضض، ما دفعني إلى التريّث في التعريف بمقولاته الأساسية، مثل "التمركز حول العقل"، و"التمركز حول الصوت"، فضلا عن مفهومي "الاختلاف" و"علم الكتابة"، ومهّدت لذلك بفرش الأرضية التي انطلق التفكيك منها باعتباره ردا على البنيوية، وتمهيدا للسيميولوجيا. وكل ذلك ظهر في كتابي "التفكيك: الأصول والمقولات" الذي نشر في المغرب في سنة 1990، بعد أن رفض نشره في العراق قبل ذلك بعامين.
دافع اهتمامي بالتفكيك هو رغبتي في معاينة الظاهرة السردية بنظرة جديدة غير النظرة الوصفية الشائعة آنذاك، فما عادت، في تصوري، كتلة صماء منقطعة عن سياقها، بل ظاهرة تمثيلية قابلة للتأويل والاستنطاق، فأكون تحرّرت من النظرة الوصفية للظاهرة السردية، وربطتها بسياقها الثقافي الذي دمغها بأعرافه من إرسال وتلقٍّ، وانصبّ اهتمامي على بنياتها السردية، ووظائفها التمثيلية. وما لبث أن نما لديّ الاهتمام بدراسة المركزيات الثقافية بجوار الاهتمام بدراسة الظواهر السردية، واستمر الأمر أكثر من عشر سنوات، إلى أن تمكّنت من مزجهما معا حينما وسّعت مفهوم السرد من دلالته الأدبية المباشرة إلى دلالته الثقافية العامة، فكان أن ثبت عندي بأنّ كلّ مركزية ثقافية أو دينية أو عرقية أقامت صرحها على سرد مخصوص جعلته وسيلة من وسائل قوتها وشرعيتها.
-آن الأوان لسؤالكم عن الكيفية التي قمتم بها في التوفيق بين المناهج الحديثة والمادة التراثية؟
* حينما أستعيد جانبا من تجربتي النقدية أجدني أجاور متون السرد العربي القديم والحديث، ولكنني غير منقطع عن كشوفات المناهج الحديثة، فلا عجب أن يرد ذكر أسماء نخبة من الباحثين المرموقين في الدراسات السردية والثقافية في كتبي، مثل: بروب، وأوسبنسكي، وباختين، وبارت، وتودوروف، ودريدا، وغريماس، وجينيت، وكرسيتيفا، وبريمون، وغولدمان، وفراي، وبرنس، وجاتمان، وكلر، ونوريس، وفاولر، وإيكو. ومع ذلك لم أنهل من العلوم الإنسانية بحسب قاعدة وضع الحافر على الحافر، فذلك عندي من الخطأ الشنيع الذي لا يثري العلم الإنساني، ولا يتيح له بلوغ الغاية منه، فإنما العلوم الإنسانية، ومنها الدراسات السردية، مباحث يهتدي بها العاملون في الآداب لكي يتوصّلوا إلى نتائج مفيدة للآداب القومية، نتائج لا تحيل المادة السردية إلى نموذج اختباري لبيان صواب النظرية، بل تكون حقلا تمارس فيه النظرية فعلها بهدف إثرائه، وكشف المضمر فيه، والإشارة إلى ما يتميز به من خصائص جمالية ودلالية، ومن دون ذلك ترغم المادة الأدبية على أن تكون شريحة اختبار يمارس عليها المُختبر مهاراته الاختبارية التي تظهر براعته، وليس قيمة المادة التي هي موضوع اشتغاله. ولعلّي أكون اقتربت بحذر إلى المناهج الشكلية والبنيوية، بيد أنني لم امتثل لمقولاتها، وما كان في واردي الانصياع الأعمى لها، وما ارتقت إلى رتبة الموجّهات الأساسية في عملي، فقد استغرقها الاهتمام بالسطوح ولم تجرؤ على الغوص في تلافيف الظواهر الأدبية. ويعود ارتيابي بتلك المناهج إلى رغبتها في الاستحواذ على الناقد، وتحويله إلى آلة ناطقة بفرضياتها ومفاهيمها.
ولا أنكر أن الدراسات الثقافية أبعدتني عن المناهج النسقية المغلقة التي بنت فرضياتها في ضوء النموذج اللغوي، وفصلت بين المادة الأدبية وسياقها الثقافي، وما وجدت ذلك يفي بغاياتي في استنباط السردية العربية من طيف واسع من المرويات السردية، والأعمال الروائية، ولطالما راودتني أفكار كثيرة بأن صرامة النموذج اللغوي لا تفلح في استكشاف طبيعة الظواهر الأدبية الكبرى، والظواهر التي صقلتها أعراف التداول الشفوي عبر القرون، وتلك التي استجابت لشروط الحقبة الكتابية من التداول القائم على التدوين، ولعلّي استجمعت أدواتي التحليلية من مزيج من المؤثرات المنهجية التي أخضعتها لتفكير صارم أعاد توظيف المفيد فيها في التحليل، ويقترح ما تثيره لديّ المادة السردية التي ألفتُها مدة طويلة. وبهذا يصحّ القول بأنني لم ألتزم إطارا نظريا قارّا لأيّ من المناهج النقدية، فليس من أهدافي استجلاب نظرية، وإثبات فرضياتها، بل اجتهدت في اقتراح ما رأيته نافعا لي في التحليل والتأويل. وعلى هذا المنوال نهلت من المؤثرات المنهجية، بتوثيق لمصادرها، متحاشيا أن تكون أعمالي صدى لها، فليس القيمة فيما وردني منتزعا عن سياقه، إنما فيما صدر عنّي مكتملا في السياق الذي أردته، وقد أخذت بحكمة فحواها أن الحوار أنفع، وأن التفاعل أبدع، وأن الاختلاس أبشع، وأن النهب أشنع، وأنه ليس من الفائدة رصف الأقوال المستعارة إلا في حال حرص الباحث إيراد رأي منسوب لصاحبه من غير بيان رأي فيه، وبخاصة في المداخل النظرية حيث يلزم نسبة الآراء إلى أهلها من دون تضليل وتزييف، وما خلا ذلك ثمار متفاعلة من التفكير والابتكار والتحفيز.
-لا يغيب عن أي دارس المظهر الموسوعي لمؤلّفاتكم، وبخاصة "موسوعة السرد العربي" بمجلّداتها التسعة، ما الذي دفع بك إلى هذا الاستغراق العميق في تعقّب الظاهرة السردية العربية، ما تفسيرك لهذا الأمر؟
* لن أساير الآخرين في المبالغة بوصف المشاقّ المصاحبة للتأليف الموسوعي، فقد يرشح منه التغنّي بأفضال المؤلّف على الآخرين، وهو أمر لا محلّ له في كلّ بحث موسوعي يتوفّر على الدقة والموضوعية، وبه استبدل الحديث عن المتعة العقلية المصاحبة لعملية التأليف، المتعة التي تقترح على المؤلّف حوارا مثمرا مع العالم من حوله، ومطارحة مع المعرفة التي هي منتهى الطلب لكلّ ذي عقل سليم. وأصف المتعة النفسية في الشعور بالرضا والامتلاء، والإحساس بالارتياح والبهجة، ما يشفع بذل الجهد، وصرف الوقت من دون حساب؛ فالمؤلّف الموسوعي يعثر على ضالّته في تطوير ضروب من الحوارات الممتعة التي لا سبيل إلى وضع نهاية مؤكّدة لها إلا بالتوقّف عن الكتابة، وهو أمر صعب المنال: حوار الدهشة في الاكتشاف، وحوار المتعة في الاستنطاق، وحوار اللذة في التأويل، وحوار الترحّل بين الماضي والحاضر، وحوار عبور التخوم الواصلة/ الفاصلة بين الثقافات التاريخية والدينية والأدبية، وحوار الانتظار الذي لا تلوح له نهاية، وأخيرا حوار الظفر بأنه لم يهدر سنيّ عمره عبثا في عالم محفوف بالفوضى والاضطراب. وعلى هذا، فبالإكثار من وصف الصعاب، يحمّل المؤلّفُ القارئَ مكارم كثيرة، ويُجشّم المتلقّي أفضالا جسيمة، فيما ينبغي عليه إزجاء الشكر لمًن وفّر له فرصة محاورة النفس، والعالم، والتاريخ.
كنت مستمتعا بتأليف موسوعة السرد العربي، وليس يجوز تأثيم اللّذة العقلية المصاحبة للتأليف، ولا شجب التبحّر في المعارف الإنسانية، فهي مصاحبة لكلّ عمل جاد، ومحفّز على الانصراف إلى تحقيقه، بل ينبغي الاحتفاء بها، فلذّات البحث في الظواهر الثقافية تفوق شهوات غايته، وبها يدرأ الباحث شعورا بالعدمية، ويكبح إحساسا بالبوهيمية، وسوف ينكفئ على ذاته إن خطرت له خواطر سلبيّة عن لا جدوى العمل الفكري والنقدي، فيتوهّم نفسه مركزا للعالم الذي يحيا فيه، فإن اختلّ هو اختلّ العالم الحاضن له، وتلك هي الأنانية بنفسها، وحبّ الذات بعينه، وجعلهما معيارا لتوازن العالم يحطّ من شأن الباحث، ويذهب به إلى حتفه، فيما ينبغي عليه أن يتبرّأ من ذلك، وبه يستبدل بذل النفس في سبيل المعرفة الممتعة، أي المعرفة التي تمهّد الدروب إلى مرافئ التوازن النفسي، والاكتفاء العقلي، بل اليقين الذي يشعر المرء بأنه كائن دنيوي فاعل. لا أقصد باليقين ما يدلّ على الثبوت والقطع، فلا ثبوت في المعارف الإنسانية، ولا قطع في أمرها، بل قصدت بلوغ أجلى حالة إدراك ممكنة لها. لست من دعاة فصل الباحث عن نفسه، ومشاعره، وعواطفه، وذوقه، وعصره، وهويّته، إنما من الداعين إلى وصل كلّ ذلك بالمسؤولية التي جوهرها الوجوب، والتعهّد، والالتزام، وهي مسؤولية يُرتقى إليها بها بسلّم المعرفة.
- أرى أنك تربط البحث الموسوعي بالمتعة؟
* بالطبع، المتعة العقلية والنفسية مهمة جدا في التأليف، وبدونها تجفّ مادة الكتابة، ولكن هذا لا يكفي، فمن الضروري ادارك المؤلف الموسوعي للهدف العام من عمله، فلا ينبغي عليه أن يكون متعجّلا، ومغرورا، وأنانيّا، وعليه أن يدرك أن الثمرة لن تكون له، فهي من حصّة غيره؛ فالتأليف الموسوعي عاقبته غيرية لا ذاتية، وخاتمته ليست لصاحبه، وبذرته اقترحها عليه هاجس البحث العام وليس الرغبة الخاصة، وما بين البذرة النيّئة والثمرة الناضجة مرحلة طويلة من الجهد المركّب: جهد الآخرين الذين سبقوه، وطرقوا الموضوع ذاته من جوانب عدّة قبله، وجهده في الجمع، وفي الترتيب، وفي التنسيق، وجهده في شقّ الطريق إلى صلب مادة البحث ليحدّ من أثر الوساطة بينه وبينها، وجهده في صوغ الفرضيات المناسبة لتحليل القضايا المطروحة عليه، وجهده في تأويل الأفكار الداعمة لها، وفي اصطناع السياق الحاضن لها، وفي تطوير الرؤية المنهجية القابعة في ثناياها، وفي الاستزادة من معارف عصره، والأعصر السالفة، بما يمكّنه من تركيب معرفة مفيدة، وينتهي الأمر باستخلاص جهده التأليفي بثمرة تُطرح للانتفاع بها من طرف الآخرين، فليس غاية التأليف الموسوعي الإشارة إلى المؤلّف بالبنان، بل إضمار العرفان. قد يحظى المؤلّف الموسوعي بنوع من الحفاوة، وربما يظفر بشيء من الرعاية، لكنهما يقصران عن الإحاطة بالانكباب حفرا في أرض شبه بكر ما طُرقت من قبل إلا على خجل.
وأريد التأكيد على أن الظواهر الثقافية الكبرى، ومنها الظاهرة السردية، لا يجوز مقاربتها بالاختزال الذي لا يستوفيها حقّها، قصدتُ: استنباط خصائص تلك الظاهرة، وبيان وظيفتها التمثيلية، ولا يتّأتى ذلك من دون ربطها بالسياقات الثقافية الحاملة لها. ومع التصرّف بملء الإرادة في الاختيار، فأنفي العشوائية في اختياري دراسة السرد العربي نفيا قاطعا، وقد تطوّرت قصدية الاختيار بدوام التفكير في الموضوع، ولم تكن جاهزة، ولن تكتمل بصورة نهائية، إنما شقّت طريقها بالبحث المعمّق إليه، فقطّعت أطياف العشوائية الخفية التي قد تكون تسلّلت إلي، في أول الأمر، من حيث لا أعرف. ولا مكان للادّعاء بتمكّن الباحث من اقتراح مقاصده المستقبلية كما ينبغي أن تكون، والعمل على هدي قصد واضح له كلّ الوضوح؛ فذلك نوع من تزوير التاريخ الشخصي له، والأرجح أن يكون الباحث قد حدّد قصده العام، ووفّر الأسباب الداعمة له، واقترح مسارا يوصله إلى ما يصبو إليه، فتتساقط أوراق العشوائية اللابثة في طيّات اللاوعي، وبمضيّ الوقت يتقوّى القصد، فيمحو أي أثر للعشوائية.
- إذًا كان اختيارك للعمل الموسوعي واضحا ومقصودا منذ البداية؟
*نعم، جعلني وضوح القصد اتّخذ من السرد العربي موضوعا لبحثي، فأقبلتُ عليه بعقل منفتح، وأردته أن يكون وافيا يحيط به، فدرجت على تأليف أجزاء الموسوعة بمخطّط طويل المدى، مخطّط يُحتمل ألّا يوافقني كثيرون عليه كونهم يستعيرون أحكامهم من الأعراف المختصّة بتأليف الكتب المتفرّقة، وليس من الأعراف المعنيّة بالتأليف الشامل المنفتح على الظاهرة السردية العربية، والتي يمتنع وصفها بكتاب مفرد، بل سِفر يوفيها حقّها في معظم جوانبه. وقد ألهمتني الأسفار التي تتطوّر عبر الزمن، ولا تكتسب شرعيتها إلا بعد اكتمالها، شرط أن تكون قد استوعبت موضوعها، وأخذته بأجمعه، والتاريخ الإنساني حافل بالأمثلة لمن أراد معرفة ذلك، وهو تاريخ مأهول بمؤلّفات متعاقبة الأجزاء لم تكتمل إلا بعد عقود من البحث، وخلال ذلك تعرّضت إلى التحديث بين طبعة وطبعة، والتجديد بين نشرة ونشرة، وبعضها ما عرف التمام في حياة مؤلّفه، فتعاقب عليه مريدوه اعتمادا على النهج الذي وضعه، أو الملاحظات التي خلّفها عنه.
وما دام الأمر قد استقرّ على هذا الوجه، فيلزم القول بأنّ البحث الموسوعي يطرح سؤال "الحقيقة" باعتبارها ركنا ثابتا لابدّ من العثور عليه بعد هذا العناء، فلا معنى لبحث لا يروم إظهار الحقيقة إثر مشقّة طويلة من الانكباب عليه، ومع ذلك فحيثما يطلق مثل هذا التصريح عن "الحقيقة"، فلا بد من كبح أي تهوّر في الادّعاء باكتشافها، فالحقيقة قرينة الفهم، فتكون نسبيّة طبقا لشروط فهمها، فلا هوية للحقيقة بمعزل عن الفهم. ويمكن أن تلوح أطيافها إذا ما وقع تنظيم الأفكار، وتنسيق الآراء، وتمهيد الطرق، للاقتراب إلى ما يظنّ أنها الحقيقة الرجراجة. يُحمد الاهتداء الى تفسير قريب لما يحتمل أن يكون الحقيقة، وليس الجزم بالعثور عليها، فذلك من المحال، وغاية العمل النقدي الالتفاف حول الظواهر الأدبية، ونَكْش بؤرها، وتقليبها، ووصفها، وتأويلها، والتأويل بحدّ ذاته إقرار بغياب جوهر متّفق عليه، أي أنه لا محلّ للتأويل خارج منطقة المجاز الأدبي القائم على تغليب الظنّ بقرينة كما روي عن ابن حزم الأندلسي. أبدا، ما انثنيت عن تعقّب أطياف هذا الهدف المتنائي، الذي ما أن أقترب إليه إلا ويكون تقدّم عليّ، وعلى هذا المنوال من الكرّ والفرّ سلخت عمري في مصاحبة المرويّات والمدوّنات السردية، أحوم حولها، أطلّ عليها، وأحاول أن أفتكّ لي دربا إلى غياهبها، ولكننّي ارتد عنها لإيماني بأنها ليست مستودعا للحقائق، فهي سيل من الايحاءات التي لا تثبت على حال. يمكن استكناه رواسم الحقائق، ولكن ينتفي الزعم بصلابة وجودها، فتلك المرويّات والمدوّنات خير دليل لاستكناه ما نتوهّم من حقائق.
- هل وفرت لكم موسوعة السرد العربي المناخ المناسب لقول ما تريدون قوله عن السردية العربية؟
* هذا صحيح، لقد وفّرت لي الموسوعة فرصة لتأكيد رؤيتي النقدية في اعتبار "السردية العربية" الموضوع المثالي للبحث في الكيفيّة التي تستعاد فيها عمليّة بناء جديدة لظاهرة أدبيّة - ثقافيّة كبيرة بدأت تتجلّى للعيان منذ العصر الجاهليّ. ووجدت أنه ليس أمام الباحثين، وأنا منهم، سوى طريقتين لوصف أصول تلك الظاهرة، وتحليلها، وتأويلها، وبناء سياقها الثقافيّ، وهما: طريقة "التاريخ الوصفي" الذي يتعقّب الوقائع الأدبيّة ممثَّلة بالمؤلّفين ونصوصهم وعصورهم، ثم الامتثال لقاعدة التدرّج الصاعد للزمن من أجل وصف بداية الظاهرة، وتتبّعها، بهدف الوصول إلى الغاية من كلّ ذلك، وهو رسم مسارها المتدرّج، ثم وصفها من نواحي التأليف، والنوع، والموضوع، وطريقة "تاريخ الأفكار" حيث ينبغي توظيف المقاربات الثقافيّة، والاجتماعيّة، والتاريخيّة، والدينيّة، واللغويّة من أجل إعادة بناء سياق تلك الظاهرة قبل إخضاعها للتحليل والاستنطاق؛ فلا يمكن، في سياق ظاهرة مخياليّة مثل السرد العربي، عزل الوقائع النصيّة عن مرجعيّاتها الثقافيّة عزلا كليا، فقد يصحّ ذلك جزئيا في بحث يتوخّى استنباط الخصائص الأسلوبيّة لنصّ مفرد أو جملة من النصوص في حقبة تاريخية واحدة، غير أنّ تخطّي السياقات الثقافيّة في إطار معالجة شاملة للسرد العربي سيفضي إلى نوع من التجريد الذي يعزل الظاهرة السردية عن شرطها التاريخيّ والثقافي، ويفصم صلتها بالخلفية الزمانية - المكانية التي ظهرت فيها.
أثبت لي تأليف الموسوعة أن السرد العربيّ القديم يندرج في نسق السرود الشفويّة؛ كونه نشأ في ظلّ سيادة مطلقة للمشافهة التي خيّمت على أشكال الثقافة العربيّة كافّة في العصر الجاهليّ، والقرون الإسلاميّة الأولى، ولم يقم التدوين إلاّ بتثبيت آخر صورة بلغتها المرويّات الشفويّة، وكثير منها ظل أسير التداول الشفوي حتى أوائل العصر الحديث، كالسير الشعبية والحكايات الخرافية. ويلزم التأكيد على أن الشفاهيّة ليست نظاما طارئا، بل أرضيّة صلبة نشأت فيها مكوّنات الثقافة العربية في مظاهرها التاريخيّة، والأدبيّة، واللغويّة، واستمدّت الشفاهية قوّتها من الأصول الدينيّة التي جعلتها خادمة للدين رؤية وممارسة، فمن المتعذّر تحرير الأحاديث النبوية، والمرويات الإخبارية والسردية، من النسق الشفوي، وأية محاولة لفصم صلتها عن الإسناد ستؤدي إلى انهيار مبانيها ومعانيها. وتتضح لأي باحث أن المرويّات السرديّة العربية القديمة تتحدّر عن جذور شفويّة، فهي تعتمد الأقوال الصادرة عن راو، يرسلها نطقًا إلى متلقٍّ، ولهذا السبب كانت الشفاهيّة موجِّها رئيسا في إضفاء السمات الشفويّة على الملاحم، والحكايات الخرافيّة والأسطوريّة، وكافة أشكال التعبير السردي القديمة. ومع ذلك فثمة تمييز بين السرود الشفويّة والسرود الكتابيّة. وقد ربط هذا التمييز السرودَ الشفويّة بالبروز الكامل للمكوّنات السرديّة التي تكوّنها بما جعل كلّ مكوّن فيها عنصرًا ظاهرا لا سبيل إلى إخفائه؛ ذلك أنّ المرويّات الشفويّة لا توجد إلاّ بحضور جليّ لراو، ومرويّ له، ولا يمكن تغييب أيّ مكوّن، الأمر الذي قرّر أنّ تلك المرويّات استمدّت وجودها من نمط الإرسال الشفويّ الذي هيمن مدّة طويلة على البنية الذهنيّة للمجتمعات البشريّة، كما أنّ ذلك التمييز، حجب عن السرود الكتابيّة، صفة إبراز مكوّنات البنية السرديّة بطريقة مكشوفة، وبها استبدل نوعًا من "التمثيل" لتلك المكوّنات، ولكنه لم يتسبّب في إلغائها بصورة كاملة، فما برحت آثارها قائمة في طيات السرود الحديثة.
- ما دمت نذرت نفسك لكشف الوظيفة التمثيلية للسرد العربي، وعالجت صلة السرد بمرجعياته الثقافية والتاريخية، فأجد من الضروري أن نعرف رأيك بالصلة بين الأعراف الاجتماعية والأعراف السردية، فذلك يظهر موقفك من طبيعة المادة السردية التي انكببت عليها مدة طويلة؟
*يلزم القول بأن الأعراف الاجتماعية سدود كابحة للخيال السردي؛ لأنها نواميس استقرّ عليها الناس من عادات وتقاليد ناظمة لشؤون حياتهم، وفي عالم السرد لا ينبغي الاهتمام بأعراف الواقع؛ فالعالم المتخيّل يفوق الحقيقي في احتمال وجوده، وكلما توغّلنا فيه وجدنا أنفسنا راغبين في هجر العالم الأخير، والاستغراق في العالم الأول، ففي ذاك تتحقّق الهوية التي حالت الأعراف من دون تحققها، وحشرتها في أطر ضيّقة ليسهل تعريفها، وذلك نزوع لا يتوافق مع البراءة الإنسانية، ولا يستجيب للخلق البشري، وفي هذا تنهار مقوّمات الأعراف، فتفصح الهوية عن ذاتها كما هي عليه قبل إعادة تشكيلها، وعليه يؤدّي السرد وظيفة تأصيل الوجود الإنساني بمنأى عن هيمنة الأعراف، ومع ذلك، فالمرء بحاجة إلى علامات يهتدي بها لكي يخوض في غمار العوالم المتخيلّة، وهي: اللغة المجازية، وتقدير قيمة الحبك، والتصديق بالمحاليّات، والاستنكاف عن المعرفة الوصفية، وترقّب المعرفة الظنية، ومشاطرة الشخصيات الإيمان في تقرير مصائرها، والإحجام عن اقتراح مصائر بديلة، وتلك، بمجموعها المتظافر، من أهم أعراف السرد، وهي غير أعراف الواقع الهادفة إلى تنميط العلاقات الإنسانية، وصوغها في ضوء شروط الواقع، فيما توقد أعراف السرد فتيل الرغبة في بلوغ عوالم تتحلّل الأحداث فيها من أي شرط مقيّد لها، والحال، فلا ينبغي نبذ أعراف الواقع، والأخذ بأعراف السرد في غير المقام المناسب لهما، فلا تفعل أي شروط هذه الأعراف فعلها في غير السياق الخاص بها، وإذ انفض يديّ عن أعراف الواقع إذ لا أجدني مؤهّلا للبت في أمرها، فأتمسّك بأعراف السرد التي أرها جليلة الفائدة في الانطلاق من التخوم الفاصلة بين عالم الواقع وعالم السرد إلى رحاب العالم الأخير الذي افتضّه الخيال. وقد يثار اعتراض مفاده أن السرد هو تخييل للواقع، فنكون بإزاء عالم جرى تمثيله بالسرد. ثمة وجه صائب في هذا التفسير، ولكنّه دون ما يتطلّع إليه السرد الذي يذهب به فضوله إلى ابتكار عوالم موازية لعالم الواقع، إنما القارئ المؤوّل هو الذي يسعي إلى العثور على ما يحيله من قرائن ترجّح شيئا من المطابقة الافتراضية فيما بينهما، ويخلع هذا التفسير قيمة دنيوية على وظيفة السرد، ولكن لا ينبغي حبسه فيها، فلا تنتزع هوية التعبير السردي بالمماثلة، إنما بالمغايرة.
ربما يقع احتجاج على عوز أحداث الواقع عن الترتيب، ولكن من قال إنّ أعمال السرد كلها خاضعة لنظام دقيق في ترتيب أحداثها؟ لو وقع إقرار ذلك، على سبيل الاحتمال، فالمقصود به الأعمال المحكومة بحبكات صارمة، فتكون خاضعة لسببيّة سردية في ترابط أحداثها، ولا يتوفّر ذلك في أغلب الأعمال السردية، فتيارات السرد الحديث، ومنها رواية تيار الوعي، لا تولي اهتماما للحبكات الناظمة، وبها تستبدل وعي الشخصيات بعوالمها المتخيّلة، وبذلك تنهار حجّة من حجج الاختلاف بين العالمين الواقعي والسردي. إنّ الظاهرة السردية برمّتها فعل اجتماعي ما خلا الأفعال التي تقوم بها الشخصيات؛ لأنها منسوبة لشخصيات متخيّلة. السرد يفارق الواقع، ولكنه لا ينقطع عنه. والأحداث سواء حصلت في الواقع أو أنها قابلة للوقوع في السرد، فهي متآزرة في سيرورة حدوثها، أي في تطورها وامتدادها وتشابكها، وكون مجموعة منها يقوم به الانسان في الواقع، وأخرى تقوم به الشخصيات في العالم المتخيّل، لا يجردهما من التعاضد، والتفاعل، فليس لأحد إنكار الوظيفية التمثيلية للسرد، فهي وظيفة اجتماعية، وتجارب الأفراد في العالم الواقعي، بل وتجارب الجماعات، ثم تمثيلها في السرد، تردم الهوة الفاصلة بين العالمين، وبالأحرى تمدّ جسرا رابطا فيما بينهما. ومهما كان الأمر فلا يجوز تجريد وظيفة السرد من بُعدها الاجتماعي، ولا يصحّ قصرها على المستوى الجمالي، فذلك، إن وقع، ينتهك ماهية نشاط بشري بالغ التأثير في تاريخ الإنسان.
وبصرف النظر عن إمكان وقوع أحداث العالم المرجعي واستحالة وقوعها في العالم المتخيل، فلا ينبغي فصم الصلة بين العالمين، فليس المهم وقوعها أو عدم وقوعها، إنما المهم التصديق باحتمال حدوثها سواء حدثت فعلا أو أنها قابلة للوقوع في السياق الحاضن لها، فذلك يجعلها مدركة بالعقل أو بالمخيّلة، أو بهما معا. وصار من الضروري إبرام عقد مرن ينصّ على انسراب شذرات من ذاك إلى هذا. وعليه ليس لأحد الادّعاء بقطع صلة عالم السرد بعالم الواقع، وذلك لو حدث، فهو لا يفيد أيّا منهما، وما حدث لهما أن تبادلا الاستبعاد؛ فالبنيات المتخيّلة التي يقترحها السرد، وتلك التي يطرحها الواقع، قابلة لمزيج من الادراك التخيّلي والعقلي، ولا يصحّ الانتصار لأيّ منهما على حساب الآخر، فالمفاضلة فيما بينهما تقوم على مبدأ آخر له صلة بتصديق أحداث الواقع، وتكذيب أحداث السرد، وهو موضوع لا علاقة له بهما في إطار العمل الأدبي، فهما مرتبطان بمشترك أعلى، وهو مشترك الرؤية الناظمة لأحداثهما، ولما كانت أحداث العالم المتخيّل تتلوّن بالرؤى السردية التي تخلع عليه تنوّعا، فلا يغيب ذلك عن أحداث العالم الواقعي التي تخضع لرؤى الأفراد والجماعات، فلا تُعرض إلا ضمن رؤى تتولّى تركيبها، أو أنها تعيد تركيبها، على وفق شروط تلك الرؤية، وهو المبدأ الذي يقوم عليه عالم السرد.
- بعد هذه الرحلة الشائقة معك أريد أن تطلعني، وتطلع القرّاء، على الطريقة المعتمدة لك في التأليف، باختصار أنتظر منك جوابا صريحا عن السؤال الآتي: كيف يكتب عبدالله إبراهيم؟
- كأني بك تريد أن أكشف سرّ مهنتي الكتابية، فأسارع إلى القول بعدم وجود سرّ سوى الانكباب على الكتابة، ثم الانكباب عليها من دون ملل، ومع ذلك فالأمر يحتاج إلى وصف للطريقة التي اتبعتها في التأليف، فلما كان السرد العربي هو مادتي الأساسية، فقد قامت علاقتي به على دوام التفكير بكل ما له علاقة به، ودوام التفكير بموضوع البحث هو أحد الأسرار الكبرى للتأليف الذي لا ينضب معينه؛ لأنه يتغذّى يوما بعد آخر بالأفكار الجديدة، ويتخلّص من العتيقة التي لا تُشبع عقلا، ولا تُسمن قضيّة، والى ذلك فدوام التفكير بالعالم، وبالظواهر المهمة فيه، هو الذي يعطي معنى لحياة الكاتب، فيرتقي به من الرتبة البوهيمية إلى الرتبة البشرية، بل يدفع به إلى آفاق الإشراق الفكري، وشغف المعرفة، ومن دون ذلك يشحّ معينه، فلا هو قادر على الوفاء بما يريد، ولا هو قادر على هجر عمله، فتصبح كتابته خطوات منقطعة عن ثقافة عصره، وسرعان ما يتوقّف بعد بحث أو كتاب، فقد نشفت بئره، ويتعذّر النهل من بئر جافة.
تتراوح الكتابة عندي بين المكابدة والشقاء من جهة، والحبور والابتهاج من جهة أخرى، فالإعداد لها يلزم جهدا بالغ الصعوبة قوامه النبش عن الأفكار في المصادر، والتمحيص الهادف إلى توفير الدقّة، والتفكير المتواصل فيما ينبغي قوله، أما تنفيذها فرحلة مبهجة تدفع بي إلى ذرى المتعة العقلية والنفسية، وبمداومتي عليها أصبت بالشغف، فلا أكاد أرى لها بديلا في حياتي، فانتهت حوارا مثمرا تفاعلت في إطاره رؤاي ومواقفي بمعطيات العالم الذي أعيش فيه، فأحدث ذلك لدي شعورا بالتوازن، فتوارى شقاؤها، وأضحت بهجة دائمة. أبدا ما شعرتُ بثقل التعبير عن أفكاري، غير أنني شقيت في جمع الآراء التي رأيتها تسهم في تغذية أفكاري، وليس يجوز الادّعاء بما يخالف ذلك، ففي نهاية المطاف إنما الكتابة ممارسة لحياة متخيّلة ترتبط بوشائج قوية مع الواقع. وما دامت كذلك، فلا يصحّ رميها بالسوء، ودمغها بعدم الأهمية، فإنما يقع اختصار العالم بالكلمات، والكلمات هي مادة الكتابة.
في كلّ ما له صلة بالكتابة لا خوف من التصريح بالحقيقة، بل الاحتراس من المبالغة؛ فإن خاطرت، وأجبت على سؤالك بدقة، فهذا يعني التفكير بمئات الصفحات التي كتبتها، ولم تظهر في "موسوعة السرد العربي"، أو في "المطابقة والاختلاف"، فأين ذهبت تلك الصفحات الطوال، وما مصيرها؟ أجيب، ببساطة، إنها أُزيحت، وجرى إقصاؤها، وما عاد أمر العثور عليها متاحا؛ لأنني أخذت بطريقة محو المسوّدات الأولى بتعديلها الدائم، وتطوير الملاحظات بتوسيعها الذي لا يعرف الكلل، والتوسّع في التعليقات بجعلها فقرات كاملة، ولم أحتفظ إلا بالصيغ النهائية، أو شبه النهائية، مما كتبتُ، وقد أفنت ما سواها، وطوته في داخلها، فلا أثر لها. فأين منيّ تلك الخواطر النافذة، وأنا أحتسي فنجان قهوة في هذا المقهى، أو في قاعة تلك المكتبة، أو صالة هذا الفندق، أو في أروقة ذلك المطار! وعلى الأخصّ حينما أنكبّ خلال الليل على مصادري، وإلى جانبي دفتر صغير لا يلبث أن يمتلئ بالملاحظات، فأستبدله بآخر، ثم آخر، وكلّما مضيت في القراءة بالغت في تدوين خواطري بفقرات مسترسلة لها صلة بما يستحثّني الكتاب عليه من أفكار، ويعجزني، بمرور الوقت، أن أفكّ خيوط تلك التعليقات لكثرتها، وتداخلها، فأستخلص من قليلها ما أراه مناسبا، وأرميه في المكان المناسب له، وأصرف النظر عن كثيرها حينما أفركه فلا أراه مناسبا؛ لأنني فقدت السياق الذي كتبته فيه.
والغالب عليّ هو إعادة النظر في تلك الملاحظات، وإيداع خلاصتها في ملفّ له صلة بالكتاب الذي أعمل عليه، ولا أتوانى عن دسّها في المكان الذي أجده لائقا بها، فتكون هذه في صفحاته الأولى، وتلك في صفحاته الأخيرة، ومعظمها يتناثر في تضاعيف الكتاب، وبمرور الأيام، والأشهر، والسنوات، تختفي أصولها الورقية بسبب الترحال بين البلاد والمنازل، أو التلف الذي تعرّضت له مسوّدات مؤلّفاتي، وأصولها الخطيّة المجلّدة بسبب إحراق مكتبتي، أو تتوارى ملفّاتها عنّي جرّاء تبديل الحواسيب الشخصية بين وقت ووقت، أو أفقد أثرها بين عدد يعجزني إحصاؤه من الملفّات الرقمية التي أضلّ طريقي في بلوغ غايتي منها، وإلى ذلك فلا أعرف مكان بعضها في الكتاب الذي أودعتها فيه؛ لأنها ذابت في صفحاته بعد التحرير. ويذكّرني سؤال الكتابة بالصفحات التي محوتها حينما كانت عزيزة عليّ في بداية أمرها، ثم فقدت بريقها عند التحرير الأول أو الثاني أو الثالث للكتاب، حيث لا يكاد يرضيني شيء، فأعدّل وأغيّر، وأدمج وأفرّق، وأمحو وأزيد، ولو أطلقت العنان لنفسي لمحوت الكتاب برمّته من شاشة الحاسوب؛ فالكتابة ليست هذرا بقصد الثرثرة، ولا لغوا بغاية الإكثار من الكلام، ولا حشوا لجراب لا زاد فيه، بل هي إفصاح عن القصد بإيجاز لا يخلّ، وإبلاغ عن غاية تفي بالحاجة، وتؤكّد الغاية، وينبغي على الكاتب التوقّف على كل جملة، والتأكّد من هدفها، ووظيفتها في السياق؛ هل هي معرفية أو إخبارية أو ترويحية أو توضيحية، وحينما لا يجد لها وظيفة فيجب عليه ضغط زر الحذف من أجل محوها.
- يقال إنك كثير المراجعة والتحرير والتدقيق فيما تكتب؟
* هذا صحيح، فقد لازمتني عادة درجتُ عليها، وأمست نهجا سرتُ عليه، ومؤدّاها عدم مقدرتي على مقاومة هوس إعادة النظر بما أكتب جرّاء الرغبة في الإتقان، وإحكام الأفكار بضبط صيغ التعبير عنها، والتوق إلى الاكتمال الذي لا سبيل إلى بلوغه، وقد أفضى إلى اختلاف في كتبي بين طبعة وأخرى، ومردّه دوام المراجعة حين إعداد أيّة نشرة جديدة منها من دون تهيّب، ولا أرى في ذلك عيبا، وليس هو بمثلبة عندي، بل مزية اقتضاها شرط التأليف الصحيح، وفرضتها عليّ أعراف الكتابة الصائبة؛ فليس ينبغي غلق ملفّ الكتاب، ودفنه، بل تركه مفتوحا يواكب جديد المعارف والثقافات، فيحدّث نفسه من مناهلها كلما اقتضى الأمر، ويرتوي من منابعها، فلا ينقطع عن سياق عصره، ولا يكتفي بخطرات التأليف الأولى، وإنما التأليف سبك، وإعادة سبك، للهواجس والأفكار، وصقلها بما يجعلها مصدرا للمعرفة، ومنبعا للثقافة.
غير أن الأهم، في تقديري، هو الخطّة العامة للتأليف التي أخذت بها منذ وقت مبكّر في عملي النقدي، ولازمتني حتى النهاية، وطبقتها في تأليف الموسوعة، ولا مناص من شرح جوهرها في هذا السياق، فقد عاهدت نفسي في النصف الثاني من ثمانينيات القرن العشرين أن أصنّف كتابا موسوعيا عن الظاهرة السردية عند العرب، وشغلت بالموضوع انشغالا تاما، ودوّنته في يومياتي في منتصف أيار/ مايو من عام 1988 حيث ورد بالنصّ أنني منذ مطلع ذلك العام "تلحُّ عليَّ فكرة مهمة، أعدّها أحد المشاريع الأساسية في حياتي، وربما أهمها في مجال البحث والنقد، وتتلخَّص في فحص السَّرد العربي وتوصيفه، وتحديد نُظمه السَّردية، كسجع الكهان، والقصص القرآني، والحكايات، والمقامات، وألف ليلة وليلة، والسِّيَر الشعبية، وأهدف بهذا المشروع إلى كشف الأنظمة السَّردية في النثر الحكائي العربي منذ القدم إلى الرواية العربية الحديثة، وسأقترح من الآن عنوان هذا البحث "السَّردية العربية: دراسة لنظم السَّرد العربي"، ويتطلَّب منِّي هذا المشروع الإعداد له إن كان في دراسة النصوص المذكورة، أو المصادر الأساسية، والمراجع الحديثة؛ فالموضوع يندرج في صميم دراسة الثقافة والمخيّلة العربيتين، ويلاحق تطورهما، ولا بد من دخوله مسلَّحا برؤية حديثة، وبمنهجية حديثة، وصولا إلى تحقيق هذا الهدف".
لم أتمكّن من الوفاء بوعدي كاملا إلا بعد زهاء ثلاثين سنة حينما تكلّل عملي بصدور الطبعة الوافية من "موسوعة السرد العربي" في تسعة أجزاء في عام 2016. ما الذي شغلت به خلال تلك العقود الثلاثة؟ كان شاغلي البحث في الموضوع الأثير إلى نفسي، والبحث عندي مزيج متداخل من القراءة، والإعداد، والكتابة، والتحليل، والتحرير، والتصحيح، والفهرسة، والطبع، وخصّصت الجزء الأكبر من ذلك الوقت الطويل للاطلاع على آلاف المصادر والمراجع عن الظاهرة السردية قديمها وجديدها، والاعتكاف على المصادر الأصلية، وإهمال الوسيطة إلا عند الضرورة القصوى. كانت هذه خطوة أولى من مشروع طموح بدأ يقترح عليّ أمورا لم تحضرني بتفاصيلها حينما عزمت على تنفيذ فكرة الكتاب الموسوعي، فكلّما توسّعت في القراءة تشعّبت القضايا موضوع البحث، وكلّما غصت في مصادر حقبة من حقب السرد قادتني إلى مصادر حقبة أخرى.
اتّبعت خطة محكمة أنفّذ بها مشروع الموسوعة، أقول محكمة مع ما يوافق طريقتي في التأليف، وهي طريقة مرنة، ولا تتعمّد الانغلاق على موضوعها، إنما مدّ صلته بالموضوعات المتاخمة له، وهي أن أبدأ بالجزء وصولا للكلّ، ليس الكلّ النظري، بل التطبيقي الذي لا يكتمل إلا بالتدرّج في تأليف سلسلة من الكتب المترابطة في باطنها، والمنفصلة في ظاهرها، تجعل من المشروع حقيقة مهما طال الزمن بي؛ فكلما انتهيت من موضوع له صلة بمشروع الموسوعة في حقبة زمنية أدفع به للنشر كتابا قائما بذاته، وعلى هذا المنوال تعقّبت الظاهرة السردية خلال 1500 سنة في ثمانية كتب هي في الحقيقة لبّ "موسوعة السرد العربي"، وفيما توهّم بعض القرّاء أنني أصدرت ثمانية كتب في ربع قرن حول السرد العربي القديم والحديث، كنت كتبت الأجزاء الثمانية من سِفر موسوعي وضعت تصميمه قبل وقت طويل من إكماله، وتدرّجت في استكمال متنه عاما بعد عام.
اعتدت أن أغوص في موضوعي غوصا كاملا، فلا يكاد يشغلني أمر سواه، فبعد أن وضعت الإطار المرن للموسوعة، شغلت بالأجزاء المكوّنة لها، فاصطنعت خطّة لكل كتاب، وتولّيت تقسيمه إلى فصول، ثم تقسيم الفصول إلى فقرات، فأكتب ذلك فصلا بعد فصل، وحالما أنتهي من الكتابة الأولية لفصل من الفصول أقوم بتقسيم فقراته على عدد من المقالات تبلغ نحو عشر في المعدّل العام، فأنصرف إلى تحريرها حسب معايير النشر، وخلال مدة نشرها في الصحافة التي تستغرق نحوا من ثلاثة أشهر، أكون قد انتقلت إلى كتابة الفصل التالي من الكتاب، ويضع اكتمال نشر مقالات الفصل الأول تحت يدي مادة ينقصها الترابط، والتوثيق، والتوسّع، فأتولّى كل ذلك، مع تحرير الفصل مرة أخرى بما يفي الموضوع، وأنزع عنه ما يوحي بنشره في مقالات متفرّقة؛ لأنه كُتب في أصله فقرة من فصل، وفصلا من كتاب، وكتابا من مشروع.
وحينما أنتهي من تحرير الفصل بصورته الجديدة الموثّقة أنشره بحثا معتمدا في مجلة علمية محكّمة أو مجلة ثقافية مرموقة، وعلى هذا يبدأ نشر بعض البحوث/ الفصول في المجلات الكبرى، وأنا منهمك في إكمال الفصول الأخرى من الكتاب، وحينما أفرغ من ذلك أجمع الفصول حسب الترتيب الذي أراه مناسبا لخطتي الأصلية، وأبدأ في تحرير الكتاب من البداية إلى النهاية، بما في ذلك المقدمة، والخاتمة، والمصادر، والفهارس، فأضيف ما أراه مفيدا، وأحذف ما أجده غير ذلك، ثم أدفع الكتاب إلى مصحّح ضليع يمحو أيّ هفوة سقطتُ فيها، وينزع أيّ خطأ وقعتُ فيه خلال مراحل الكتابة الثلاث، ولا أكتفي بذلك، بل أتعقّب صحّة كلّ شيء مع الناشر، فأطلب تصحيحا وفهرسة لكتبي المفردة، وأخيرا أشرع في الترتيب والتصنيف، والتقديم والتأخير، فأحذف المقدّمات التي لزمها نشر كتاب مفرد، وأدرج ما أظنه يعمّق الأفكار الخاصة بالموسوعة فقد اتسع فضاء التأليف، وصار قابلا لمعظم ما أريده، ولَم أتمكّن منه من قبل، بما في ذلك سعة الرؤية للموضوع، وتغيير الأسلوب، والتحقّق من الفرضيات، والبرهنة عليها، وهو أمر أبذل فيه جهدا لا يقلّ عن جهد التأليف في صورته الأولى. وحينما قررت نشر الصيغة الوافية لموسوعة السرد العربي قدّت فريقا متخصّصا بالتصحيح والفهرسة عاونني في التدقيق النهائي، خشية الوقوع في خطأ ما عادت أمامي أية فرصة أخرى لتحاشيه، وبهذه الطريقة لم أفرغ من التأليف يوما إلا ما ندر، فينبغي عليّ، ما دمت قد اخترت ذلك، أن أتولّى المراحل كافة يوما بعد يوم، وإلا أكون قد تنكّبتُ لوعدي الذي عاهدت به نفسي، وأنا في مقتبل عمري الثقافي.
- أرغب في أن تحدثنا عن سيرتك الذاتية "أمواج"، ففيها قدمت طريقة جديدة في كتابة السيرة الذاتية، طريقة السهل الممتنع، طريقة سردية ممتعة في معالجة الأحداث والتجارب العامة والخاصة، كيف تنظر الى دور فن السيرة الذاتية في ارساء قيم جديدة تقرب المسافة بين صاحب السيرة والمتلقّي؟
* أعترف بأنني شغوف بقراءة السيرة الذاتية، وأجد من الواجب أن تطرق باب المنطقة السريّة في حياة صاحبها وإلا فسوف تفقد جزءا كبيرا من وظيفتها، وذلك هو الجزء الجوهري في كل كتابة ذاتية. لكنّ لذلك محاذير شتّى، إذ يخشى أصحاب السير الغوص في حيواتهم السرية للاعتقاد الشائع أنها نوع من العار، فيطمسون ما أراه شرطا أساسيا من شروط السيرة الذاتية، وليس ينبغي التكتّم على ذلك لأن البطانة الذاتية للمرء هي المكوّن الأول لهويته الشخصية، بل أراها المانح الشرعي لكتابة السيرة الذاتية، كما لا يجوز إغفال الحياة الخاصة للكاتب لأنها تتصل بمسار نشأته وتطوره، واداركه للعالم المحيط به، وأخير ينبغي أن يقدّم كاتب السيرة شهادته الكاملة على عصره، ويكشف تطوّر وعيه بأحداث زمانه، وإلا جاءت السيرة خلوا من الأهمية التاريخية. ولكل هذا أوافق" فيليب لوجون" في نفي أن تكون السيرة الذاتية "رواية من لم يكونوا روائيين" جريًا لما يشيع عن كونها كتابة نرجسية مسطحة. من الضروري، في تقديري، أن يدمج كاتب السيرة الذاتية بين السريّ والخاص والعام، ولا يحق له أن يبالغ في الاهتمام بمستوى دون آخر، وعليه ألا ينظر بتحيّز مسبق إلى تجربة حياته بأنها منزّهة عن الأخطاء، فحياة الإنسان لها ثلاثة مستويات أساسية: حياة سرية، وحياة خاصة، وحياة عامة، وليس يجوز له، بذرائع أخلاقية أو دينية أو اجتماعية، حجب مستوى والاهتمام بآخر.
ولعل السؤال الذي تثيره كتابة السيرة الذاتية، ومنها سيرتي( أمواج) عن جرعة الاعتراف فيها، فأقول بأن التجارب الذاتية سجل للإخفاقات والنجاحات، وتخطّي العثرات، وفيها كل ما يسرّ القارئ ويغيظه، ولعل كثيرا من الكتاب يجفلون من تجاربهم التي استحالت إلى ذكرى، فيطمرونها كعار، وبها يستبدلون تاريخا مجيدا لحياتهم، بأن يشيحوا عنها بوجوههم، أو يراوغوا، أو يمّوهوا، وربما يزينوا، أو يلطّفوا، ومن النادر أن يجرؤ امرؤ على تحقيق درجة كافية من المطابقة بين ما وقع وما روي، ولا يعود ذلك إلى تجنبهم البوح الصادق أو التكتّم فقط، إنما لأن تمثيل التجارب من خلال السرد يعيد إنتاجها في سياق مختلف. وقد سعيت إلى تخطّي ذلك، في السيرة اعترافات صريحة تعذّر عليّ كتمها، وهي ليست تجارب خاصة، فحسب، بل آراء كثيرة جهرت بها، ومع ما سوف يترتب على ذلك من سوء فهم، وتقويل، وافتراء، فقد أخلصت فيما أردت قوله ووصفه، فلا يعاب على المرء التصريح بأمر، إنما يعاقب عليه الإخفاء والطمس والهرب من قول الحقيقة. وكل ذلك ورد في شكل أدبي اصطلحت عليه بالأمواج، وهو شكل اهتديت له في كتابة سيرتي، وأنا أدمن الوقوف على شواطئ البحر الأبيض المتوسط وسواحل الخليج العربي حيث لاحظت الأمواج المتلاحقة التي زرعت في نفسي فكرة أن حقب الحياة كأمواج تتدافع ثم تتلاشى، فهي تنبثق من عمق اليم، وتتبدّد على سواحله، وكان لذلك مفعول السحر في نفسي. وعلى فكرة متوالية الأمواج بنيت فصول السيرة، وكما أن الأمواج تكون هائجة وصاخبة أحيانا، وهادئة بطيئة أحيانا أخرى، فكذلك أمواج السرد في الكتاب الذي استغرق صوغه عقدا ونصف، وبذلك أقمت الكتاب على شكل سردي له صلة بأمواج البحر دون سواها، ولعل تلك هي أمواج الحياة في العراق.
وأحبّذ لكاتب السيرة ألا يؤخّر كثيرا كتابة سيرته ونشرها لأن النسق الاجتماعي والديني والسياسي سوف ينطبق عليه فيحول دون جهره بالوقائع التي عاشها، ولذلك تنطفئ حرارة التجارب لا أوصي بتأخير ظهر كتب السيرة الذاتية إلا لأسباب قاهرة، فكلّما تقدم العمر بالمرء في داخله، ففي مجتمع ضاغط، ومجهّز بنظام شامل من قيم الامتثال والولاء، تتراجع فردية المرء واستقلاليته كلما خطا به الزمان إلى الأمام، فينتهي مرائيا أكثر منه فردا قادرا على الإفصاح عن نفسه، وتجاربه، وأخطائه، وعيوبه؛ لأن الاعتراف بذلك يُنبذه من سياق مجتمعي هو بحاجة إليه. وقد عشت هذه الهواجس وانا اكتب سيرتي الذاتية، إذ غشتني مخاوف من ألاّ أتمكن من ذكر الأشياء فيما بعد، وينبغي قولها وأنا على مشارف الخمسين. ولست على بيّنة نهائية من السبب الذي جعلني أفترض أن يكون سنّ الخمسين حدا فاصلا بين مرحلة القدرة على الجهر بالأشياء، ومرحلة التكتّم عليها، فربما خيّل لي أن خطّا وهميا يفصل بين حقبة القوة وحقبة الضعف، أي بين التفرّد والامتثال، وما نتمكّن من قوله ونحن أقوياء لا نتمكّن من الإفصاح عنه ونحن ضعفاء، فنبرة التودّد، والخجل تستفحل بالتدريج في الحقبة الثانية، وذلك يغيّر أو يزيف كلّ ما وقع في الحقبة الأولى، فتجارب التكوين الذاتي تتشكل بمعظمها في الأولى، واستعادتها في الثانية، هو نوع من اقتلاعها وترحيلها، وذلك فيما أرى يُحدث هوة لا تردم بين التجربة والإحساس بها، فحينما يصبح المرء مدينا لحقبة، لن يكون قادرا على روايتها بأمانة، وسيقع تحت طائلة التحيّز، بل ويسبغ عليها ما يرغب فيه الآخرون، تجنبا لإثارة لغط سينبثق لا محالة في الوسط الذي ينتمي إليه، فهو يريد أن ينتهي بريئا قبل أن يطبق عليه جفن الردى، وبحاجة إلى شهود على براءته، وليس مشاركين له في تجربته الحقيقية، فكأن الحياة، في المجتمعات التقليدية، تهمة ينبغي علينا ختمها بصك براءة، وطمرها. أتمنى ألا أكون قد وقعت فيما حذّرت منه.
- أفهم أنه من الضروري أن تكون تحت يديّ كاتب السيرة الذاتية يوميات خاصة به ؟
* هذا ما أراه بعد أن مررت بتجربة كتابة سيرتي الذاتية، فأحبّذ أن يعتمد كاتب السيرة على يومياته أو الوثائق التي حوزته، ومع أن أغلب الكتاب العرب لا يهتمون بكتابة اليوميات، فلعلها تكون أهم سجل شخصي للكاتب، سجل يودع فيه تجاربه، وتطور وعيه، واكتشافه لنفسه وللعالم الذي يعيش فيه، ومن غير ذلك فمعظم الأشياء تتوارى خلف النسيان، ولا يقنعني أي حِجاج بأن الذاكرة أمينة على أحداث طمرتها احداث، ويمكن استعادتها بسياقها بعد عقود من الزمان، فاليوميات هي السجل الكاشف لحال كاتب السيرة، وهي المادة الخام التي يلوذ بها لاستعادة الأحداث التي عاشها، ومنذ الصبا كنت ولوعًا بتسجيل الخواطر، ثم قطعت ذلك بأن بدأت أدوّن يومياتي في شتاء عام 1976، وها قد مضى على ذلك أكثر من أربعين سنة استقام خلالها لديّ خمسة عشر مجلدا، فيها كل ما مرّ بي أو شهدت من أحداث على المستويين الخاص والعام.
استلهمت سيرتي رحيق اليوميات بدءا من الالتماعات الشعرية إلى المغامرات الشخصية إلى الأحداث الخطيرة، وكشفت اليوميات، ثم السيرة، شخصا تورط بأخطاء الجاهل، وسيطر عليه الوعي الزائف بما وقع في بلاده، ومرّ زمن طويل قبل أن يكتشف ذلك، ويسعى إلى معرفة الحقائق بما يعتقد أنه وعي أصيل، فاليوميات من هذه الناحية مدوّنة لتطور الوعي بالأحداث، وهو تطور بطيء، وفيه ارتدادات، ولو وضعت تحت معيار مفهوم القيمة لوجدنا فيها ما يخجل ويعيب من جهة، وما يسبب السخرية والضحك من جهة ثانية، وما يثير العجب من جهة ثالثة. وكل ذلك ليس لأهمية الوقائع أو ضحالتها، إنما للطريقة الصريحة التي رويت بها. ففي نهاية المطاف كنت مسكونا بهاجس الصدق فيما كتبت، وهو صدق نسبي، يتضح في كثير من الأحيان أنه سيل من الأخطاء في ضوء الأحداث اللاحقة، ومع ذلك فهو جزء من التاريخ الشخصي ولا ينبغي محوه، ولا حتى الخجل منه، فذلك أمر وقع.