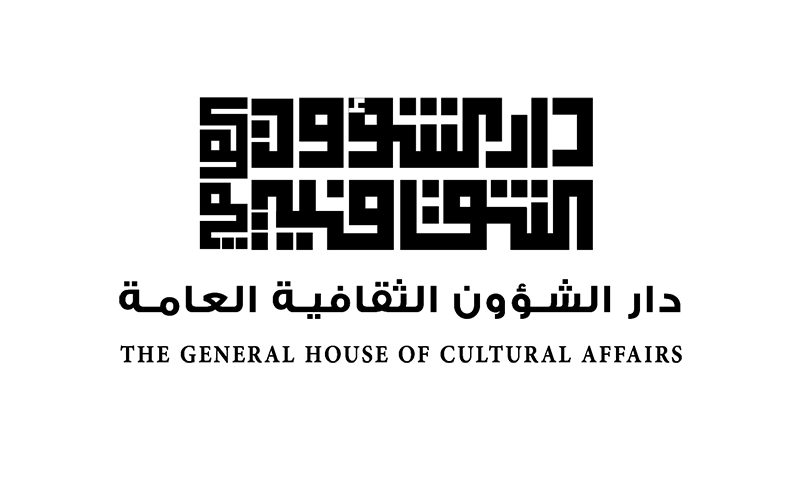دراسات وبحوث
رِسَالَةٌ فِي البَسْمَلَةِ للشَّيْخِ مُهَذَّبُ الدِّيْنِ أَحْمَدُ بِنْ عَبْدِ الرِّضَا البَصْرِيُّ
رِسَالَةٌ فِي البَسْمَلَةِ
للشَّيْخِ مُهَذَّبُ الدِّيْنِ أَحْمَدُ بِنْ عَبْدِ الرِّضَا البَصْرِيُّ
كَانَ حَيًّا سَنَة (1085هــ)
تَحْقِيْق
أ.د حَمِيْد الفَتْلِيّ
كُلِّيَّةُ الآدَابِ - جَامِعَةُ بَغْدَادَ
مقدّمة المحقّق:
بسم الله الرّحمن الرّحيم
الحمد لله, والصّلاة والسّلام على رسول الله، وآله الأطهار، ورضيّ الله عن صحابته، ومن اهتدى بهداهم إلى يوم الدّين.
وبعد:
فقد أولى المسلمون البسملة عناية كبيرة, فتناولوها بالشّرحِ, والتّفسير كلّ بحسب اختصاصه، فاللّغويّ اعتنى بألفاظها وتركيبها وأصواتها ودلالات كلّ اسم فيها. والصّرفي تناول ما ورد فيها من أسماء فذكر اشتقاق كلّ اسم منها، فقد عُنو كثيرًا باشتقاق (الاسم) وأوزانه وتصاريفه والإبدال الحاصل فيه, مشيرين إلى الحذف والتّعويض الذي جرى عليه فلم يُغفلوا مسألة اشتقاق لفظ الجلالة إذ جرى الخلاف بينهم في كونه اسمًا أو صفةً، فضلًا عن الاسمين الكريمين, أعني: الرّحمن والرّحيم، فأشاروا إلى وزنهما ودلالة المبالغة فيهما وسرّ تقديم أحدهما على الآخر.
وكان للنّحويين سَهمٌ في هذه الآية المباركة فقد حلّلوها تحليلًا نحويًا وأشاروا إلى الوجوه المحتملة في إعراب كل اسم منها وما يبتنى على ذلك من دلالات مبينين الحذف والتّقدير وتعلّق الجارّ والمجرور في هذه الآية.
فضلًا عن الفقهاء وعلماء الكلام الذين أدلو بدلوهم في البسملة, فبيّنوا وجوه الواجب والمستحب والجهر الإخفات فيها وغير ذلك من الأحكام الشّرعيّة.
واختلف المسلمون أهي آية من آيات القرآن أم هي مجرد فاصلة تفصل بين سوره, وغير ذلك من الأحكام التي أشار إلى بعضها المصنّف في هذه الرّسالة.
ولَمْ ننسَ أقوال المفسرين فيها, فقد أوّلوها عناية فائقة، ونتيجة لعناية المسلمين بها ولأهميّتها في حياتهم فقد وضعت فيها المؤلفات العديدة ولا نغالي إذا ما قلنا: إنّ البسملة على قلّة مفرداتها قد أخذت المساحة الأوسع في الفكر الإسلاميّ واحتلّت المكان الأرحب في مصنفاتهم واستقلّت بمؤلفاتٍ منفردة أكثر من غيرها من آي القرآن.
وكان للشّيخ مهذب الدّين أحمد بن عبد الرّضا البصريّ حظٌّ في هذا، فقد وضع رسالة في البسملة, تناول فيها معانيها وبعض أحكامها الشّرعية، وتحدّث عن الجوانب اللّغويّة ثمّ بيّن بعض فضائلها مستندًا إلى أقوال النّبيّ وآله صلّى الله عليهم وسلّم أجمعين، وهي رسالة رشيقة جامعة مانعة أفاد مؤلفها ممَن سبقه من العلماء، لذا فإنّها تحوي على فوائد جمّة, ونكات لغويّة لطيفة, الله أسأل أن ينفع بها أهل العلم ومريديه.
المحقّق
تنويه
بسم الله الرّحمن الرّحيم
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: ( •• )( ) وقديمًا قالوا: (لا يعرف الفضل لأهل الفضل إلّا ذوو الفضل).
وإيمانًا منّي بضرورة حفظ الحقوق والتزامًا بالأمانة العلميّة, أقول: إنّه بعد الفراغ من تحقيق هذا النّصّ وإمضاء مدّة زمنيّة ليست بالقليلة على دراسته واخراجه بالصّورة التي هو عليها الآن, وبعد الاتّفاق مع هيئة تحرير مجلّة المورد الموقّرة لنشره, تبيّن لي أنّ هذه الرّسالة كانت قد حقّقت ونشرت في مجلّة إحياء تراث البصرة عام (2018) لمحقّقها الدّكتور قاسم خلف مشاري, وقد نبهني على ذلك المفهرس العراقيّ وعضو هيئة التّحرير في المجلّة الأستاذ الفاضل حيدر كاظم الجبوريّ, وبعد عقد مقارنة بين تحقيقنا والتّحقيق الآخر تبيّن أنّ هناك فروقًا واضحةً جدًا بين العملين, فدراستي كانت شاملة وموسّعة بشكل كبير وعمليّ في الحواشي كان مخالفًا جدًا عن عمل الأستاذ الفاضل, فكنت أحرص على مناقشة المسائل وشرح عبارة المصنّف إن كانت لغويّة أو فقهيّة أو عقائديّة بالرّجوع إلى المصادر في أغلب الأحيان, فضلًا عن أنّني قمت بتصحيح ما وجدته من أخطاء لغويّة أو صرفيّة أو نحويّة وردت في المخطوطة وهي ليست قليلة فكنت أُبقي النّصّ كما ورد عن المصنّف وأشير في الحاشية إلى الصّواب, وهذا ما لم أجده في التّحقيق الآخر. ثمّ أنّ المصادر والمراجع التي اعتمدتها تختلف كلًا أو بعضًا عن تلك التي اعتمدت في التّحقيق الآخر.
علمًا بأنّي لم أعثر على النّصّ المحقّق للأستاذ لأنّه غير منشور في المواقع الالكترونيّة, ولم أعلم بمكان نشره ولم يخبرني أحد بذلك إلّا في الفترة التي أشرت إليها آنفًا. وإنّي واثق بأنّ التّحقيقين يكمل بعضهما الآخر ويفضيان إلى خدمة القرآن والعربيّة. والله من وراء القصد.
المؤلّف في سطور
• اسمه:
مهذّب الدّين أحمد بن عبد الرّضا البصريّ، فاضل خبير, وعالم نحرير, مِنْ أصحاب الرّجال, وأرباب الكمال( ), أُخْتُلِفَ في اسم أبيه, فقيل: محمد رضا، وقيل: عبد الرّضا, وقيل: عبد الرّضيّ البصريّ( )، كان حيًا (1085هـ) ( ).
"تبحّر في أكثر علوم وفنون زمانه, أقام في مشهد الأمام الرّضا (عليه السّلام) بخراسان، وفي القرى التّابعة لها، وزار كابل وقندهار وشاه جهان ثمّ سكن حيدرآباد وصنّف فيها وفي المدن والقرى التي زارها جملة من الكتب.
تتلمذ على المحدّث الكبير محمد بن الحسن الحر العامليّ, وحصل على إجازة, وعُني بالحديث ومهر فيه وصار مِن حفاظ عصره، كان يحفظ إثنى عشر ألف حديث بلا إسناد, وألفين ومائتي حديث مع الإسناد"( ).
• مصنّفاته:
وله تصانيف عديدة منها:
1- تحفة ذخائر كنوز الأخيار في بيان ما يحتاج إلى التّوضيح من الأخبار. في مجلدين.
2- آداب المناظرة.
3- عمدة الاعتماد في كيفيّة الاجتهاد.
4- التّحفة الصّفوية في الأنباء النّبويّة.
5- التّحفة العلوية في الأحاديث النّبويّة.
6- الزّبدة في المعاني والبيان والبديع.
7- فائق المقال في الحديث والرّجال( ).
ومعظم هذه المصنفات لم تحقق
• وفاته:
اختلف في سنة وفاته, فقيل: إنّه كان حيًا سنة (1085هـ)، وقيل: توفى (1086هـ), أو (1090هـ) ( ).
الدّراسة
أضع بين يدي القارئ الكريم نصًّا محقّقًا لرسالة صغيرة في البسملة, لمؤلفها الشّيخ مهذب الدّين أحمد بن عبد الرّضا البصريّ وقد اشتملت على فوائد جمّة ونكات لغويّة وتفسيريّة وفقهيّة وبعض الرّوايات في البسملة وآثارها.
وجريًا على عادة المحققين في وضع دراسة تسبق النّصّ المُحقق، فإنّي أضع هذه الدّراسة اليسيرة قبل الشّروع في التّحقيق، وتبعًا لصغر هذه الرّسالة فإن الدّراسة ستكون ميسرة مقتضبة.
• أسلوبه:
من النّافع أن نشير هنا إلى الأسلوب الذي انماز به المؤلّف في هذه الرّسالة والكشف عن أهمّ ملامحه الأسلوبية:
1- استعماله ما يعرف بفنّ الفنقلة, وهو أسلوب تعليميّ درج عليه الشّيوخ مع تلامذتهم" يقوم أساسًا على طرح اشكالات بافتراض سؤال ثم الجواب عنه وذلك بتوضيح عدّة صيغ أشهرها: فإن قلت: كذا... فالجواب... كذا، أو فإن قيل: كذا, قلتُ: كذا, أو فإن قال قائل: كذا... قيل: كذا, وهي طريقة السّؤال والجواب. ولشهرة هذا الأسلوب نحت له العلماء مصدرًا سمّوه (الفنقلة) اختصارًا لجملة (فإن قلتَ... قلت...) كالحمدلة, والبسملة, وغيرهما"( ), وقد استعمل المؤلّف هذا الأسلوب في مواطن كثيرة, منها قوله: "فإن قلت ما معنى الباء فيه, وما معنى تعلّقها؟ قلت معناها الاستعانة...".
2- كان كثيرًا ما يميل إلى الأسلوب التّعليميّ, وكإنّه يتحدّث مع تلامذته بصورة مباشرة من قبيل استعماله فعل الأمر (فافهم، اعلم، فتأمل)، وقد درج على هذا الأسلوب في عموم الرّسالة.
3- كان كثيرًا ما يذكر مصطلحات فقهيّة أو منطقيّة وهو على المذهب الشّيعيّ الإماميّ، ويتّضح ذلك من بعض المباني الفقهيّة التي يؤمن بها ويتبناها، و من ذلك عدّه البسملة آية من آي القرآن الكريم, حين قال: "وآية عند قرّاء مكة والكوفة؛ لذلك يجهرون بها وهو الأصح" ، ويتّضح كذلك في الرّوايات التي كان ينقلها عن أئمة أهل البيت (عليهم السّلام) وهي غير واحدة في هذه الرّسالة, كان يكثر من استعمال المصطلحات الفقهيّة والمنطقيّة والكلاميّة، كاستعماله مصطلح الوجوب والإباحة والحرمة والكراهة بالنّسبة للفقه، وأما بالنّسبة للمنطق فكاستعماله مصطلح الدّور ومصطلح الاشتقاق الجعلي. وأمّا ما يتعلّق بمصطلحات علم الكلام فأنه كان يطلق مصطلح الواجب الحقّ أو ذات الواجب على لفظ الجلالة الله تعالى وهو من تعبيراتهم.
4- كان بصريّ المذهب, إذ أيّد البصريّين في جميع المسائل اللّغويّة التي تعرّض لها في هذه الرّسالة, فعلى سبيل المثال حين بسط القول في اشتقاق الاسم وبين أن الاسم مشتق من السّمو قال: " وما ذهب إليه البصريّون هو المختار وأمّا ما ذهب إليه الكوفيّون ففاسد من وجوه".
5- كان يذكر بعض العلل, وجميع تعليلاته كانت قياسيّة بسيطة ومن تلك العلل:
• علّة اختصاص: ذكرها معللًا تقديم الجار والمجرور (باسم) على متعلّقه وتقديره عنده إقرأ أو أتلو، فالتّقدير باسم الله أقرأ أو أتلو، وقد قدّم الجار والمجرور للاختصاص كما ذكر.
• علّة أولى: علّل بها لتقديم الجارّ والمجرور على متعلّقه, وهو الفعل (إقرأ) في قوله تعالى: " اقرأ باسم ربك الذي خلق".
• علّة تغليب: ذكرها وهو يتحدّث عن اشتقاق لفظ الجلالة الله, إذ أصله إله, وهو من أسماء الأجناس, كرجل يستعمل في كلّ معبود سواء كان المعبود بحقّ أو لا، ثمّ غُلّب على المعبود بالحقّ جلّ جلاله كتغليب النّجم على الثّريا مع إنه اسم لكلّ كوكب.
• علّة ثقل وكثرة الاستعمال: ذكر هاتين العلتين معًا وهو يبين سبب حذف الهمزة من أوّل الاسم في: بسم الله الرّحمن الرّحيم.
• علّة عوض: فقد علّل بها لحذف الواو من سمْو وتعويضها بالهمزة في أوله فصار اسمًا.
• علّة مناسبة: وهي من العلل المعنويّة التي أشار إليها وهو يبيّن سرّ تقديم الرّحمن على الرّحيم في البسملة.
6- وهناك أمور أخرى يجدها القارئ واضحة في أسلوبه والشّواهد عليها مبثوثة في هذا المصنّف من قبيل استشهاده بالشّعر العربيّ القديم لإقامة حجّة أو دحض رأي أو تثبيت قاعدة من القواعد جريًا على سنن المؤلفين، ثمّ كان يسجل اعتراضه على اللّغويّين الذين لا ينسجمون ومذهبه، وكذلك يرد على الفقهاء أو الكلاميّين وحتّى المفسرين كلّما تأتّى له ذلك، ثمّ إنّ المؤلّف كان كثير الأخذ ممّن سبقه, وقد تنوّعت المصادر في مصنّفه بين مصادر لغويّة أو تفسيريّة أو فقهيّة, واعتماده على الكشّاف للزّمخشريّ، وكان له القدح المعلّى فقد أكثر الأخذ منه مشيرًا إليه تارة ومغفلًا تارة أخرى.
وبعد فإنّ المؤلّف عاش متأخرًا، ولذا كان يغلب على أسلوبه السّجع والكلام المنمّق، وهو متأثر بمَن سبقه من العلماء.
وصف النّسخة الخطّيّة
المخطوطة عبارة عن رسالة صغيرة ضمت ستّ لوحات، تتألّف كلّ لوحة من خمسة وعشرين سطرًا، يعد خطها واضحًا بدرجة معتد بها, وقد اعتمدت في تحقيق هذه الرّسالة على نسخة خطّيّة وحيدة, احتفظت بها مكتبة مجلس الشّورى الإيرانيّ, برقم: 28639, وخطّها نسخ وهو جميل جدًا وواضح ومقروء, لم أقف على تاريخ نسخها ولا ناسخها.
والمخطوطة لا تخلو من بعض الرّموز, فكان يضع الرّمز(فح) وهو بمعنى فحينئذ، والرّمز(ظ) بمعنى الظاهر.
وذكر المصنّف مكان وزمان تحريرها والانتهاء منها في مقدّمة الرّسالة وخاتمتها.
[النّصّ المحقّق]
رِسَالَةٌ فِي البَسْمَلَةِ
[مقدمة المؤلف]:
أحمد ولي الحمد حمدًا متّصلًا، وأصلّي على مَن رمى السّبعَ مكملًا، وخُتِمَ به النّبيّون, فافتخرت به الأولون والآخرون، وقُرِنَ اسمه باسم الرّحمن, وكُتِبَ على أعلى أبواب الجنان، وعلى عثرته الأعلام، ومصابيح الظّلام.
وبعد:
فيقول الفقير إلى عفو ربّه والرّضا, المشتهر بالمُهذِّب( ) أحمد بن عبد الرّضا: هذا بعض الكلام على البسملة، وأسأل الله التّوفيق في البداية والتّكملة.
[بسم]:
بسم, الاسم: فيه مذهبان:
الأوّل: مذهب البصريّين, وهو عندهم أصله سِمْو بكسر الفاء كحِبْر أو بفتحها كعَدْل( ) أو بضمها كقُفْل. وعينه ساكنة على الأصل؛ لعدم [وجود] معارض يقتضي العدول عنه، ولا دليل على حركتها؛ لعدم جمعه على غير أفعال، ثمّ حُذفت الواو وسُكنت السّين لدخول الهمزة, فبقى حرفان ساكنان فكُرِهَ الاستعمال بهما، وإن حُرِكَا, إلّا ما قلّ كما سيجيء - إن شاء الله تعالى - . ثمّ أوتى بهمزة وصل مكسورة في الأوّل عوضًا عن اللّام، وإنما كانت الهمزة مكسورة؛ لأن الهمزة التي يؤتى [بها] فرارًا عن( ) الابتداء بالسّاكن لتعذره, لا تكون إلا مكسورة كهمزات المصادر وغيرها إلا همزة باب الأفعال والتّفضيل والتّعجب والجموع, فمفتوحة والتّابعة لضمّة عين الفعل فمضمومة. فأن قلتَ: لِمَ جعلت في الأول؟ قلتُ: لأنّ الهمزة إذا وقعت في الأولى وكان ما بعدها ثلاث حروف( ) حُكم بزيادتها وبأصالة الحروف, فحينئذ( ) يعرف اشتقاق الكلمة وأيضًا فيه تنبيه على أنّ المحذوف آخر الكلمة كابن وشبهه( ).
وجاء بِسم, بالكسر بدون الهمزة, وسَم بالفتح، وأُسم بضم الهمزة, كما في الأسرار( )، وسُم بالضّم، ومنه قول الشّاعر :
باسم الذي في كلّ سورة سُمُه( )
ويروي سِمُه بالكسر( ). وقول الآخر( ):
والله أسماك سُما مباركًا
آثرك الله به إيثارك
فعلى هذا يكون أحد الأسماء العشرة المحذوفة الإعجاز( ).
الثّاني: مذهب الكوفيّين, وهو عندهم أصله: وَسْم, بالفتح حذفت الواو وبقيت السّين ساكنة, فأوتي بالهمزة المكسورة لما مرّ في محلّها, فقيل: إِسْم فعلى هذا لا يكون أحد الأسماء المذكورة.
أمّا حجّة البصريّين, فإنّهم يقولون: إنّه مأخوذ من السّمو وهو: العلو والارتفاع؛ لأنّه على( ) على سماء, وعلى( ) على ما تحته من معناه، وأيضًا يقع خبرًا أو مخبرًا [عنه] بخلاف قسيميه, أعني: الفعل والحرف، فإنّهما ليسا بهذه المثابة؛ لأنّ الأوّل لا يقع إلّا ليخبر به, والحرف صلة، فلهذا ازداد شرفًا وسمى( ) عليهما.
وأمّا حجّة الكوفيّين, فإنّهم يقولون: إنّه مأخوذ من الوسم, وهو العلامة؛ لأنّ سِمة على مسماه ويعرف بها؛ وذلك لأنّ التّلفّظ بزيد مثلًا يدلّ على مدلوله, وهي الذّات المعلومة, وتعرف به, فكأنّه علامة عليها, وما ذهب إليه البصريّون هو المختار. وأمّا ما ذهب إليه الكوفيّون ففاسد من وجوه سنذكرها - إن شاء الله تعالى - وإن كان مختارًا بحسب المعنى.
ثمّ اعلم أوّلًا أنّ التّصغير والتّكسير يردان الأشياء إلى أصولها، ومن ثمّ قيل في (باب) عند التّصغير (بويب), وفي جمعه (أبواب).
ثمّ اعلم ثانيًا أنّ الصّرفيّين قالوا في تصغيره: سُمَيّ، وأصل اسم: سِمْو, ثمّ ضُمّ أوّله للتّصغير, وفتح ثانيه, وزيد ياء التّصغير السّاكنة الثّالثة, فصار سُميو، فاجتمعت الياء السّاكنة مع الواو المتحرّكة فقلبت الواو ياءً دون العكس, وإدغامها فيها كما في سيّد وميّت ومرمي, فقيل: سُمَيّ, ولم يرد: وُسيم تصغير اسم فهذا الوجه الأوّل.
الثّاني: قالوا في تكسيره أسماء, وأصله أسماو, وقعت الواو التي هي لام الفعل( ) متطرفة بعد الألف الزّايدة التي هي لبناء الجمع قلبت همزة كما في: كساء, ورداء, وسماء, فقيل: أسماء ولم يرد أوسام جمع اسم.
الثّالث: إنّ وجود الهمزة في الأوّل يُنبئ على أنّ المحذوف هي اللّام؛ وذلك لأنّها تعوّض عن اللّام غالبًا لا عن الفاء، ألا ترى ابنا أصله بَنْو كَحَبْل حذفت منه اللّام, وعوضت عنه الهمزة في الأوّل, وعِدَة أصله وعد حذفت منه الفاء ولَمْ تِعوض عنه الهمزة, ثمّ لمّا أدخلت عليه الباء الجارّة وكانت الهمزة فيه للوصل كما تقرّر غير مرة ومن حقّها أن تحذف حذفت وعملت الباء به الجرّ.
فإن قلتَ: لِمَا( ) عملت الباء ولِمَ كان عملها الجرّ دون غيره؟ قلتُ: لأنّ حروف الجرّ ملازمة الأسماء، وكلّ ما لازم شيئًا وهو خارج عنه في الحقيقة أثر فيه غالبًا( ).
وأمّا عملها الجرّ؛ لأنّ الرّفع أخذه الفعل للفاعليّة, والابتداء للمبتدأ, وغيره من عوامل الرّفع المعنوية( )، والنّصب أخذه للمفعوليّة، فبقى الجرّ فأخذته حروف الجرّ والمضاف على مذهب مَن جعله عاملًا( ).
فإن قلت لِمَ حُذفت الهمزة منه في الخطّ والقياس إثباتها فيه؛ لأنّها همزة وصل تحذف من اللّفظ لا غير ويشهد به قوله تعالى: ( ) ( ) ؟.
قُلت: حذفُها في الخطّ تبعًا لحذفها في التّلفّظ؛ وذلك لثقلها ولكثرة الاستعمال بالبسملة فناسب ذلك كما لا يخفى, بخلاف " اقرأ باسم ربك". وقيل: طولت الباء تعويضًا عن الهمزة( )، وبنيت على الكسر للزومها الحرفيّة والجرّ، وإن كان القياس فتحها تحقيقًا؛ لأنّ كلّ حرف جاء لمعنى وهو على حرف واحد من حقّه أن يكون مبنيًا على الفتح كما صرح به صاحبه الكشّاف( )، كلام الابتداء وواو العطف والقسم وغيرها, والفا لمعانيه بأسرها فلا يرد نحو كاف التّشبيه ومَن فافهم.
وهي متعلّقة بمحذوف تقديره: بسم الله أقرأ أو أبتديء أو أتلو( )؛ لأنّ ما يتّبع التّسمية مطلوب لابدّ منه كما أنّ الشّارع إذا أراد أن يشرع في عمل يقول: بسم الله, كان معناه: بسم الله أشرع أو أبتديء, إلى غير ذلك, كالذّابح إذا ذبح والمسافر إذا حلّ بمكان أو ارتحل منه قال بسم الله, كان المعنى أذبح أو أحلُّ أو ارتحل، ونظيره في حذف المتعلّق, قوله تعالى: ( ) ( ), أي اذهب، ومنه قول الشّاعر( ):
ضربتْ صدرها إليّ وقالتْ
يا عَدِيًّا لقد وقتكَ الأواقي
أي: أقبلت أو جاءت.
وقول الآخر( ):
فقلت إلى الطّعام فقال منهم
فريق يحسد الإنس الطّعاما
أي هلمّوا( ), ومنه قولهم: بالرّفاء والبنين, وباليمن والبركة, أي: أنكحتَ, أو تزوجتَ, أو أعرستَ إلى غير ذلك.
فإن قلت: لِمَ قُدِّر متأخّرًا عن المتعلّق؟ قلت: لمّا كان الأهمّ من المتعلِّق والمتعلَّق به هو الأوّل دون الثّاني, وكانوا يبتدئون بأسماء آلهتهم فيقولون: باسم اللّات وباسم العزّى, وجب تقديمه عليه لهذا وللاختصاص أيضًا, كما في قوله تعالى: ( )( ) بتقديمه على الفعل، ويشهد بذلك قوله تعالى: ( ) ( ).
اللهم إلّا إذا قُدّر مصدر كما هو رأي البصريّين, فحينئذ يقدّم لئلا يلزم تقديم معموله عليه وهو جائز، وأتى منه في قوله تعالى: ( )( ), ( )( )، فإن السّعي والرّأفة مصدران أُخرا عن معموليهما؛ وذلك لأنّ الظّرف ممّا يكفيه رائحة الفعل فلا وجه لرأيهم، وأيضًا يلزم على رأيهم أن يعمل محذوفًا, وأجيب عنه بما مرّ.
وأمّا قوله تعالى: " اقرأ باسم ربك" بتقديم الفعل, فإنّه لمّا كانت أوّل سورة نزلت فكان تقديمه أثبت وأوقع وأولى؛ لأنّه الأهم, وهو ظاهر( )، وقيل: إنّه متعلّق بـ( مفتتحًا), أي إقرأ مفتتحًا باسم ربّك, فحينئذ يجوز تأخيره, فيقال: إقرأ باسم ربّك مفتتحًا, هكذا نُقِلَ في حاشية الكشّاف( ).
فإن قلت: ما معنى الباء فيه وما معنى تعلّقها؟
قلت: معناها الاستعانة، وتعلّقها كتعلّق السّكين بالذّبح أو التّرك، فحينئذ يكون تعلّقها كتعلّق الدّهن بالإنبات, كما في قوله تعالى: ( )( ).
والله: اسم علم مفرد( ) موضوع للذّات الواجب المستجمع لجميع صفات الكمال دالّة عليه دلالة جامعة لمعاني الأسماء الحسنى ما ظهر منها وما لم يظهر، ولذلك يقال هذا الاسم من أسماء الله تعالى؛ لأنّه يقال الرّحمن والرّحيم والواحد والعظيم مِنْ أسمائه ولا يقال بالعكس.
وقيل: اسم لمفهوم ذات الواجب, فيكون كليًا انحصر في فرد, فلا يكون علمًا؛ لأنّ مفهومه جزئيّ. وفيه نظر، [فإنّنا] لا نسلم أنّ مفهومه كليًا( ) للاتفاق على أنّ قولنا: (لا إله إلا الله) كلمة توحيد، وإذا كان مفهومه كليًا والكلّيّ من حيث هو كلّيّ يصدق على كثيرين فكيف يستفاد والتّوحيد منه.
وأصله إله بالتّنكير ثمّ عُرّف بلام التّعريف فاستثقلت الهمزة, فحذفت وفخّم للتّعظيم, لما في التّفخيم منه، ثمّ لمّا وقعت بعد الميم المجرورة بالباء رقّقت وذلك لأنّ لفظ( ) الجلالة إذا تقدّمها حرف مضموم أو مفتوح أو ابتدئ بها فخّمت، وإذا تقدّمها حرف مكسور رقّقت كما بُين في موضعه.
وقيل: أصله الآله حذفت الهمزة, وعوّضت عنها لام التّعريف, فقيل: الله, ولذلك يقال يا ألله بالقطع، كما يقال يا اله، وهو مِنْ أسماء الأجناس كرجل، ويستعمل في كلّ معبود وسواء كان المعبود بحقّ أو لا، ثم غُلِّب على المعبود بالحق جلّ جلاله, كتغليب النّجم على الثّريا مع أنّه اسم لكلّ كوكب، والبيت على الكعبة، والمدينة على مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله، وهكذا. وهو اسم لا صفة، ألا ترى أنّه لا يقال شيء إله كما لا يقال شيء فرس بل يقال إله معبود كما يقال رجل محمود، والصّفات لا بدّ لها من موصوف فتأمل.
والله بالحذف لا يستعمل إلّا في المعبود بالحق( )، وقال أبو الهيثم الرّازي( ): أصله الإله ثم حذفت الهمزة المتوسّطة استثقالًا لها, فلمّا حذفوها نقلوا كسرتها إلى اللّام السّاكنة قبلها, فقالوا: اللّاه فحركوا لام التّعريف ومن حقّها السّكون فالتّقت لامان متحركان( ) وحقّ الأوّل( ) منهما السّكون فأسكنوها وأدغموها في الثّانية, فقال( ): الله، ونظيره قوله تعالى: (• )( )، كان في الأصل(لكن أنا) فحذفوا الهمزة وحولوا فتحتها إلى النّون قبلها, فصارت لكنّنا وهكذا حكى الفراء( ).
وأمّا ما قيل من أنّ اللّام عوّضت عن الهمزة بعد نقل حركتها إليها وحذفها ففيه نظر, للّزوم الدّور؛ وذلك لأنّ حذف الهمزة موقوف على نقل حركتها إلى اللّام ونقل حركتها موقوف على حذفها ليتأتّى تعويض اللّام عنها.
وأجيب بأن نقل الحركة موقوف على الحذف؛ لأنّ العوض لا يؤتى به إلّا بعد حذف المعوّض عنه، وعلى كلّ تقدير فهو مشتقّ من لاه اشتقاقًا جعليًا, فلا يلزم منه أن يكون صفة؛ لأنّ اعتبار ذلك لترجيح الاسم لا لصحّة الإطلاق كما ذكره السّكّاكي( ), ومعناه الخفاء، كما قال الشّاعر( ):
لاهت فليس ترى يومًا ببارزة
يا ليتها خرجت حتى عرفناها
وقيل: الظّهور, وهو مجرور بإضافة الاسم إليه، وهل العامل فيه المضاف أو اللّام المقدّرة؟ ففيه خلاف.
فذهب بعضهم إلى الأوّل لقولهم: كلّ اسم أضيف إلى اسم آخر هو العامل فيه وهو مذهب سيبويه، وآخرون إلى الثّاني وهو مذهب الزّجاج( ).
الرّحمن الرّحيم: صفتان لله بنيا للمبالغة من رَحِم بالكسر والرّحمة لغةً: الرّأفة والعطف والحنو. والرّحمن أكثر مبالغة لزيادة بنائه؛ وذلك لأنّ زيادة البناء تدل على زيادة المعنى كما في كسَر وكسّر( ) وهو خاص اللّفظ عامّ المعنى, والرّحيم بالعكس.
ولهذا لا يوصف به إلّا الله تعالى, وأما قول بني حنيفة في مسيلمة الكذاب رحمان اليمامة, فتعنّت منهم وكفر( ).
ولمّا كانت رحمته تعم المؤمن والكافر في الدّنيا وتخصّ المؤمن فقط في الآخرة, كما قيل رحمن الدّنيا ورحيم الآخرة، ورحمة الدّنيا مقدمة على رحمة الآخرة، قُدّم على الرّحيم للمناسبة( ).
فإن قلت: لِمَ قُدّم الأبلغ على ما هو دونه والقياس التّرقي من الأدنى إلى الأعلى، كما يقال عالم نحرير وفقيه طَبِن وحكيم نطاسي وفيلسوف نقريس وكاتب حاذق وصانع ماهر؟( ).
قُلت: الرّحمن متناول لأصول النّعم وعظامها وجلالها، والرّحيم كالتّكملة فهو متناول ما دقّ منها وعذُب ولطُف ولذلك أُردف.
والرّحمن مجرور على الوصفيّة لما تقرّر في موضعه من أن الصّفة تتبع الموصوف في أربعة من عشرة، والعامل فيه هو العامل بمتبوعه أو بنفس التّبعيّة والأصحّ الأوّل( )، والرّحيم كذلك.
وقيل: الرّحمن بدل لا نعت( )، والرّحيم بعده نعت له كما في المغني( ) فيكون العامل فيه محذوفًا مماثلةً للعامل في المتبوع لما تقرّر من أنّ البدل على نية تكرير العامل.
فعلى الأوّل يكون صفة، وهو ما ذهب إليه الزّمخشريّ( ) وابن الحاجب( )، وعلى الثّاني علمًا وهو ما ذهب إليه الأعلم( ) وابن مالك( ).
فإن قلت: هل هو منصرف أم لا؟ قلت: بل غير منصرف.
فإن قلت: شرط منع صرف فعلان الصّفة وجود فعلى وهو باطل.
قلت: كما أن وجود فعلى باطل فكذلك وجود فعلانة، وأيضًا المراد من وجود فعلى انتفاء فعلان وهو حاصل، فحينئذ لا عبرة بامتناع التّأنيث لاختصاص العارض, فالأولى أن يرجع إلى الأصل وهو القياس على نظائره، وهذا ما ذهب إليه الزمخشري( )، وقيل: إنّه منصرف( ) وهو الأشهر فتأمل.
وهما صفتان مشتقتان من فعل متعدٍّ, ولكنّه يؤول باللّازم كما في قتيل وجريح, فأنّهما مشتقان من جرحته وقتلته فهو جريح وقتيل.
ويجوز فيهما النّصب بتقدير فعل، والرّفع بتقدير مبتدأ, والجرّ هو الأصل لما تقرر، ونصب الأول ورفع الثّاني بما مرّ والعكس.
ثمّ البسملة ليست بآية من كل سورة عند قُراء المدينة والبصرة والشّام، وإنّما كتبت للفضل والتّبرك بالابتداء بها كما بُدِئ بها في كلّ أمر ذي بال، ولذلك لم يجهروا بها في الصّلاة.
وآية عند قراء مكّة والكوفة لذلك يجهرون بها وهو الأصحّ( )، رُوي عن ابن عباس( ): "مَنْ تركها فقد ترك مائة وأربع عشرة آية مِنْ كتاب الله تعالى".
ثمّ إذا تُليت فلا بدّ من اتّصال الميم باللّام من الجلالة مع حذف الهمزة بالتّلفّظ وترقيق لامها كما مرّ، واتّصال هائها بالرّاء ونون الرّحمن براء الرّحيم مع حذف الهمزتين وتفخيم الرّاء منهما؛ لعدم مقتضى التّرقيق، وإدغام اللّام منهما فيهما؛ لأنّها من الحروف الشّمسيّة، وهي ثلاثة عشر حرفًا الدّال والطّاء والثّاء والنّون( ).
فإن قلت: لِمَ أُبتديء بها في أوّل الكتب؟ قلت لوجوه:
- الأوّل: لمّا كان الله تعالى أوّل الموجودات ناسب اسمه أن يكون أوّل المكتوبات.
- الثّاني: عملًا بقوله صلى الله عليه وآله: "كلّ أمر ذي بال لم يبدأ باسم الله فهو أبتر"( ).
- الثّالث: اقتداءً بالكتاب العزيز.
- الرّابع: اقتداءً بذوي التّصنيف.
- الخامس: تبركًا باسمه عزّ وجلّ.
فإن قلت: ما وجه تسميتها بالبسملة؟
قلت: وجه تسميتها بها دلالة عليها, وهو من قبيل إيداع اللّفظ دلالة على المعنى، وهي علم لقولنا: بسم الله الرّحمن الرّحيم, كالتّهليل والحوقلة والتّرجيع والحيعلة, فإنّها أعلام لمعانيها، ونظيره دلالة التّسمية على المسمّى, كالجيم فإنّه اسم لجه, وذلك بأنّهم أخذوا المسمّى وجعلوه صدر كلمة اسم من الحروف الهجائيّة قصدًا للدّلالة الواضحة.
فإن قلت: هل هي مباحة الاستعمال في جميع الأوقات على السّويّة أم لا؟
قلت: لا بل تستعمل وجوبًا وذلك في مثل الصّلاة الواجبة، ومباحًا عند الشّروع في الأمور والفراغ منها، كالأكل والشّرب.
وعن ابن مسعود عن النّبيّ صلّى الله عليه وآله أنه قال: "من أراد أن ينجيه الله من الزّبانية التّسعة عشر, فليقل: بسم الله الرّحمن الرّحيم, فأنّها تسعة عشر حرفًا, فيجعل الله كلّ حرف منها جُنّةً مِنْ واحدٍ مِنْهم"( ).
وتكره إذا استعملها الجنب, وقرأ أكثر من سبع آيات وقيل سبعين.
ويحرم استعمالها مع العزايم الأربع.
وأمّا شيء من فضائلها ما روي عن ابن عبّاس عن النّبيّ صلى الله عليه وآله, قال: "إذا قال المعلّم للصّبيّ قل بسم الله الرّحمن الرّحيم, فقال الصّبي بسم الله الرّحمن الرّحيم كتب الله براءة للصّبي وبراءة لأبويه وبراءة للمعلّم"( )، وروي عن علي بن موسى الرّضا (عليه السّلام) أنّه قال: " إن بسم الله الرّحمن الرّحيم أقرب إلى اسم الله الأعظم من سواد العين إلى بياضها"( ).
وروي عن الصّادق (عليه السّلام) [أنّه قال] : "ما لهم قاتلهم الله عمدوا إلى أعظم آية في كتاب الله فزعموا أنها بدعة إذا أظهروها"( ).
اتّفق الفراغ من تسويدها في المشّهد الرّضويّ, يوم الاثنين, من عاشر العشر الأوّل, من الشّهر الثّالث, من السّنة الثّالثة, من العشر الثّامن, بعد مضي الحاصل من تضعيف النّون, وضرب الحاصل منه في باء زمن الهجرة النّبويّة, على مهاجرها أفضل الصّلاة وأتّم التّحيّة.
قائمة المصادر والمراجع:
- إئتلاف النّصرة في اختلاف نحاة الكوفة والبصرة: للزبيديّ، تحقيق: د. طارق الجنابي، الطبعة الأولى، عالم الكتب، بيروت - لبنان, 1987م .
- أحكام القرآن: لأبي بكر بن العربيّ المالكيّ, تحقيق: محمّد عبد القادر عطا, الطّبعة الثّالثة, دار الكتب العلميّة, بيروت - لبنان, 2003م.
- أساس البلاغة: لجار الله الزّمخشريّ، تحقيق: محمد باسل عيون السّود، الطّبعة الأولى، دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، 1998م.
- أسرار العربية: لأبي البركات الأنباريّ، عنى بتحقيقه: محمد بهجة البيطار، مطبعة الشرقي, دمشق - سورية، 1957م.
- أسلوب القنفلة عند الزّمخشري في تفسيره وبيان خصائصه: د. عبد العزيز جودي، بحث، مركز تفسير للدّراسات القرآنية .
- الإشارات إلى أسرار البسملة: الشّيخ شمس الدّين الواعظيّ, مطبعة ثامن الحجج, 1424هـ.
- -إعراب القرآن: للباقوليّ, تحقيق: إبراهيم الإبياري، الطّبعة الرّابعة، دار الكتاب المصري، ودار الكتب اللّبنانية، بيروت والقاهرة، 1420هـ .
- أعيان الشّيعة: لمحسن الأمين، تحقيق: حسن الأمين، دار التّعارف للمطبوعات، بيروت - لبنان، 1983م.
- إنباه الرّواة على أنباه النّحاة: لجمال الدّين القفطيّ، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، الطّبعة الأولى، دار الفكر العربي، القاهرة، مؤسسة الكتب الثّقافية، بيروت، 1982م.
- الإنصاف في مسائل الخلاف: لأبي البركات الأنباريّ: تحقيق: محمّد محي الدّين عبد الحميد، المكتبة العصرية، صيدا - بيروت، 1987م.
- بحار الأنوار: للعلّامة المجلسيّ, تحقيق: محمّد مهدي الخرسان وإبراهيم الميانجي ومحمّد الباقر البهبوديّ, الطّبعة الثّانية, 1983م.
- البحر المحيط: لأبي حيان الأندلسيّ، تحقيق: صدقي محمد جميل، دار الفكر، 2010م.
- بحوث ودراسات في اللّغة والنّحو: د. حميد الفتليّ, مركز الكتاب الأكاديميّ, عمّان - الأردن, 2020م.
- البرهان في تفسير القرآن: للسّيّد هاشم البحرانيّ, مؤسّسة الأعلميّ, بيروت - لبنان, 2006م.
- تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام: لشمس الدّين الذّهبيّ، المكتبة التوقيفية، القاهرة - مصر.
- التّبيان في إعراب القرآن: لأبي البقاء العكبريّ, تحقيق: عليّ محمّد البجاويّ, عيسى البابي الحلبيّ وشركاه.
- التّحرير والتّنوير: لمحمّد الطّاهر بن عاشور, الدّار التّونسيّة للنّشر, تونس, 1973م.
- التّفسير الصّافي: للفيض الكاشانيّ, الطّبعة الثّانية, 1416هـ.
- التّقفية في اللّغة: لأبي بشر البندنيجيّ, تحقيق: الدّكتور خليل إبراهيم العطيّة, وزارة الأوقاف العراقيّة, بغداد - العراق, 1979م.
- التّلخيص في معرفة أسماء الأشياء: لأبي هلال العسكريّ, تحقيق: عزّة حسن, الطّبعة الثّانية, دار طلاس, دمشق - سورية, 1996م.
- جامع أحاديث الشّيعة: للسّيّد البروجرديّ, قم - إيران, 1409هـ.
- الجامع لأحكام القرآن: للإمام القرطبيّ, تحقيق: أحمد البردونيّ وإبراهيم أطفيش, الطّبعة الثّانية, دار الكتب المصرية, القاهرة - مصر, 1964م.
- جمال القرّاء وكمال الإقراء: لعليّ بن محمّد السّخاويّ, تحقيق: عبد الحقّ عبد الدّايم سيف القاضي, الطّبعة الأولى, مؤسّسة الكتب الثّقافيّة, بيروت - لبنان, 1999م.
- حاشية التفتازاني على الكشاف للزّمخشريّ: تحقيق عبد الفتاح عيسى البربري، رسالة دكتوراه، جامعة الأزهر، 1978م.
- حاشية الصّبّان على شرح الأشمونيّ لألفيّة ابن مالك: لأبي العرفان الصّبّان, الطّبعة الأولى, دار الكتب العلميّة, بيروت - لبنان, 1997م.
- الدّر المنثور في التّفسير بالمأثور: لجلال الدّين السّيوطيّ, دار الفكر, بيروت - لبنان, 2011م.
- الذّريعة إلى تصانيف الشّيعة: أغا برزاك الطّهرانيّ، الطّبعة الثّالثة، دار الأضواء، 1983م.
- الزّاهر في معاني كلمات النّاس: لأبي بكر ابن الأنباريّ, تحقيق: حاتم الضّامن، الطّبعة الأولى، مؤسسة الرّسالة، بيروت، لبنان، 1992م .
- شرح أبيات سيبويه: لأبي سعيد السّيرافيّ، تحقيق: د. محمّد عليّ الرّبع هاشم، دار الفكر والنّشر والتّوزيع، القاهرة - مصر، 1974م.
- شرح الأزهريّة: خالد الأزهريّ, طبعة بولاق, القاهرة - مصر.
- شرح أصول الكافيّ: لمحمّد صالح المازندرانيّ, مؤسّسة البلاغ المبين.
- شرح ألفيّة ابن مالك: لأبي عبد الله الحازميّ, المكتبة الشّاملة.
- شرح التّصريح على التّوضيح, أو التّصريح بمضمون التّوضيح في النّحو: الشّيخ خالد الأزهريّ, الطّبعة الأولى, دار الكتب العلميّة, بيروت - لبنان, 2000م.
- شرح كتاب سيبويه: لأبي سعيد السّيرافيّ، تحقيق: أحمد حسن مهدلي، الطّبعة الأولى، دار الكتب العلميّة، بيروت - لبنان، 2008م.
- شرح ملّا جامي على متن الكافية في النّحو: تحقيق: عليّ محمّد مصطفى وأحمد عزّو عناية, دار إحياء التّراث العربيّ, بيروت - لبنان.
- الصّحاح, تاج اللّغة وصحاح العربيّة: لأبي نصر الجوهريّ, تحقيق: أحمد عبد الغفور عطّار, الطّبعة الرّابعة, دار العلم للملايين, بيروت - لبنان, 1987م.
- العين: للخليل بن أحمد الفراهيديّ، تحقيق: د. مهدي المخزوميّ، د. إبراهيم السّامرائيّ، دار الهلال، القاهرة، مصر.
- الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل: لجار الله الزّمخشريّ، الطّبعة الثّالثة، دار الكتاب العربي، بيروت - لبنان، 1407هـ.
- الكشف والبيان عن تفسير القرآن: لأبي إسحاق الثعلبيّ، تحقيق: الإمام الطّاهر بن عاشور، الطّبعة الأولى، دار إحياء التراث العربي، بيروت - لبنان، 2002م.
- لآلئ الأخبار: للشّيخ محمّد نبي التّويسكاري, المكتبة المحمّديّة, قم - إيران.
- لسان العرب: لابن منظور الأفريقيّ، الطّبعة الثّالثة، دار صادر، بيروت - لبنان، 1414هـ.
- مجمع البيان في تفسير القرآن: لأبي عليّ الفضل بن الحسن الطّبرسيّ, دار المرتضى, بيروت - لبنان, 2006م.
- المجيد في إعراب القرآن المجيد: لإبراهيم السّفاقسيّ, تحقيق: حاتم الضّامن, الطّبعة الأولى, دار ابن الجوزيّ, 1430هـ.
- مرآة الكتب: للميرزا عليّ بن موسى التّبريزيّ، تحقيق: محمد عليّ الحائريّ، الطّبعة الأولى، منشورات مكتبة آية الله العظمى المرعشيّ النّجفيّ، 1414هـ.
- مستدرك أعيان الشّيعة: لحسن أمين، الطّبعة الأولى، دار التّعارف للمطبوعات، لبنان - بيروت، 1987م.
- معاني القرآن: لأبي زكريا الفرّاء، تحقيق: أحمد يوسف النّجاتي ومحمّد عليّ النّجّار وعبد الفتّاح إسماعيل الشّلبي، الطّبعة الأولى، دار المصريّة للتّأليف والتّرجمة، القاهرة - مصر.
- معجم المؤلفين: لعمر رضا كحالة، مؤسّسة الرّسالة، الطّبعة الأولى، بيروت - لبنان، 1993م.
- المعجم المفصّل في شواهد العربيّة: د.إميل بديع يعقوب، الطّبعة الأولى، دار الكتب العلميّة، بيروت - لبنان، 1996م.
- مغني اللّبيب عن كتب الأعاريب: لابن هشام الأنصاريّ, تحقيق: محمّد محي الدّين عبد الحميد, القاهرة - مصر.
- مفتاح العلوم: لأبي يعقوب السّكاكيّ، تحقيق: نعيم زرزور، الطّبعة الثّانية، دار الكتب العلميّة، بيروت - لبنان، 1987م.
- موسوعة طبقات الفقهاء: للشّيخ جعفر السّبحانيّ، الطّبعة الأولى، 1418هـ.
- نتائج الفكر في النّحو: لأبي القاسم السّهيليّ, الطّبعة الأولى, دار الكتب العلميّة, بيروت - لبنان, 1992م.
- نزهة الألباء في طبقات الأدباء: لأبي البركات الأنباريّ، تحقيق: إبراهيم السامرائيّ، الطّبعة الثّالثة، مكتبة المنار، الزرقاء - الأردن، 1987م.
- نواهد الإبكار وشواهد الأفكار: لإسراء كريم عبد الله, المكتبة الشّاملة.