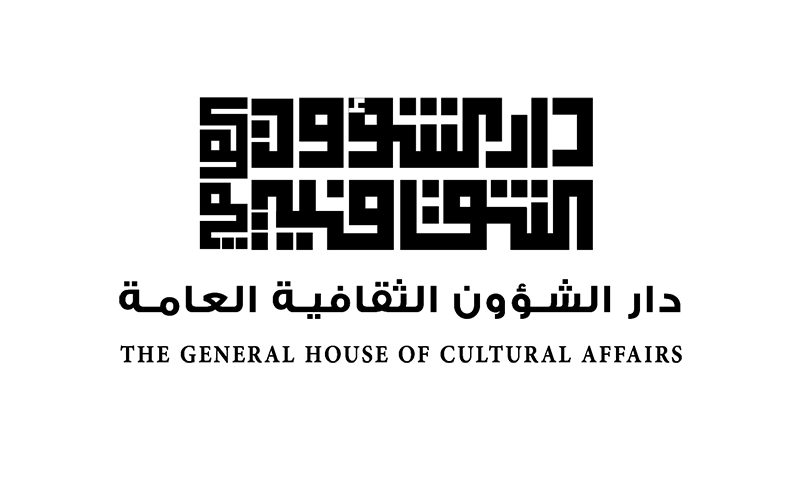دراسات وبحوث
تشظيات الخطاب السرديّ في الحكاية الخرافية (كليلة ودمنة) مثالاً
تشظيات الخطاب السرديّ في الحكاية الخرافية (كليلة ودمنة) مثالاً
م.د.ميساء سليمان محمود الإبراهيم
سوريا /جامعة البعث/كلية الآداب والعلوم الإنسانية/
قسم اللغة العربية
الملخص:
تنتظم الحكايات في " كليلة ودمنة" في إطار تسلسلي تتشكّل بموجبه كلّ حكاية على شكل حلقة تتعالق برباط زمني ومنطقي مع الحكاية الإطار وبقية الحكايات السابقة واللاحقة، لذلك فإنَّ العمل الحكائي يمثّل فكرةً تقوم على ربط الحكايات من خلال ربط الثيمات التي تنطوي عليها الحكايات للوصول إلى ربط الأفكار التي تقوم عليها الحكايات، ويرتبط معنى الثيمة في الكتابة السردية بمقاصد الكاتب؛ وبذلك تتجاوز الثيمة حدود فكرة النص الأدبي إلى فعل التأويل ليغدو ذلك الغرض العام المهيمن على النصّ.
وبهذا تمركزت الدراسة في بيان التمثيلات الذهنية اللاوعية التي تحكم المجتمع والأفراد، وفهم الإشارات والعلامات التي تحملها النصوص، وإدراك نظام دلالاتها، ودراسةِ قوانين الأنماط الأولية والرموز في ضوء مقولات محددة، كمقولات نوروثروب فراي التي تنظر إلى الأدب بوصفه نظاماً من العلاقات اللغوية التي تصور الحياة والواقع رمزياً، وتحدد القوانين العامة التي تعمل البنى من خلالها في إطار تأويلي.
المحور الأول: الحكاية بوصفها خطاباً سردياً
يعد إيخنباوم أول من طرح مشكلة الحكاية ، فقد نظر إليها على أنها كيان يستند بصورة تامة إلى الشكل الشفاهي الخاص بالسرد ، وقد رأى جيرار جينيت أن الحكاية (خطاب سردي)، ويمكن عدُّ الحكاية عصب السرد فهي ثابتة وأساسية وعليها مدار السرد، وبانتفائها ينتفي السرد . فالسرد قائم على حكاية خيالية أو واقعية، أُعيد إنتاجها بطابع خيالي أو واقعي في نموذج لفظي يندرج تحت أنواع أدبية، ويُفترض في التاريخ والسيرة والسير ذاتية أن يعيد خطابات ملقاة فعلاً، ويُفترض في الملحمة والرواية والخرافة والأقصوصة أن تتظاهر بإعادة إنتاج خطابات مختلقة . ويتحدث جينيت عن دلالة كلمة حكاية ويصنّفها في ثلاثة اتجاهات بحسب استخداماتها على النحو الآتي: أولها: الخطاب الشفوي أو المكتوب الذي يضطلع برواية حدثٍ أو سلسلة من الأحداث. والثاني: أقل انتشاراً يشير إلى سلسلة الأحداث الحقيقية أو التخييلية، بغض النظر عن الوسيط اللساني. والثالث: يدل على حدثٍ إلا أنه ليس حدثاً يُروى، بل هو الحدث الذي يقوم على أن شخصاً ما يروي شيئاً، إنه فعل السرد متناولاً بوصفه غايةً ، فالحكاية بمفهومها الأخير تدل على الخطاب المنطوق به من الجهة التركيبية والدلالية، فهي تطلعنا على الأحداث التي ترويها من خلال السرد الذي أنتجها ، وهي معرفة لا يمكن أن تكون معرفة غير مباشرة من خلال وسيط، هو الخطاب الذي يحمل علاماتٍ أو قرائن تدل على أسبقية العمل المروي على العمل السردي ، مما يجعل الحكاية لاحقة بالسرد ، فالحكاية في تحققها الأول الشفهي أو حتى المكتوب تنتظم لتشكيل الأحداث . ويشير (تودوروف) إلى أن الحكاية بنية مجردة مطلقة، مكونة من مجموعة من الأفعال القابلة للسرد من قبل مجموعة مختلفة ومتعددة من الرواة ، ومن ثم فهي غير ثابتة المعالم من حيث الأداء، إذ إن كل راوٍ يقدمها بحسب رؤيته الخاصة ، ويتساءل رولان بارت عن وجود بنية الحكاية، وينتهي إلى أنها موجودة في المحكيات، ولكن ليس في كل المحكيات، فكثير من الشارحين الذين يوافقون على فكرة البنية السردية،لا يستطيعون التسليم بإبعاد التحليل الأدبي عن أنواع العلوم التجريبية، إنهم يطالبون بأن يطبق على السرد منهج استقرائي خالص، وأن يبدأ بدراسة المحكيات في كل عصر ومجتمع من أجل الانتقال بعد ذلك إلى تقديم نموذج عام . ومن المفيد التمييز بين القصة والحكاية لأسباب تتعلق بالخلط بين المفهومين، فالحكاية عند جنيت فعل لغوي، وهي ككل فعل لفظي تخبر وترسل دلالات، وهي لا تمثل قصة حقيقية أو خيالية، وإنما ترويها أي تدل عليها بوساطة اللغة( )، والقصة والسرد لا يوجدان إلا بوساطة الحكاية، والعكس صحيح, فالحكاية أي الخطاب السردي لا يمكنها أن تكون حكاية لأنها تروي قصة وإلا لما كانت سردية( )، فالقصة استعمال تقني، وقد اقترح تودروف التمييز بين الحكاية بصفتها خطاباً، والحكاية بصفتها قصة( )، فالنص السردي في نظره يتمييز بهذين المستويين اللذين يمكن التعامل مع مكوناتهما بطريقة تتيح الكشف عن البنية السردية. فالقصة تمثل جانباً حكائياً من خلال الأحداث المتعاقبة التي قد تتشابه مع الحياة الواقعية كما إنها تمثل جانباً خطابياً من خلال طريقة انتقالها( ) وتحليل الحكاية يعني دراسة مجموعة من الأعمال والأوضاع المتناولة في حد ذاتها( )، أما المستوى السردي فهو مشغول بعلامات سردية، وهي مجموعة العوامل التي تعيد دمج الوظائف والأفعال في الاتصال السردي المرتكز على مانحه ومتلقيه، وهذا المستوى دقيق وقواعده ملزمة، إلى حد من الصعوبة تصور حكاية خالية من علامات مقننة للسردية( )، والحكاية تتخذ ثلاثة أشكال: شكل سردي صرف ،وشكل محكي عن طريق وجوه الحوار بين الشخصيات، ومختلط من الحكاية والحوار( )، واستخدم جيرار جينيت هذا المفهوم ، ضمن النموذج التحليلي الذي قدمه واستوعب فيه المقولات السابقة عليه، وقدم تحديداً دقيقاً لأسس السرد الفني من خلال دراسته لكلمة قصة في اللغات الأوربية مستخلصاً ثلاثة معانٍ أوضحها وأقدمها هو الملفوظ السردي مكتوباً أو شفهياً، والثاني هو المضمون السردي، والمعنى الثالث هو الحدث.
يُعرَف المروي بأنه كل ما يصدر عن الراوي، وينتظم لتشكيل مجموعة من الأحداث تقترن بأشخاص، يحكمها فضاء من الزمان والمكان، وتعد (الحكاية) جوهر المروي، والمركز الذي تتفاعل عناصر المروي حوله، بوصفها مكونات له ، وتتحكم في أنساقه بنيتان هما: موقف الراوي وموقف المجتمع .
ويكمن الفرق بين (الحكاية) و(القصّة) في أن للحكاية والقصّة المادّة الأولية نفسها بعد تصنيفها وإضفاء الفنّية عليها، فالأولى شبيهة بالواقع، والثانية فنية( ). فالحكاية إنتاج لغوي يضطلع برواية حدث أو أحداث عدّة( )، تتمثل وظيفتها في قص قصّة( )، فالحكاية نقلت غير اللفظي إلى اللفظي( ). من هنا تبدو أهمية التمييز بين بناء الحكاية وبناء القصة. واصطلح الشكلانيون الروس على هذا المستوى بـ " المبنى ". والثاني " الاحتمال " المنطقي لنظام الأحداث واصطلحوا عليه " المتن " فالمبنى يحيل على الانتظام الخطابي للأحداث في سياق البنية السردية، أما المتن فيحيل على المادة الخام التي تشكل جوهر الأحداث في سياقها التاريخي . يقول توماشفسكي: " إننا نسمي متناً حكائياً مجموع الأحداث المتصلة فيما بينها والتي يقع إخبارنا بها خلال العمل ، وفي مقابل المتن الحكائي يوجد المبنى الحكائي الذي يتألف من الأحداث نفسها، بيد أنه يراعي نظام ظهورها في العمل كما يراعي ما يتبعها من المعلومات ".
وثمة علاقة بين الحكاية واللغة, فالحكاية هي" التي تطلعنا على الأحداث التي ترويها ومن جهة أخرى على النشاط الذي يفترض أنه أنتجها. وبعبارة أخرى : إن معرفتنا بهذا النشاط وبتلك الأحداث لا يمكن إلا أن تكون معرفة غير مباشرة، يتوسط لها حتماً خطاب الحكاية، وبما أن الأحداث هي بالضبط مدار ذلك الخطاب، وبما أن نشاط التحرير يخلف فيه علامات أو قرائن يمكن كشفها وتأويلها، مثل حضور ضمير متكلم يدل على تطابق الشخصية مع السارد أو حضور فعل ماض يدل على أسبقية العمل المروي على العمل السردي، هذا فضلاً عن إشارات أكثر مباشرة وصراحة ، فخطاب الحكاية هنا يحمل وجهين الأول شفاهي أداته اللغة المنطوقة، والثاني تحريري أداته اللغة المكتوبة، ( فالحكاية خليط منظم من هذه المواد كلها) ، نستطيع أن نتلمس آثار الشفاهية من خلال علاقات الخطاب بعناصر السرد أي الراوي والمروي له والمروي، بينما نستطيع من خلال دراسة اللغة بوصفها إحدى أنظمة العلامة التي تعيد إنتاج الدلالات تمهيداً للكشف عن الأنظمة الاجتماعية والثقافية التي ترتبط بها.
أما السرد في مجال التعبير الأدبي، كما أشار إليه (جينيت)، عرض " لحدث أو لمتوالية من الأحداث حقيقية أو خيالية، عرض بوساطة اللغة، وبصفة خاصة بوساطة لغة مكتوبة( )"، ويسعى علم السرد إلى البحث عن "مكونات البنية السردية للخطاب من راو ومروي ومروي له، ولما كانت بنية الخطاب السردي نسيجاً قوامه تفاعل تلك المكونات أمكن التأكيد أن السردية هي العلم الذي يعنى بمظاهر الخطاب السردي أسلوباً وبناء ودلالة"( )، ويعد السرد فرعاً من فروع الشعرية المعنية باستنباط القوانين الداخلية للأجناس الأدبية، والنظم التي تحكمها والقواعد التي توجه أبنيتها ، وتحدد خصائصها وسماتها( )، إن مفهوم السرد يعني إعادة تشكيل الواقعة سواء كانت حقيقية أم متخيلة من خلال مكونات اللغة المنطوقة أو المقروءة أو المكتوبة، في عملية صياغة وعرض وإعادة إنتاج، وفق نظام يحدده السارد مشكلاً الحبكة التي تمتلك نظامها الخاص في إظهار الحدث، وكيفية بنائه، وتشكيل موادِّه الأولية ضمن نظام زمني جديد، وتضمين النص الرؤى والمضامين والدلالات والغايات باستخدام سلسلة من التقنيات القادرة على توزيع الوظائف، بما ينسجم مع كل مستوى يقوم عليه النص( ).
فالسرد فعل تواصلي، تداولي مؤثر، يندرج في نسق ثقافي يتحكم فيه بصورة تامة، أشكالاً ومضامين، من خلال منظومة من القواعد والمقاييس الاجتماعية والفنية. ويتحقق تأثير هذا الفعل من خلال ممارسة فاعليه أي طرفي العملية السردية السارد والمسرود له إرسالاً وتلقياً، لذا فإن كل ملفوظ سردي -بوصفه فعلاً كلامياً- منتج ضمن سياق ثقافي محدد،ومن ثمة فإن معناه هو إسهامه في المحافظة على ما يسميه الدارسون "أنماط الوجود" في المجتمع الذي يعيش فيه المتحدث بكل أشكالها سواء ما يتعلق منها بالأفراد أم بأنظمة حياتهم وممارساتهم .
وتقوم عملية السرد على وجود متكلم ومستمع، أو راوٍ ومتلق، وتتميز هذه العملية بنوع من التعقيد يأتي من تعدد مستويات التوصيل" فإننا نجد في المرتبة الأولى العلاقة التي تربط بين الكاتب والقارئ، وهذان الطرفان يرتبطان بواقع مادي تاريخي يخرج عن نطاق عالم القص التخييلي، والكاتب حين يقص لا يتكلم بصوته، ولكنه يفوِّض راوياً تخييلياً يأخذ على عاتقه عملية القص ويتوجه إلى مستمع تخييلي أيضاً يقابله في هذا العالم( ).
وهناك ثلاثة أنماط من السرد من جهة ارتباطه بالواقع: النمط الواقعي: وهو السرد الذي يقدم ما وقع حقيقةً، فهو يرتبط بالخبر التاريخي، إذ يقوم السارد بنقله إلى المتلقي، فيتم تسجيل الأحداث، ونجد هذا النمط من السرد في المؤلفات التاريخية، والنمط التخييلي: ويرتبط بالواقع من جهة الإمكان، ويفارقه من جهة المحاكاة، مما يجعله سرداً قابلاً للتداول في أزمنة متباينة وأمكنة مختلفة عما حصل في الواقع، وأما النمط التخيلي: فهو منفصل عن الواقعي من جهة حدوث الفعل، ومن جهة إمكانية الحدوث، بناء على العلاقة القائمة بين الشخصيات، أي هي علاقة من صنع الخيال، وليس لها مرجعية واقعية ( ).
وتندرج حكايات "كليلة ودمنة" تحت النمطين التخييلي من جهة الحدوث، والمفارق من جهة المحاكاة، والتخيلي الخرافي المفارق للممكن بناء على طبيعة العلاقات القائمة بين الشخصيات، فشخوصها من حيث الجنس، يشترك فيه الحيوان الإنسان( ).
إن الاختلاف بين ما هو واقعي في الحكايات وما هو خرافي يكمن في أن الحكايات لا تتطابق في مجرياتها مع الواقع، لكن رموزها تمتلك التفسير المعقول واقعياً، إذ من الممكن قبوله بعد تأويله وفك رموزه، أما ماهو خرافي فيها، فهو إمكانية حدوثها في عالم الواقع، لا سيما أنها قائمة على الخيال، وهذا الاختلاف يُحدد من خلال التلقي و"بحسب درجة تماهي القارئ مع هذه الشخصية أو تلك، على أن كلام الحيوان يبقى في اعتبار القارئ ضرباً من المجاز. وهذا من أهم بواعث التشويق إلى قراءة الحكايات، وخاصة ما يجتمع فيها الإنسان والحيوان في مغامرات مشتركة، فالقارئ يميل كثيراً إلى إدراك اللحظة التي يجازى فيها بطل الحكاية، وتعاقب فيها الشخصية الشريرة، ويرغب كثيراً وإن في مجال الخيال أو الحلم أو العجيب في الوقوف عند لحظة العدل والإنصاف، فترتاح النفس وتطمئن وتشعر بأن هناك ما يشجع على التقدم في الحياة بنوع من الثبات والأمان( ).
فالراوي والمروي له طرفا العملية السردية يحددان طبيعة المروي ونمط السرد الذي يدخل في علاقة وظيفية أيضاً مع الغايات والمقاصد التي يرمي إليها النص، "ومن ثم فالنص السردي ذو أفقين: أفق التجربة المتجه نحو الماضي، مستعيداً للأحداث وفق خطاب سردي معين، وأفق مستقبلي تتحكم به الوظائف المختلفة التي تعقب عمليات التمثل واستخلاص المغزى والتأويل، وما يتبعه من عمل وفق المقاصد المتوخاة من طرفي العملية السردية...إذن يمكن القول: " إن السرد خلخلة واضحة للزمن، تتمثل هذه الخلخلة في الانزياح الزمني المؤقت للسارد، مهما كانت علاقته بالأحداث المروية والمسرود له معاً من الحاضر إلى الماضي ومنه إلى المستقبل، في محاولة انفلات من الزمن، وهروب من أسر اللحظة حنيناً إلى ماض أو توقاً إلى مستقبل أفضل"( ). إن مقاربة هذه المفاهيم يجعلنا ندرج كتاب " كليلة ودمنة" في نسق الحكاية التي تطلق على المفهوم السردي أي على المدلول، إذ دَلَّت على تمثيل الأصوات والحركات، المروية على لسان راوٍ أسهم في نقل الأحداث في إطار زماني ومكاني. وفي نسق القصة من جهة التقنيات الفنية التي تطلق على النص السردي، أنتجتها عملية القص بناء على سرد مجموعة المواقف المتخيلة للنص السردي، إن تحليل مكونات هذا النص السردي، وفحص العلاقة بين القصة من حيث هي شكل لساني يستخدم اللغة في عملية الإيصال ، وبين الحكاية من حيث هي محتوى يرتبط بالدلالات التي تنتجها اللغة، هو الذي يحدد الطريقة التي تقدم بها القصة المحكية، من خلال مجموع ما يختاره الراوي من وسائل وحيل لكي تقدم هذه القصة للمروي له.
ويعد كتاب "كليلة ودمنة" حكاية خرافية، إذ إن معظم الأحداث تقوم بها شخصيات رمزية تنتمي إلى عالم الحيوان،ويتماهى الحيوانُ مع الإنسانِ بفضلِ المشتركِ الأخلاقيّ الذي أسّسَهُ الخيالُ، وجاءت صورة التماهي على هيئة حكايات على لسان الحيوان، وتسمّى الحكايةعلى لسان الحيوان بـ(الأمثولة)( ). وهي حكاية ممتدة في الزمن تظهر كلما استدعت الحاجة إلى الوعظ والتخفي وراء أقنعة رمزية، فقد قيل: ( إنّ حكايات الحيوان تنتشر في جميع أنحاء العالم، وقد احتفظت بمقدرتها على الحياة عبر مئات السنين، ابتداءً من ملحمة جلجامش البابلية، ومنالإغريق حَتَّى عصرنا الحاضر... نجدها لدى الحضارات البدائية، كما نجدها لدى الحضارات الرّاقية )( ).وعند العرب اشتهر (حديث خرافة )، وقيل: إنه من بني عذرة أو من بني جهينة اختطفته الجنّ ثُمَّ رجعَ إلى قومه فكانَ يحدِّث بأحاديثَ ممّا رأى يعجَبُ منها الناسُ فكذَّبوه، ورُوي عن النبي (صلى الله عليه وسلّمَ) أنّه قال (خرافة حقٌّ)( )،وهذا يعني أن المشترك ما بين الأمثولة والحكاية الخرافية القصد إلى الوعظ والحكمة استناداً على الخيال، فلا حضور للمقبولية العقلية في السَّرْدِ الحكائي الأمثولي؛ لتحرّرها من سيطرة حاكمين هما: العقل والحواس اللذان يكونان رقيبين على القوة المتخيَّلة( )، وهما تدوران على لسان الحيوان، ونجد حكاية الأمثولة في "كليلة ودمنة" ضمن ثلاثة أنواع هي :
1- حكاية مطلقة يكون أبطالُها من جنس الحيوان جميعهم .
2- حكاية جزئية يكون أبطالُها مُوَزّعين بين أجناس مختلفة.
3- حكاية ضمنية يكون أبطالهامن البشر وراويها من الحيوان .( )
وعلى سبيل المثال لا الحصر تنتمي حكايتا (البوم والغربان) و (الأسد والثور)إلى النوع الأول، وحكايتا (الناسك والفأرة) و (الجرذ والتاجر) إلى النوع الثاني ، وحكايات (الناسك واللص)، و (المرأة الفاجرة وجاريتها) ، و(امرأة الإسكاف وجارتها)إلى النوع الثالث.
وتمثل حكاية الملك والفيلسوف بيدبا الحكاية الإطار التي تتفرع عنها بقية الحكايات، فتشكل عنقوداً من الحكايات يقوم بروايتها بيدبا الفيلسوف للملك ، كما تتفرع من الحكاية الواحدة حكايات أخرى, ضمن سلسلة متتابعة من الأحداث التي تجري في إطار زماني ومكاني معين، تتوافق الأحداث في تسلسلها منطقياً مع طريقة بنائها بما يقتضيه السياق أحياناً من حذف واسترجاعات واستباقات، فابن المقفع يعتمد على نمط السرد الإخباري الذي تبدأ فيه الحكاية بمقدمة مرتبطة بصيغة إسنادية هي (زعموا أن)، والرواية في الحكاية مزدوجة: إذ يروي الراوي بيدبا الفيلسوف أخباره التي ينسبها إلى رواة آخرين مختبئين وراء الصيغة الاستهلالية (زعموا أن) وتبدأ عملية سرد الحكايات والأمثال التي يأخذ بعضها برقاب بعضٍ على نحو مضبوط بإحكام بالحكاية الأم التي تُذكر في مطلع كل حكاية، والأحداث تتطور وتتأزم ثم تسير نحو الحل. والبناء يتم تدريجياً باستخدام أسلوب السرد مرةً والحوار والعرض مرة أخرى، فيتم بناء الوحدات السردية على شكل متواليات سردية، توظف إمكانات اللغة في خلق نسق تأثيري هدفه الأول هو الإقناع.
فالسارد بيدبا تمكنه سلطة السرد من تبادل الأدوار ، فيمنحه السرد سلطة القوة الناطقة الفاعلة والمؤثرة في المتلقي أي " الملك" الذي وإن حضر ذهنياً إلا أنه غاب شكلياًبعد المقدمة بسبب هيمنة السارد بيدبا على عملية السرد بشكل كامل. وهذا تطويق للملك الذي لا يحاور في النص وإنما هو متلق سلبي فلا تظهر في النص علامات استجاباته، فالراوي يغيِّبهُ كُلياً، على الرغم من أن الراوي يستخدم الحجاج وسيلة للإقناع، إلا أن هذا الحجاج هو أداة الشخصيات لعرض أفكارها والدفاع عنها، على نحو افتراضي يقدم للملك .
ونلمح في متن النص وحدات سردية تحمل الثيمات التي تدل عليها لغة النص، وتتمثل في : ( المُلك, الصداقة, المشورة, الحكمة, الرأي، الإقناع، النميمة، الغدر، الخديعة، المواجهة، القتل...)، إن هذه الثيمات تتخطى إطار الحكاية الواحدة، لتشكل في النص بؤراً دلاليةً، فالحكمة على سبيل المثال ثيمة كبرى تتفرع منها ثيمات أخرى مثل النصيحة والرأي والحذر،فهي نسق حاضر في معظم الحكايات، وهذا يفسر إلى حد بعيد المنظور الإيديولوجي الذي يقوم عليه النص، والذي تجلّى في ربط بين المحور الاجتماعي والنفسي والأخلاقي والفكري على حد سواء، وهذا الربط الذي أسهمت اللغة فيه بشكل واضح، وبدا في تخطي اللغة لمدلولاتها ، إذ تتجاوز بعض العلامات اللغوية إمكاناتها المعهودة، لتصبح بفعل السياق أكثر توهجاً، فرمزية الاسم لحيوان معين مثل ( الأسد، ابن آوى، الثور) قد شحنت بدلالات رمزية تفوق ما تؤديه العلامة وهي مفردة، إضافة إلى أنها قد تخرج أحياناً عن رمزيتها ، فالأسد على سبيل المثال في لحظة معينة يفقد رمزيته للقوة، ويصبح ضحية للمكر والخداع، وابن آوى قد يخرج عن رمزيته للمكر والخداع ، فيصبح حكيماً. فترتبط هذه الدلالات بالوظائف التي تؤديها الشخصيات، فيبدو أن المؤلف يؤسس نسقاً دلالياً رمزياً لكنه قد ينحرف بهذا النسق في المسار الحكائي عما هو شائع ومعهود.ومن ناحية أخرى يسهم هذا النسق في إبراز الثيمة التي بنيت عليها الحكاية.
وتتطلب دراسة الكتاب الكشف عن تقنيات السرد في الحكايات، من خلال دراسة تقنيات ( الراوي والمروي له، القناع، الحجاج، الاستهلال، الزمان والمكان، الأمثال،بناء الشخصيات، التوليد القصصي).فهذا يسهم في تفكيك البناء النصي على مستوى الحكاية الإطار والحكايات المتفرعة عنها. ويوضح كيفية توظيف هذه التقنيات في سرد الحكايات، ويمهد الطريق للكشف عن تأثر الأدباء بتلك التقنيات في مؤلفاتهم التي نحت نحو حكايات "كليلة ودمنة".
المحور الثاني: الراوي مركزية المروي له في الخطاب السردي
إن أي تلفظ أو تسجيل للتلفظ يقتضي شخصاً يتلفظه( )، ذاك الشخص هو الراوي، فيعرف الراوي بأنَّه " أداةً تروي أو تلتزم بنشاط مايخدم حاجيات السرد( )" ويُسمى الراوي الذي لا يشارك في القصة "متباين"، فيما يكون الراوي الذي يتعهد بدور فيها، "متماثلاً" في القصة( ) فيمثل الراوي في الحكاية مركز السرد، وقد ميزت النظريات السردية الحديثة الراوي من المؤلف، فالراوي هو الشخص الذي يروي حكايةً، ويخبر عنها سواءً أكانت حقيقة أم متخيـلة، ولا يشترط أن يحمل اسماً معيناً فقد يكفي أن يتمتع بصوتٍ أو يستعين بنظير ما، يصوغ بوساطته المروي، وتتجه عناية السردية إلى هذا المكون بوصفه منتجاً للمروي بما فيه من أحداث ووقائع، وتعنى برؤيته للعالم المتخيل الذي يكونه السرد، وموقفه منه وقد استأثر بعناية كبيرة في الدراسات السردية( )، ويرى بارت: "أن المؤلف المادي للقصة لا يمكن أن يختلف مع السارد، فإشارات السارد ملزمة للقصة، ويمكن الوصول إليها بالتحليل الإشاري السيميولوجي"( )، فهناك على الأقل ساردٌ واحدٌ ماثلٌ في مستوى السرد مع المسرود له( )، والراوي في الحقيقة هو أسلوب صياغة أو بنية من بنيات القـص، شأنه شأن الشخصية والزمان والمكان، وهو أسلوب تقديم المادة القصصية( )، لذلك تبدو المسافة الفاصلة بين الراوي والمؤلف واضحة، حتى لو بدا الراوي مشكلاً الظل الفني للكاتب، والمعبرعن رؤيته الفكرية والفنية من خلال موقعه المحوري في عملية السرد. وهذا ما يسميه جيرار جينيت المسافة السردية( ), فالراوي هو الكاتب وقد دخل عالم القص، فوضع مسافة بينه وبين ذاته تخوله دخول عالم الشخصيات التي يحكي عنها. إن وضع هذه المسافة تمكنه من ممارسة لعبة الإيهام بحقيقة ما يروي، فالكاتب لا يمكنه أن يوهم بحقيقة ما يروي إذا لم يضع هذه المسافة، فالراوي هو الذي يحدد مواقع رؤية لهذه الشخصيات، وهو لغاتها المختلفة، وهو حوافزها المتنوعة، ومن ثَمَّ فإنَّ مواقع الرؤية تتغير وتتنوع من خلال تغييره، فالسرد هو نُطْق الشخصيات بدواخلها التي ليست بالضرورة دواخل الكاتب، وهكذا تبرز أهمية الراوي في وجوده على مسافة من الكاتب، وعلى مسافة من الشخصيات،سواء أكان واحداً منها أم لم يكن، ومن هنا تبدو أهمية اللغة من حيث هي صياغة لعالم القص. فللراوي هوية الناقل الذي عليه أن يكون أميناً صادقاً في قصه على مستوى المتخيل، من هنا تبدو اللعبة الفنية هي المعادل الأساسي لفعل الصدق والأمانة، أو لقدرة السرد على أن يوهم بحقيقته، فاللعبة الفنية تكمن في أنَّها لعبةٌ شكليةٌ وليست ممارسةً خارجيةً لبعض تقنيات القول، بل هي قدرة القول اللغوي الناهض في بنية قصصية على ممارسة تقنيات هذا النهوض في أن يمثل عالم القص( ). فالراوي وإن كان عنصراً من عناصر البنية،لايمكن وضعه على مستوى التعادل الوظيفي مع بقية العناصر المكونة للبنية، فهو في علاقته بما يروي عنصرٌ مميزٌ ومختلفٌ، فهو الذي يمسك بكل أطراف لعبة القص والكاتب من خلفه هو الذي يمارس هذه اللعبة ليقيم منطق البنية ، إذ إن هذا المنطق هو في الوقت نفسه منطق القول،فيتحدد عنصر الرواي في علاقته ببقية العناصر بوصفه عنصراً مهميناًفي حركة العلاقات بين العناصر، وعلى اعتباره فاعليةً أساسيةً تقيم الاختلاف بين علاقة العناصر فيما بينها من جهة ،وبين علاقة عنصر الراوي بهذه العناصر من جهة أخرى( ). وللرواة أنواعٌ من حيث علاقة الراوي بما يروي ، تتحدد بما يأتي:
1- راوٍ يحلل الأحداث من الداخل .
1-بطل يروي قصته بـ ( ضمير الأنا) .
2-كاتبٌ يعرف كل شيء ( كلي المعرفة) غير حاضر.فالمسافة مع الأحداث معدومة.
2- راوٍ يراقب الأحداث من الخارج.
1-شاهد – حاضر
2-كاتب لايحلل - ينقل بوساطة – غير حاضر.فالمسافة مع الأحداث قائمة ( ).
ويمكن أن يكون الراوي هو البطل الذي يحكي قصته فيحلل ويسقط المسافة بينهوبين مايروي ، ويمكن أن يكون مجرد شاهدٍ يرى ويصور، فهو حاضرٌ لكنه لايتدخل أي لايسقط المسافة مع الأحداث، وفي عدم حضور الراوي " يمكن أن يكون عالِماً بكل شيء فيتدخل محللاً ومسقطاً المسافة بينه وبين مايروي، وذلك لا لكونه مجرد شاهد، بل للجوئه إلى رواة آخرين ثانويين، أو شخصيات تروي له"( ).وفي كل عمل أدبي يتضمن راوياً لابد أن تكون هناك (وجهة النظر)( )، تشير إلى الزاوية التي ينظر من خلالها السارد إلى أحداث قصته وشخصياتها وموقعه منها. يرى هؤلاء النقاد أن قيمة العمل الأدبي تكمُنفي الرؤى، فالمادة القصصية لا تقدم في صورة موضوعية تقريرية، بل إنها تخضع لجملة من الأحكام المنبثقة عن منظورٍ خاص ترى من خلاله، بمعنى الرؤية الشخصية للكاتب التي ينظر بها إلى عمله وكيفية إخراجه إلى القراء حاملاً رؤية الكاتب الفكرية والفلسفية وإدراكه للأشياء( ).
وننطلق في دراسة الراوي والمروي له في كتاب "كليلة ودمنة" من تحليل الخطاب بوصفه الأساس في تقديم المادة الحكائية، فتحديد الرواة في المتن يسمح لنا بالكشف عن ثوابت الخطاب وتحولاته في المتن، لاسيما أن المادة الحكائية ثابتةٌ والاختلاف يكمن في الطريقة التي تقدم بها، إذ يلعب الخطاب دوراً مهماً في طرح الرؤية السردية، من خلال علاقة الراوي في النص بما يرويه وبمن يروي له. ففي الكتاب نجد أن هناك عدداًمن الأصوات السردية هيمن عليها الراوي الخارجي الناظم لعملية السرد، الذي ظهر في الحكاية الإطار، وتبعاً للرواي الخارجي يتحدد نمط القص ، فتنحصر الحكايات في نمطين هما : تخيلي و تخييلي، لكن النمط المهيمن على الحكايات هو النمط التخيلي الخرافي، فإن الشك الحاصل في الحدث الواقع في المروي يهدف إلى استنتاج البديل الرمزي للتمثيل الإنساني، وليس إلى تصديق الحدث، وهذا يعني أن سيطرة النمط التخيلي الخرافي المفارق للممكن، ضرورة من ضرورات العصر الذي عاش فيه ابن المقفع، إذ لجأ إلى قضية الترميز التي استطاع من خلالها وعلى لسان الحيوانات تمثل العلاقات الإنسانية. فـهذا النمط من التأليف لم يكن سائداً في تلك المرحلة التاريخية التي أنتجت النص.ويبين الجدول الآتي مستويات الرواة والمروي لهم في حكايات "كليلة ودمنة" :
المروي الراوي الخارجي الراوي الأول الراوي الثاني الراوي الثالث علاقته بالمروي المروي له الأول المروي له الثاني المروي له الثالث النمط
باب
الأسد والثور ابن المقفع- مؤلف مجهول بيدبا مفارق الملك دبشليم تخيلي
الرجل الهارب
من الموت بيدبا = الملك دبشليم تخييلي
القرد والنجار كليلة = دمنة تخييلي
الثعلب والطبل دمنة = الأسد تخيلي
الناسك واللص كليلة = دمنة تخييلي
امرأة
الإسكاف وجاريتها = تخييلي
الغراب والأسود دمنة = كليلة تخيلي
العلجوم والسرطان دمنة ابن آوى = كليلة الغراب تخيلي
الأرنب والأسد دمنة = كليلة تخيلي
السمكات الثلاث دمنة = الأسد تخيلي
القملة والبرغوث دمنة = الأسد تخيلي
الذئب والغراب وابن آوى والجمل الثور = دمنة تخيلي
وكيل البحر والطيطوى دمنة = الثور تخيلي
البطتان والسلحفاة دمنة أنثى الطيطوى = كليلة الطيطوى تخيلي
القردة واليراعة كليلة = دمنة تخيلي
الخب والمغفل كليلة = دمنة تخييلي
العلجوم والأسود وابن عرس كليلة والد الخب = دمنة الخب تخيلي
الجرذان وتاجر الحديد كليلة = دمنة تخييلي
باب الفحص عن أمر دمنة بيدبا = الملك دبشليم تخيلي
المرأة والعبد دمنة = الأسد تخييلي
الطبيب الجاهل المتكلف دمنة = القاضي تخييلي
الحراث وامرأتاه دمنة = سيد الخنازير تخييلي
المرزبان
وامرأته والبازيار
دمنة = عظيم الجنود والقاضي تخييلي
باب الحمامة المطوقة بيدبا = الملك دبشليم تخيلي
الجرذ والناسك والضيف الفيلسوف = الملك تخيلي
المرأة التي باعت السمسم الفيلسوف الضيف = الملك الناسك تخييلي
الذئب والرجل والقوس الضيف الزوج = الناسك المرأة تخييلي
الجرذ وصاحب الدنانير وأصحابه الضيف = الناسك تخيلي
المرء الذي لا مال له الجرذ = السلحفاة تخييلي
باب البوم والغربان الفيلسوف = الملك تخيلي
الأرانب والفيلة الغراب الغراب = الملك الطير تخيلي
الصفردوالأرنب والسنور الغراب الغراب = الملك الطير تخيلي
الناسك والعريض واللصوص الغراب = الملك تخييلي
الناسك واللص والشيطان الوزير = الملك تخيلي
النجار وامرأته وخليلها الوزير = الملك تخييلي
الناسك والفأرة التي تحولت جارية البوم = الغراب تخيلي
الأسود وملك الضفادع الغراب = الملك تخيلي
باب القرد والغيلم الفيلسوف = الملك دبشليم تخيلي
الأسد وابن آوى والحمار القرد = الغيلم تخيلي
باب الناسك
وابن عرس الفيلسوف = الملك دبشليم تخيلي
الناسك وجرة السمن والعسل المرأة = الناسك تخييلي
باب إبلاد وايريخت الفيلسوف = الملك دبشليم تخييلي
باب مهرايز ملك الجرذان الفيلسوف = الملك دبشليم تخيلي
الملك والثعلب الوزير = الملك تخيلي
الحمار الذي ذهبت أذناه الوزير = الملك تخيلي
باب السنور والجرذ الفيلسوف = الملك تخيلي
باب الملك والطائر والقبرة الفيلسوف = الملك تخيلي
باب الأسد وابن آوى الفيلسوف = الملك تخيلي
باب السائح والصائغ الفيلسوف = الملك تخيلي
باب ابن الملك وأصحابه الفيلسوف = الملك تخييلي
أبناءالملك والشريف والتاجر والأكار الفيلسوف = الملك تخييلي
باب اللبوة
والشعهر الفيلسوف = الملك تخيلي
الغراب والحجلة الفيلسوف = الملك تخيلي
ونلاحظ من خلال هذا الجدول أن الكاتب قام بتوظيف تقنيتي الراوي والمروي له في ثلاثة مستويات سردية: ففي المستوى الأولمن طبقة الرواة، نجد تقارباً شديداً بين الراوي الخارجي الذي يهيئ إطاراً للسرد، وبين الكاتب الذي يتمثل دوره في إيجاد المادة الحكائية، و المترجم الذي قدم المادة الحكائية متقاسماً مع الكاتب دوراً في صنع الحكاية، مسهماً في تقديم الخطاب من خلال وجهة نظره، معتمداً أسلوبه ورؤيته وتقنياته في عرض المادة الحكائية.
فنحن أمام راوٍ خارجي تداخل في صوته صوتان، الأول هو المؤلف الحقيقي الذي لا نستطيع أن نحدد صوته بدقة إلا من خلال جوهر الحكاية أو معناها، على الرغم من بعض التغيرات الطفيفة التي شملته كما يرى بعض محققي الكتاب، وما أثبتته بعض الاختلافات في النسخ المتعددة للكتاب، فالتغييرات من حذف وإضافات تنم على ما أصاب الحكايات من تعديل، ودراسة هذه القضية بتفصيلاتها وجزئياتها قد تخرجنا عن مسار البحث الذي رسمناه، لاسيما أن دراسات مستفيضة أخرى تناولت دراسة هذا الجانب، لذا فنحن هنا نحاول أن نحدد رؤية الراوي الخارجي الثاني، وهو مترجم هذا الكتاب أعني عبد الله بن المقفع، إذ ترجم الكتاب ترجمة غير خالصة، بمعنى أنه تصرف بهذه الترجمة بما ينسجم مع غاياته.
وهنا لابد من الإشارة إلى أن التغيير قد لحق أبواباً بمجملها مثل (باب عرض الكتاب) و(باب بعثة برزويه إلى بلاد الهند لتحصيل الكتاب) اللذين أضافهما ابن المقفع و(باب برزويه الطبيب) الذي أضافه الفرس على الأرجح، وهو موضع نظر لأن النسخة الفارسية نسبته إلى بزرجمهر، وباب (الفحص عن أمر دمنة) الذي لم يُثبت في النسخ الفارسية أو الهندية أو السريانية القديمة ويرجح الدكتور عبد الوهاب عزام أنه من إضافة ابن المقفع( )، من ثم فيمكن اعتبار ابن المقفع مؤلفاً ومترجماً في الوقت ذاته يحدد من موقعه زاوية الرؤية في الحكايات. وقد اتضحت أبعاد هذه الرؤية من خلال "باب عرض الكتاب " إذ كشفت عن طرائق البناء السردي التي سيعتمدها في المتن الحكائي، ومن خلال النظام اللغوي، تتضح خصائص الشكل السردي الذي ستخضع له الحكايات لاحقاً ، يقول ابن المقفع "فأول ما ينبغي لمن طلب هذا الكتاب أن يبتدئ فيه بجودة قراءته والتثبت فيه، ولا تكون غايته منه بلوغ آخره قبل الإحكام له ، فليس ينتفع بقراءته ولا يفيد منه شيئاً وإن طمحت عيناه إلى جمعه، ولم يأخذ منه ما يعي الأول فالأول ، فإنه خليقٌ ألا يصيب منه، إلا كما أصاب الرجل الذي بلغني أنه رأى في بعض الصحارى كنزاً .فلما كشف عنه ونظر إليه رأى شيئاً عظيماً لا عهد له بمثله. فقال في نفسه: إن أنا أحرزت ما ههنا بنقله وحدي لم أنقله إلا في أيام، وجعلت لنفسي عملاً طويلاً، ولكن أستأجر رجالاً يحملونه.ففعل ذلك وجاء بالرجال فحمل كل واحد منهم ما أطاق .وانطلقوا فيما زعم إلى منزله.فلم يزل دائباً في ذلك حتى فرغ واستنفد الكنز كله. ثم انطلق إلى منزله بعد الفراغ فلم يجد شيئاً، ووجد كل رجل منهم قد حاز ما حمل لنفسه؛ ولم يكن له إلا العناءُ في استخراجه والتعبُ عليه) .
فهو يبدأ عرض فكرته على شكل مقولة حكمية ثم يدعمها بحكاية تؤيد ما ذهب إليه ، فتبدو الاستفاضة في شرح الفكرة وتوسيعها بطريقة توليد القصص، وهذا شكل من أشكال الحجاج والخصومة– ونقول هنا خصومة تجوزاً، فالخصم المقصود هنا هو المروي له أو المتلقي الذي يريد إقناعه. فهو يوظف هذه المقولة منذ البداية في نسيج النص توظيفاً تقنياً ليثبت من خلالها فكرته، ويؤيدها بأكثر من حكاية،وبذلك تتوالد الحكايات ضمن القصة الإطارية .
وتتحدد من خلال هذا الشكل الفني والأسلوبي أهداف الكاتب وغاياته، فهو يتوجهفيه مباشرة إلى متلقيه، ويقوم بتهيئة المتلقي لما سيقوله، ويدعوه إلى إعمال العقل والنظر والفكر واتخاذ الوعي سبيلاً إلى الوصول إلى المغزى، والعمل به.
من هنا بدا أن الراوي الخارجي من خلال عرضه الكتاب اعتمد طرائق للسرد تشي منذ البداية بأسلوب الحكاية، ووجه عناية المتلقي إلى الغاية التي يحملها النص، مركزاً على الغرض الاعتباري .
ونستطيع أن نستشف مستوى الخطاب الذي سيقدمه الراوي ووجهة هذا الخطاب، فهو يحدد الفئات التي ستتلقى الكتاب من حكماء وعلماء ومتعلمين وسفهاء، مدركاً أن كلاً منهم سيجد في الكتاب ضالته، فالراوي الخارجي يبدأ سرده بعنصر التشويق وتعزيز ثقة المتلقي بأنه لاشك واجدٌ ما يهمه في الكتاب، وهذا النمط من التشوبق يعمل على تهيئة المتلقي نفسياً لمفارقة الواقع والدخول مع الراوي إلى عالمه السردي، وهو عنصر مهم يقع على عاتق الراوي مهمة إنجازه من اللحظة الأولى للسرد، وهذا ماقام به ابن المقفع عندما ربط غايات الكاتب بغايات القارئ في مقدمته إذ قال: " ولم تزل العلماء من أهل كل ملة يلتمسون أن يعقل عنهم، ويحتالون في ذلك بصنوف الحيل؛ ويبتغون إخراج ما عندهم من العلل، حتى كان من تلك العلل وضع هذا الكتاب على أفواه البهائم والطير. فاجتمع لهم بذلك خلالٌ. أما هم فوجدوا متصرفاً في القول وشعاباً يأخذون منها.
وأما الكتاب فجمع حكمةً ولهواً: فاختاره الحكماء لحكمته. والسفهاء للهوه، والمتعلم من الأحداث ناشطٌ في حفظ ما صار إليه من أمر يربط في صدره ولا يدري ما هو، بل عرف أنه قد ظفر من ذلك بمكتوي مرقومٍ. وكان كالرجل الذي لما استكمل الرجولية وجد أبويه قد كنزا له كنوزاً وعقدا له عقوداً استغنى بها عن الكدح فيما يعمله من أمر معيشته؛ فأغناه ما أشرف عليه من الحكمة عن الحاجة إلى غيرها من وجوه الأدب. وينبغي لمن قرأ هذا الكتاب أن يعرف الوجوه التي وضعت له؛ وإلى أي غايةٍ جرى مؤلفه فيه عندما نسبه إلى البهائم وأضافه إلى غير مفصحٍ؛ وغير ذلك من الأوضاع التي جعلها أمثالاً: فإن قارئه متى لم يفعل ذلك لم يدر ما أريد بتلك المعاني، ولا أي ثمرةً يجتني منها، ولا أي نتيجة تحصل له من مقدمات ما تضمنه هذا الكتاب. وإنه وإن كان غايته استتمام قراءته إلى آخره دون معرفة ما يقرأ منه لم يعد عليه شيءٌ يرجع إليه نفعه. ومن استكثر من جمع العلوم وقراءة الكتب؛ من غير إعمال الروية فيما يقرؤه، كان خليقاً ألا يصيبه إلا ما أصاب الرجل الذي زعمت العلماء أنه اجتاز ببعض المفاوز، فظهر له موضع آثار كنز؛ فجعل يحفر ويطلب، فوقع على شيءٍ من عينٍ وورقٍ؛ فقال في نفسه: إن أنا أخذت في نقل هذا المال قليلاً قليلاً طال علي، وقطعني الاشتغال بنقله وإحرازه عن اللذة بما أصبت منه؛ ولكن سأستأجر أقواماً يحملونه إلى منزلي، وأكون أنا آخرهم، ولا يكون بقي ورائي شيءٌ يشغل فكري بنقله؛ وأكون قد استظهرت لنفسي في إراحة بدني عن الكد بيسير الأجرة أعطيهم إياها. ثم جاء بالحمالين، فجعل يحمل كل واحدٍ منهم ما يطيق، فينطلق به إلى منزله: فلم يجد فيه من المال شيئاً، لا قليلاً ولا كثيراً. وإذا كل واحدٍ من الحمالين قد فاز بما حمله لنفسه. ولم يكن له من ذلك إلا العناء والتعب: لأنه لم يفكر في آخر أمره. وكذلك من قرأ هذا الكتاب، ولم يفهم ما فيه، ولم يعلم غرضه ظاهراً وباطناً، لم ينتفع بما بدا له من خطه ونقشه؛ كما لو أن رجلاً قدم له جوزٌ صحيحٌ لم ينتفع به إلا أن يكسره." .
وفي المستوى الأول من طبقة الرواة في المتن الحكائي نجد الفيلسوف بيدبا والمروي له الملك دبشليم، وهوراوٍ (كليُّ المعرفة) غير حاضر في الأحداث.والمسافة قائمة بين الراوي وما يرويه.ويبدو أن الراوي هنا يتنصَّل منذ البداية من أحداث الحكاية، عندما يستخدم تقنية الاستهلال: "زعموا أن "، فالراوي يتخذ موقف الحياد مما يروي على الأقل ظاهرياً، وينسب هذه الحكاية إلى راوٍ مجهول الهوية،و هذايترك أثراً إيجابياً عند المتلقي،سببه ربط الحكايات بالماضي ، لما له من قدسية في نفوس المتلقين، إذ يرتبط الماضي بالحكمة وتجارب الأقدمين، ويكتسب بذلك المروي مصداقية ما، وربما كان تعزيز هذه المصداقية مهماً جداً، فقد يغفل المتلقي أن الحكاية الأولى أبطالها بشر، بينما سيكون الأبطال في كثير من الحكايات اللاحقة أبطالاً وهميين غير حقيقيين، فيهيئ الراوي توطئةً تؤسس للدخول في عالم السرد المتخيل.
إن ما يحكم البنية الحكائية هو المحافظة على راوٍ أصلي هو بيدبا الفيلسوف ومروي له هو دبشليم الملك، وهذان الطرفان ضروريان للحكاية الإطار، وأما تعدد الرواة فيقع في مستويات أدنى من المستوى الإطاري ، إذ يكون الراوي أحد شخصيات الحكاية.
إن الراوي في المستويات السردية الثلاثة: الحكاية الإطار، والحكاية الفرعية الأولى، والحكاية الفرعية الثانية، هو واحد في حقيقة الأمر، على الرغم من تنوعه واختلافه من حيث التخييل والوضع السردي، فالراوي الخارجي هو المؤلف الفعلي ينتمي إلى خارج النص ويحمل دوراً تنظيمياً ، بينما الرواة الآخرون مهما تنوعوا فهم أصوات سردية يروون النص الكلي، ووجودهم داخل النص هو وجود بنائي، فالسارد يتكرر بتسمية جديدة كلما ازداد سرد الحكايات( ). لكن غاية الكاتب في النص هي تنويع وجهات النظر وزوايا الرؤية في السرد، وبناء النص على محاور متعددة تخرج عن نسق الصوت الواحد، من هنا كانت تعددية الرواة تمكن الكاتب من بناء النص بناء قائماً على تبادل الأدوار، فيكون السارد راوياً مرة، ومروياً له مرة أخرى، كما في حكايات باب الأسد والثور، فتتعاور الشخصياتُ الروايةَ فيما بينها.
ويعتمد الراوي اللغة الواصفة لأنَّها أداة تصوير ترسم من خلال إخبارها ظلالاً أدبيةً، وتتسم هذه اللغة بتركيز مكثف الدلالات، فالتكثيف والاختزال والإيحاء، وهي قضايا سنجدها ظواهر بارزة في نسيج النص السردي، تسهم في عملية تراكمية الحدث من جهة والزمن من جهة أخرى. فاللغة التي استخدمها الراوي تعد بحد ذاتها تقنية كما سنثبت من خلال الدراسة اللغوية للقصص.
ويظهر في المستويين الثاني والثالث تعدد الرواة في الحكايات المتفرعة عن الحكاية الإطار، ينجم عنه تعدد في المنظورات كما في حكاية "الحمامة المطوقة"، إذ يبدأ الفيلسوف رواية حكاية "الحمامة والجرذ" ، وبدوره يروي الجرذ للغراب حكاية "الضيف والناسك"، ثم يظهر في السياق راوٍ جديد هو " الناسك" الذي يروي حكاية المرأة التي باعت السمسم المقشور بغير المقشور، ومن ثم يدخل زوج المرأة في سلسلة الرواة عندما يروي " حكاية الذئب والقناص " ليعود الفيلسوف إلى حكاية "الجرذ والغراب والظبي والسلحفاة " وفق بناء دائري محكم ، إذ بدأ الحكاية عن "الجرذ والحمامة" وانتهى بها، ولا غرابة أن يستخدم ابن المقفع هذه الطريقة البنائية، إذ يبدو تأثره بالفكر الإسلامي واضحاً، فـهذه (الطريقة البنائية توافق إلى حد بعيد الذهنية العربية الإسلامية في تصورها الكون، وقد انعكست هذه الطريقة في البناء والعمارة كالقناطر والأقواس والقباب وفي شكل الحروف وهذا كله يتصل بالتصور الكوني المنطلق أساساً من فكرة الدوران التي يمثلها الطواف عند المسلمين) .
إن استخدام ابن المقفع هذه الرؤية في بناء الحكاية، يوضح أن مهمة الراوي لا تنحصر في سرد وقائع الحكايات، وفي إعادة ترتيب أحداثها الزمنية وفق منظور جديد. وإنما في إبراز الدور الأساسي والفاعل للراويالذي يعتمد مبدأ التوليد السردي في إنتاج الحكايات، ويغير موقع الراوي الذي يعيد تشكيل الأحداث وفق رؤيته ومنظوره الشخصي. وهو في ذلك كله لا يعفي الراوي من التأثر بالطابع العربي الإسلامي.
الخاتمة:
- إن توالد الأفكار والمضامين في (كليلة ودمنة) هو الذي يوضح الصورة الكليَّة المكونة من مجموع الحكايات على وفق خطة سردية واعية تربط بين الحكاية الإطار والحكايات المتفرعة لإنجاز الغايات.
- إنَّ بعض المسارات السردية انزاح فيها الشكل الفني الذي وجدت فيه الحكايات ، وبعضها عاد واختلط بأنواع أدبية أخرى مثل النظم، والمقامة و القصة التاريخية والمناظرة ، مع الحفاظ غالباً على الإطار القصصي الحكائي، وتشكل الشخصيات مكوناً رئيسياً من مكونات القص، ونمطاً بدئياً راح يتخذ شكل النموذج البدئي في الأعمال الأدبية التي راحت تتأثر بشخصيات حكايات "كليلة ودمنة" ، بعضها ظل نمطاً بدئياً لم يتطور ، وبعضها الآخر راح يتطور، ويتحول إلى نموذج آخر.
- إن السرد المركب للحكايات في كتاب كليلة ودمنة يكشف عن علاقات الترابط بين القصص المتوالدة من جهة، وبين الحكاية الإطار، أوالحكاية الأم من جهة ثانية. فإن توالد الأفكار والمضامين هو الذي يوضح الصورة الكليَّة المكونة من مجموع الحكايات، وفق خطة سردية واعية تربط بين الحكاية الإطار والحكايات المتفرعة لإنجاز الغايات، وهي تأديب الملوك وإسداء النصح والإرشاد لهم وتعليمهم حقائق مهمة عن الملك، وتأتي هذه العلاقة من خلال فعل التوالد الذي يحيل على ترابط سرديداخلي، بين القصص المتفرعة، وبين الحكاية الأم. لتكشف خيطاً معنوياً شفافاً يربط بين الحكايات، ويستند إلى التعليل والشرح والإيضاح من خلال الحكايات التي تشكل سلسلة متواصلة لا تُدرك للوهلة الأولى، إلا أن الثيمات الجزئية في النص تجتمع تحت ثيمة كبرى وتترابط ترابطاً معنوياً واضحاً يكشف عن ذهنية بصيرة بمقاصدها وتأدية غاياتها .
- تنتظم الحكايات في " كليلة ودمنة" في إطار متسلسل لتشكّل كل حكاية حلقة، تتعالق برباط زمني ومنطقي مع الحكاية الإطار وبقية الحكايات السابقة واللاحقة. وبناء هذه السلسلة ليس تراكمياً بقدر ماهو استقلالي ، إذ إن تجريد حكاية من السلسلة لا يعني انقطاعها، فالعلاقة الناظمة بينها قائمة على التجاور والتوالد المنفصل.
المصادر والمراجع
1- إبراهيم : عبد الله، موسوعة السرد ، المؤسسة العربية للدراسات والنشر ط1/ 2005م.
2- ابن عبد ربه: أبو عمر أحمد بن محمد، العقد الفريد،ضبطه وصححه أحمد أمين، أحمد الزين،إبراهيم الأبياري، دار الكتاب العربي بيروت لبنان،1983/
3- ابن المقفع: عبد الله: كليلة ودمنة، تح عبد الوهاب عزام ،تقديم طه حسين،دار المعارف،(د.ت)
4- ابن المقفع:عبد الله (ت: 132هـ) : كليلة ودمنة ، راجعه الشيخ الياس خليل زخريا ، دار الأندلس، بيروت 1963م.
5- ابن المقفع : عبد الله: كليلة ودمنة تحقيق الأب لويس شيخو اليسوعي عن أقدم مخطوطة تاريخية بيروت، مطبعة الآباء اليسوعين 1922 م.
6- ابن منظور:جمال الدين محمد بن مكرم ، ت(711هـ) : لسان العرب ،دار صادر، بيروت ط3 /1994 م.
7- أفلاطون: جمهورية أفلاطون- ترجمة حنا خباز- مكتبة النهضة- بغداد 1986-ص 172
8- تشارسكي: أناتولي : أناتولي ، موضوعات عن قضايا النقد الماركسي، مجلة دراسات عربية، العدد 7/1971
9- تودوروف، تزفيتان: مدخل إلى الأدب العجائبي،تر:الصديق بو علام، القاهرة،ط1 دار شرقيات
10- جنيت: جيرار وآخرون : شعرية المحكي ، تأليف رولان بارت , ولفغانع كيزر , واين بوث , فيليب هامون ، بإشراف جيرار جينيت وترفيتان تودوروف ، تر : غسان السيد ،طبعة الجمعية التعاونية للطباعة 2001 م.
11- حميد : باسم صالح: سلطة السرد مجلة التربية الأساسية الجامعة المستنصرية العدد 50/ 2007
12- الخطيب: عبد الكبير :في الكتابة والتجربة– ترجمة :محمد برادة – دار العودة بيروت 1980م.
13- الروبي: ميجان وَ البازعي: سعد ، دليل الناقد الأدبي، المركز الثقافي العربي- المغرب ط3 2002.
14- زكي : أحمد كمال : الأساطير بيروت دار العودة ط2/1979م.
15- سواح: فراس : مغامرة العقل الأولى ، بيروت ،لبنان دار الكلمة للنشر ، ط/ 1998م.
16- شولز، روبرت ، البنيوية في الأدب ، تر : حنا عبود ، اتحاد الكتاب العرب ، دمشق ،1984م.
17- صالح: إبراهيم،و صالح:هند، الحكاية المثلية عند ابن المقفع، دار محمد علي للنشر 2003م.
18- صحراوي، إبراهيم: السرد العربي القديم الأنواع والوظائف والبنيات، الدار العربية للعلوم ناشرون، منشورات الاختلاف،2008م. ط1)
19- عابدين: عبد المجيد،الأمثال في النثر العربي القديم ط1/دار مصر للطباعة
20- عبود: حنا: النظرية الأدبية الحديثة والنقـد الأسطـوري منشورات اتحاد الكتاب العرب 1999
21- عكام : فهد: نحو تأويل تكاملي للخرافة، بحث أعد للمشاركة في الملتقى الدولي الثاني(تحليل الخطاب الأدبي) الذي قرر عقده بدياً بجامعة تيزي وزو الجزائر بتاريخ 18-19-1991،
22- علبي ، أحمد: ابن المقفع الكاتب والمترجم والمصلح ،دار الفارابي بيروت ط2002م.
23- عوض: ريتا ، خليل حاوي، فلسفة الشعر والحضارة، بيروت، دار النهار ، ط2،
24- الغذامي :عبد الله محمد ، النقد الثقافي (قراءة في الأنساق الثقافية العربية المركز الثقافي العربي، بالدار البيضاء وبيروت، ط/2، 2001م.
25- كامبل: جوزيف، قوة الأسطورة ، تر: حسن صقر، ميساء صقر، دمشق ، دار الكلمة، ط1/ 1999،
26- الكعبي : ضياء: السرد العربي القديم :الأنساق الثقافية وإشكاليات التأويل،المؤسسة/ العربية للدراسات والنشر،بيروت،ط/ 2005 م.
27- مارتن , والاس :نظريات السرد الحديثة ,تر: حياة جاسم محمد،المجلس الأعلى للثقافة،1988 م
28- النعيمي : أحمد إسماعيل:الأسطورة في الشعر العربي ما قبل الإسلام، دار الشؤون الثقافية بغداد 2005م
29- هلال: محمد غنيمي ، الأدب المقارن، دار العودة، بيروت، 1983م.
30- هومبيرت : إيلي ،كارل غوستاف يونغ : تر: وجيه أسعد ، دمشق وزارة الثقافة ، 1991م.