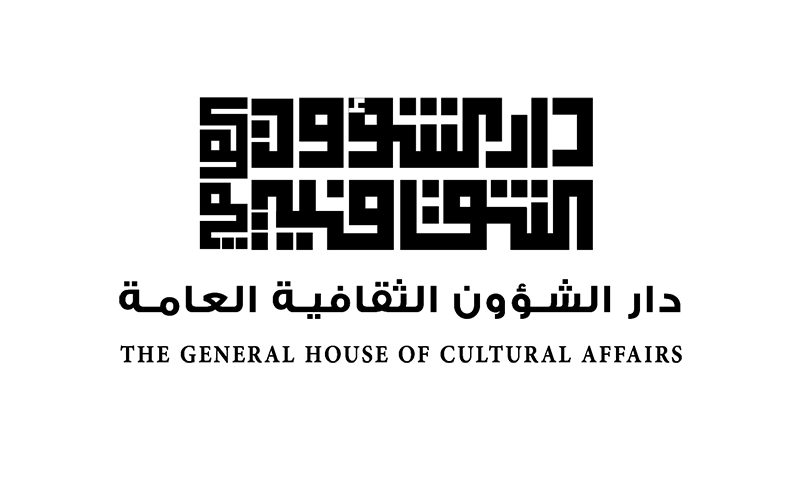![]()
دراسات وبحوث
الشعر واقتضاء السرد قراءة في نص ((خطوةٌ في الضباب)) لحسب الشيخ جعفر

الشعر واقتضاء السرد
قراءة في نص ((خطوةٌ في الضباب)) لحسب الشيخ جعفر
د. عبد العظيم السلطاني
النص:
خطوةٌ في الضباب([1])
قبل أن أتوخّى الحذر
قبل أن يتقوّسَ في الحبس ظهري،
ويبيـضَّ مني القَذال
كنتُ فيما يقال
أتلقّى الصدى وأُطيلُ النظر
عَبْرَ نافذتي والطِوار
عَبْرَ نافذتي واتشاحِ الطريقِ الخريفيّ كنتُ أُرامقُ
نافذةً في الجوار
فأرى في ارتخاءِ الستار
في ارتخاءِ الستارِ الخفيفِ المواربِ في الضوءِ ظلًّا وحيدا!
علَّها امرأةٌ في انتظار
علَّها تتأملُ نافذةً في الجوار!
غيرَ أن الستار
لم يزل يتمايل في هبّةِ الريحِ منذُ انطواءِ النهار
وهي فيما وراءَ الستار
تتراءى كما يتراءى الرداءُ المعلُّق في الحبلِ مائلةً، متمايلةً
في اتجاهِ المطار
في اتجاهِ المطارِ البعيد
وقد انطفأتْ في النوافذ أضواؤها غيرَ ضوءٍ وحيد!
***
ويمرُّ النهارُ الخريفيُّ بعد النهار
وهي مائلةٌ، متمايلةٌ في اتجاه المطار!
قلتُ: ( أمضي، أُنبّهُ جارتَها
وندقُّ الجرس !)
ولقد دُقَّ فيما بدا لي الجرس
ساعةً، وهي نائمةً أو منومةً لا تُفيق
فإذا التفَّ من حولِنا الناسُ وانفتحَ البابُ،
أبصرتُها
كالرداءِ المعلقِ في الحبلِ مائلةً ، متمايلةً
تحت مصباحِ سقفٍ وحيد !
***
مرةً كنتُ منفرداً في ممرِّ القِطار
ساعةَ انتصف َ الليلُ،
وانصرفَ النُدلُ والطاعمون
فإذا بي أرى وجهَها في الضباب الخريفيّ
عَبْرَ الزُجاج
وهي قائمةٌ في الممرِّ إلى جانبي!
قلتُ: (لابدَّ من أنني مرهقٌ
فإلى الدفءِ والأغطية!)
غيرَ أني التقيتُ بها عندَ طاولتي في انتظار!
قلتُ: (أمضي إلى امرأةِ الشاي علِّي أُزحزِحُ عني الدُوار)
وهنا انفتحَ البابُ عنها معلّقةً
كالرداءِ المعلَّقِ في الحبلِ مائلةً، متمايلةً
في اتجاهِ الستار
وأنا والمحطةُ والناسُ فيما وراءَ الستار!
***
ويمرُّ النهارُ الخريفيُّ بعدَ النهار
وهي مائلةٌ في اتجاه المطار!
قلتُ: (أمضي أُنبّهُ جارتَها)
ولقد دقَّ ملءَ الممرِّ الجرس
بينما كنتُ أَلمحُ جارتَها
تتسللُ في الثقبِ كالضوءِ أو كالدُخانِ
إلى الغرفةِ الموصدة
فإذا انفتحَ البابُ أبصرتُها
كالرداءِ المعلقِ مائلةً في انتظار!
قلتُ: (أغلقُ أجفانَي المجْهَدة
وأنام
ساعةً، فلقد يتبدّدُ عني الغَمام !)
فالتقيتُ بها متمدّدةً تحت أغطيتي لا تَريم !
قلتُ: (أحملُ جثتهَا، وأغِذُّ الخطى في العراء!)
غيرَ أن الحرس
سمِعوا في يديَّ الجرس
مالئاً بالرنينِ الفضاء!
وهنا أوقفونيَ متهمَاً، وأقاموا الحُجج بين أيدي القضاء!.
العنوان باب موارب :
العنوان في هذا النص يفتح بابا مواربا للقارئ لشيء من فهم، ((خطوةٌ في الضباب))، يبدأ بعلامة/كلمة ((خطوة))، والخطوة حركة صغيرة، فهي خطوة واحدة ليس إلّا. وهذا يعني إنّها غير محفوفة بكثير من الخطر، وليست بحاجة كبيرة إلى الحذر. غير أنّ وضعها في سياقها من الجملة يتكشّف عنه احتمال خطر كبير؛ لأنّها في الضباب. وهي بالنتيجة حركة صغيرة ((خطوة)) صارت محفوفة باحتمالات كثيرة؛ لأنّها اقترنت بعلامة أخرى/ كلمة ((الضباب))، وهنا انفتح باب الاحتمال على أكثر من شيء: المجهول/ اللّاوضوح/ توقّع المفاجأة/ القلق والتوتر... كل هذه الاحتمالات والمشاعر واردة في حالة الضباب. فأيّ الاحتمالات تدنِيها إلى المتلقي قراءة متن النص؟! نهرع إلى متن النص، إذن، فهو قد يعود ثانية لينير العنوان. في حين المواجهة الأولى للقراءة- أيّة قراءة- يكون العنوان لحظة الإنارة الأولى للنص. لكنها هنا في هذا النص ضبابية لا تقدّم من الضوء ما يكفي للرؤية.
تتبّع حركة النص:
((خطوةُ في الضباب)) نص شعري، ينتمي لشعر التفعيلة، وهو متوسط الطول، يقع في واحد وستين سطرا شعريا. أطول سطر فيه يتألّف من ثماني كلمات وأقصر سطر فيه يتألّف من كلمة واحدة. وهو نص سداه الشعر ولحمته السرد. ويقدّم للقارئ نصّا تخييلا كأنّه حكاية، لها موضوع واحد تدور فيه، ولا تكتمل الصورة لدى القارئ إلّا بالانتهاء من قراءة النص كاملا. والنص مؤلّف من أربعة مقاطع، كلّ مقطع فيه يقدّم مشهدا، ومجمل المشاهد تفضي إلى رسم كلي لحدث وقع.
والراوي هو بطل السرد يروي للمتلقي، في زمن لاحق لزمن وقوع الأحداث. والراوي في أيّ سرد يصفه رولان بارت بـأنّه كائن من ورق([2])، أي شخصية مصنوعة يصنعها مؤلّف النص. وفي نص ((خطوةٌ في الضباب)) صنعه الشاعر/ المؤلف. وفيه نجد الراوي يروي أحداثا وقعت للمؤلف/ الشاعر. غير أنّه وإن اقترب حدّ التطابق مع الشاعر، بوصفه ذاتا شاعرة، أنتجت النص الشعري استجابة لمعطيات وسنن قوليّة تخص عالم الشعر وتحيل عليه؛ يبقى ليس متطابقا مع شخص حسب الشيخ جعفر الإنسان. لذا صار لدينا شاعر ينسج شعرا يتضمن سردا يرويه راوٍ وكأنّه هو. فلا يروي عن الغير، بل هو البطل في الحدث.
قراءة متن النص ترجّح خيار كتابة توصيف أو تخطيط من خلال إعادة الصياغة لتتبّع حركة النص وطريقة تناوله لموضوعه. وبالمجمل هو سرد شعري يبدأ من لحظة تاريخية سابقة لزمن الحكي الذي يحصل في لحظة كتابة النص. يبدأ بـ ((قبل)) وتتكرر في بداية جملتين تضيئان تاريخا سابقا لزمن الحكي، حين كان الشاعر السارد في حال من الاندفاع، وقليل الخشية لا يحاذر ((قبل أن أتوخّى الحذر)). ثم ترد الجملة اللاحقة المُحِيلة على حاله القديم ((قبل أن يتقوّسَ في الحبس ظهري)). ولعل هذه الجملة مفتاح يفسّر لنا لاحقا بعض الأحداث أو الأسباب، فهو في لحظة الحدث المسرود كان في عنفوان الشباب والمخيلة في أقصى طاقاتها. وتتبعها جملة فرعية معطوفة عليها ((ويبيـضَّ مني القَذال))، أي قبل أن يتمّ الشيب دورته على قفا رأسه ويدكّ آخر المعاقل التي تقاوم الشيب (قذال الإنسان في المعجم ما هو واقع بَيْن الأُذُنَيْنِ مِنْ مُؤَخِّرةِ الرَّأْس).
بعد هذه الإطلالة ينفتح السرد، بعد أن وضع الراوي إشاراته التي حدّدت زمن حصول ما سيسرد من أحداث، وهو الزمن الماضي وليس الزمن الحاضر حيث يُكتب النص.
ويبدؤها بـ((كنتُ فيما يقال))، مستعينا بجملة اعتراضية أقرب إلى اللازمة السردية ((فيما يقال)). وهذه يمكن أن نجدها في نص سردي آخر وإن لم يكن شعراً، ولكنها هنا مهمّة لأنّها تؤكد أن سردا لحدث أو أحداث ماضية سيبدأ، وعلى القارئ أن يتهيّأ لتلقّي المسرود.
يبدأ سرد الحدث، بـ((كنت [...] أتلقّى الصدى))، أي هو متلقٍ فقط، وليس فاعلا، ثمّ إنّه يتلقى ((الصدى)) أي لا يتلقى الصوت المباشر الحقيقي. وهذا قد يكشف بعضا من هدوء المكان ساعة وقوع الحدث.
((وأطيلُ النظر))، ولم تكن نظرة عابرة، بل إطالة في النظر يفضي إلى تأمّل في المكان والموقف وفتح لآفاق التخيّل، بما يهيّئ لقدحات نفسية واستحضارات باطنية. وكل هذا يجري من خلال نافذة ((عَبْرَ نافذتي والطِوار))، (في المعجم: "الطَوار" بالفتح. وطَوَارُ الدَّارِ: مَا كانَ مُمْتَدّاً مَعَها مِنَ الفِناءِ ). وثمّة شعور شفيف بالحزن تبثّه فكرة حضور الخريف ((واتشاح الطريق الخريفيّ)).
هذا هو المشهد الكلّي، في أنّه يتلقى الصدى ويطيل النظر عبر النافذة نحو الطريق في فصل خريفيّ، وفي ظلّ هذا المشهد ثمّة نظرات جانبية يرامق من خلالها نافذة مجاورة، (في المعجم رمَق الشَّيءَ: نَظر إليه وأتبعه بصره يرقبُه ويتعهَّدُه، ورامق : أتبعه بصره ونظر إليه يرقبه)، بين الفينة والأخرى شيئا آخر لفت انتباهه ((كنتُ أُرامقُ نافذةً في الجوار)). والذي أتاح فرصة أن يرامق أنّ لديه زمنا واسعا، فهو كان يطيل النظر فيرى شيئا. فماذا كان يرى من خلال نافذة الجوار؟! كان يرى ((في ارتخاءِ الستارِ الخفيفِ المواربِ في الضوءِ ظلًّا وحيدا!)). وهنا هو يرى ((ظلّا)) لا حقيقة. فيذهب التصوّر به إلى أنّه ظلّ امرأة. ويخمّن سبب وقوفها من خلال أكثر من احتمال: ((علَّها امرأةٌ في انتظار)). وقد لا تكون في حالة انتظار، وهذا احتمال آخر، فـ ((علَّها تتأملُ نافذةً في الجوار!))، أي لعلّها مثل حاله تتأمّل، وهنا قد تكون هذه المرأة تتأمّل وجوده وهو في نافذته.
وقد لا تكون في حالة تأمّل ونظر إلى نافذته؛ لأنّ ((الستار لم يزل يتمايل في هبّةِ الريحِ منذُ انطواءِ النهار))، وهذا الظلّ يتمايل ولمدّة طويلة: منذ انطواء النهار. لذا يتسرب شكّ لديه في أن تكون امرأة تنظر إليه من نافذته، فليس معقولا أن تستمر كل هذه المدّة في النظر إليه. فالذي يراه أن امرأة ((تتراءى كما يتراءى الرداءُ المعلُّق في الحبلِ))، فهي غير مستقرة كرداء على حبل تحركه الريح. وبالرغم من تمايلها تبقى على اتجاه واحد، فهي ((مائلةً، متمايلةً في اتجاهِ المطار))، وهو بعيد عنها. ويستمر تمايلها وانتظارها ((وقد انطفأتْ في النوافذ أضواؤها غيرَ ضوءٍ وحيد!)). هذا الضوء الوحيد هو ضوء النافذة التي تنظر منها بعد أن انطفأت أضواء النوافذ الأخرى، إشارة إلى خلود الناس إلى النوم.
هو يتعاطف معها، فهو وحيد يطيل النظر ليس لغاية بل في طريق طويل في حال من خريف حيث ظلال الحزن... وهي وحيدة وتطيل النظر باتجاه المطار وكأنّها تنتظر من يجيئ من هنالك... وهنا ينتهي المقطع الأول الخاص بسرد أحداث تلك الليلة مفتوحا على احتمالات عدّة.
يبدأ المقطع الثاني بأن يؤطر الزمن الكلّي للحدث بأنّه ((الخريف))، أيضا. ويحذف بعضا من زمن الحدث حين لا يتضمن جديدا، ويختصر السرد بجملة تشير إلى أنّ النهارات المتتابعة تمرّ ((ويمرُّ النهارُ الخريفيُّ بعد النهار)). وتلك المرأة/ الظل ((مائلةٌ، متمايلةٌ في اتجاه المطار!)). ومن المنطقي هنا أن يتحرك في داخل الشاعر/ الراوي إحساس بضرورة أن يفعل شيئا حيال استمرار ما يرى، ليعرف حقيقة هذه المرأة/ الظل المتمايلة من خلال النافذة، وخلفها الستارة المُرخاة... فيخاطب نفسه بأن لابدّ ان يفعل شيئا: ((قلت: (أمضي، أُنبّهُ جارتَها وندقُّ الجرس !) )). وقد نفّذ ما فكر فيه، فدقّ الجرس طويلا بصحبة جارتها وهي تبدو نائمة لا تفتح الباب. ثم يثير الناس هذا الوقوف الطويل أمام الباب والجرس يدق ولا من مجيب، فالتفّ الناس حولهما ((فإذا التفَّ من حولِنا الناسُ وانفتحَ البابُ، أبصرتُها)).
الراوي لم يسرف في الحديث عن طريقة فتح الباب. فهو يسرد شعرا، وليس مجرد سرد حكاية لتُعنى بكل التفاصيل. فما الذي أبصره بعد فتح الباب؟ الشاعر/الراوي لم يكن معنيا بما أبصره الناس الذين التفوا حولهم، وليس معنيا بما أبصرته جارتها!، هو معني بما يُبصره هو (واقعا أو تخيّلا)، لذا قال: ((أبصرتها)). وهنا تنفتح الاحتمالات والتوقّع المتعدّد للقارئ مثلما انفتح لديه هو. أبصرها، فماذا سيبصر؟!. وجدها: ((كالرداءِ المعلقِ في الحبلِ مائلةً، متمايلةً)). فهي هنا – وللوهلة الأولى- ليست سوى رداء معلق في الحبل بوضعية مائلة متمايلة (متحركة غير ثابتة على قاعدة). لكن حرف التشبيه (الكاف) في ((كالرداء)) يمنع من هذا التصوّر، فهو يتحدث عن شيء كالرداء، فهي هنا امرأة معلّقة وهنا ينفتح التعدد في التصوّرات لدى القارئ: فكأنّها مشنوقة بالوحدة ((تحت مصباحِ سقفٍ وحيد!)). وهي في حال من الانتظار: انتظار شيء/ أحد يأتي من جهة المطار. هذا ما قد يتصوره المتلقي للوهلة الأولى ويحذف احتمالات أخرى. لكن هذا ليس ما أبصره الراوي فعلا، فقد يكون المشهد شيئا آخر وليس امرأة مشنوقة. وهنا ينتهي المقطع الثاني من النص، بشيء من الإبهام والتشويق في انتظار القادم ليتحقق الفهم.
يبدأ المقطع الثالث كاشفا بصورة أكبر عن طبيعة تلك المرأة المائلة والمتمايلة، وهذه المرّة في القطار، بما يدفع الواقعة في المقطع السابق لتحلّ واقعة أخرى يصادف فيها تلك المرأة. هذه المرّة في القطار وفي منتصف الليل، ((مرةً كنتُ منفرداً في ممرِّ القِطار ساعةَ انتصف َ الليلُ))، وحيث لا أحد فقد انصرف الخدم ومقدمي الطعام : ((انصرفَ النُدلُ والطاعمون فإذا بي أرى وجهَها في الضباب في الضباب الخريفيّ عَبْرَ الزُجاج وهي قائمةٌ في الممرِّ إلى جانبي!)). فهي، إذن، حضرت أمامه في منتصف الليل وفي فصل الخريف، أيضا. وهو لوحده وفي القطار (حيث هو وسيلة نقل، وحركة، وضد السكون. وهنا حدّث نفسه مثلما حدّثها في موقف سابق، بأنه قد يكون مرهقا وما يراه ليس سوى تَهـيُّؤات، وعليه أن يخلد إلى الفراش ويتدفأ : ((قلتُ: (لابدَّ من أنني مرهقٌ فإلى الدفءِ والأغطية!) )). فهل نجح في التخلّص ممّا ظنّ أنّه وهمٌ سببه الإرهاق؟ الجواب: كلا. فبعد أن ذهب إلى مكانه في القطار وجدها ثانية بانتظاره ((غيرَ أني التقيتُ بها عندَ طاولتي في انتظار!)), إنّها في كلّ مكان. فقرر أن يحتسي شاياً من امرأة تقدّم الشاي في القطار، لعله يساعد في طرد تشويش الإرهاق والدوار الذي يتصوّر أنّه ينتابه الآن. ((قلتُ: (أمضي إلى امرأةِ الشاي علِّي أُزحزِحُ عني الدُوار) )). غير أنّه حين وصلت امرأة الشاي انفتح له الباب وإذا بها المرأة/ الشبح نفسها، وهي معلقة كما رآها في الحالات السابقة، ((وهنا انفتحَ البابُ عنها معلّقةً كالرداءِ المعلَّقِ في الحبلِ مائلة، متمايلةً في اتجاهِ الستار وأنا والمحطةُ والناسُ فيما وراءَ الستار!)). هي شبح يطارده، إذن، حاضرة أينما ذهب وحلّ، يجدها على الحال نفسه. فهي الحالة الثابتة على الرغم من تمايلها وهو المتحرك، حيث هو هنا مع الناس والمحطة كلها بجهة وهي في الجهة المواجهة. وفي الحالة السابقة كانت هي بجهة وهو وجارتها والناس بجهة أخرى يواجهونها. وهنا ينتهي المقطع الثالث، وما زال الأمر لديه لغزا، وما زال القارئ يترجح لديه تصوّر شيئا فشيئا ومشهدا بعد مشهد بأنّها ((شبح)) يطارده. ولنا أن نسأل: مَنْ هذه التي تواجه الجموع في الحالتين (في البيت وفي القطار) ولا يراها سواه؟! قد تكشف القراءة شيئا بهذا الخصوص.
يعود النص في المقطع الرابع إلى لحظة سردية سابقة سجّلت ما حصل له معها في المقطع الأول، حيث هو في نافذته يتأمل الطريق الممتد في ذلك اليوم الخريفيّ، في حين تتراءى له المرأة/ الشبح المائلة باتجاه المطار. والمطار مكان احتواء الطائرات (وسيلة نقل، وعلامة حركة وضد السكون)، بما يرجّح لدى القارئ أنّ لهفة الشاعر الراوي معلّقة بأمكنة نقل المسافرين، وهذه الأمكنة حاضرة فيه وتنعكس على الاتجاه الذي تكون عليه المرأة، لتكون باتجاه المطار. وهنا تتطابق الاحتمالات لديه مثلما هي لدى المرأة/ الشبح، أو قُلْ: هو المرأة معبّرا عن رغباته المحتملة الدفينة من خلالها. فقد تكون بحثا عن قادم يأتي أو خبر يصل، وقد تكون لهفة إلى لحظة سفر إلى مكان آخر.
مرّة أخرى يحذف الراوي بعضا من زمن الحدث، لأنّه لا يتضمن جديدا ((ويمرُّ النهارُ الخريفيُّ بعدَ النهار وهي مائلةٌ في اتجاه المطار!)). وفي هذا الموضع من النص يستشعر القارئ بعض إرباك في السرد، ليس مصدره قطع في عنصر الزمن، بل مصدره إرباك في تكرار الحدث في المكان عينه. فبعد أن كان السرد يجري وكأنّه في قصّة قصيرة من حيث تحديد الزمان والمكان وتتابع الأحداث، وانتظامها في أكثر من مكان صار هنا مقطوعا، وكأنّه عاد إلى نسخ حدث وقع في مكان بعينه، سبق للسرد أن تجاوزها وقدّمها للقارئ. فبعد أن نبّه جارتها في المقطع الأول وذهبا إليها، يعود في هذا المقطع إلى الفعل نفسه، في حين هو اكتشف إنّها شبح لا حقيقة، ولاشكّ أن جارتها توصلت إلى الاكتشاف نفسه!.
لكن لا بأس، إنّه سرد في الشعر، غايته الرئيسة تحريك التلقي وهز وعي القارئ. وله أن لا يلتزم بمنطق ترتيب السرد التقليدي في النثر، فليس غايته سرد أحداث كما تُسرد في القصص المقدَّمة للقارئ على أنّها قصص وليس شعرا. وأظنّ أنّ ما دفع الشاعر/ الراوي إلى هذا أنّه أراد العودة إلى المكان نفسه، كي يكون تمهيدا لنهاية الأحداث التي أراد لها أن تكون، وكما سيتضح لاحقا.
((ويمرُّ النهارُ الخريفيُّ بعدَ النهار وهي مائلةٌ في اتجاه المطار!)). ويعاود السلوك نفسه: ((قلتُ: (أمضي أُنبّهُ جارتَها) )). وبعد أن دقّ الجرس جاءت المفاجأة الأخرى، إذ صارت جارتها هي الأخرى كالضوء أو كالدخان، (( كنتُ أَلمحُ جارتَها تتسللُ في الثقبِ كالضوءِ أو كالدُخانِ)). فإذا تسللت و((انفتحَ البابُ أبصرتُها كالرداءِ المعلقِ مائلةً في انتظار!)). وهنا صار الراوي مشككا في قدرته على التركيز، ومشككا فيما يرى فهو يشعر بالإعياء، فقرّر أن يذهب إلى النوم، لعله يتخلّص من شبحها الذي يطارده، فـ (( قلتُ: (أغلقُ أجفانَي المجْهَدة وأنام ساعةً، فلقد يتبدّدُ عني الغَمام !) )). فهل تخلّص منها حين قرّر النوم ليستريح؟!. الجواب: كلا؛ فقد وجدها هذه المرّة في فراشه متمددة متغطية بغطائه ولا تبارح المكان، ((فالتقيتُ بها متمدّدةً تحت أغطيتي لا تَريم!) )). ماذا يصنع، إذن، في هذه الحالة وهي ممدّدة في فراشه؟! خطر في باله أن يتخلّص من جثتها بخطىً مسرعة: ((قلتُ: (أحملُ جثتهَا، وأغِذُّ الخطى في العراء!) ))، فلم يفلح في التخلّص منها، بل وقع في النهاية المؤلمة: ((غيرَ أن الحرس سمِعوا في يديَّ الجرس مالئاً بالرنينِ الفضاء! )). فأيّ جرس هذا؟ هل هو الجرس الذي كان يدقّه على تلك المرأة/ الشبح، أم الجرس الذي كان يدقه على جارتها؟!. يبدو لا فرق، فهو الجرس الذي يدقّه على مطلق فكرة المرأة. هو الجرس القاتل في نهاية المطاف. إن استجابتْ له المرأة فهو مقتول، وإن لم تستجب فهو مقتول بشبحها الذي يطارده، أو بجثتها المحمولة التي صارت دليلا عليه كما يتصور حينها، ويروي لنا ذاك التصوّر. في نهاية الأمر صار لدى الحرس قاتل يحمل جثّة، وهذا دليل على وقوع جريمة، ((وهنا أوقفونيَ متهمَاً، وأقاموا الحُجج بين أيدي القضاء!.)). فهل أوقفوه لأنّه يحمل الجثّة (الوهم) حين كان كابوسا، أم أوقفوه لأنّه يدق الجرس طويلا بسببها فيزعج الناس؟!. أم الأمر كلّه كابوس: المرأة والحرس والقضاء؟!.
هي المرأة حين تكون كاللعنة التي لا يستطيع الفكاك منها، أو قل إنّ شبحها يطارده لأنّ صورة الشبح ساكنة في أعماق الراوي، والخلاص غير ممكن حتى النهاية، وهكذا كانت نهاية الكابوس: حرس وأدلة وقضاء.
هذه تصوّراته، أو قل تهيّؤاته، فهي صورة ضاغطة في داخله، تلاحقه ويتصوّر وجودها خالطا بين الواقع والوهم. صورة المرأة التي فيه، وتتجلى له في كل مكان وتطاره بأن تشخص أمامه، ولا يستطيع الخلاص منها حتى النهاية. بل هي النهاية، فحين يحاول التخلّص منها تصبح نهايته وهلاكه على يديها.
ونص ((خطوةٌ في الضباب)) نص ثري وفيه طاقة قادرة على تحريض المتلقي على التأويل، فهل يتسّع خيال القارئ وتزداد شكوكه في نصّ ملغّم بالاحتمالات فيتصوّر أنّ المرأة/ الشبح هذه هي الحياة نفسها؟! قد يحق للقارئ ذلك، لا سيما حين يرفع بصره ليعود إلى قراءة عنوان النص ويربط إنارته بإنارة متن النص، فهو ((خطوةٌ في الضباب))!. وقد يزداد القارئ ميلا إلى هذا التصوّر حين يتذكر أن تلك المرأة كانت ترد في مشاهد النص مفردة وتواجه الجميع، ولا يراها سوى الشاعر الراوي. وكأنّه يروي عن عين الشاعر وهي ترى ما لا يراه غيره.
وهو في الوقت عينه يحرّض المتلقّي على طريقة جديدة في النظر إلى الحياة. فنص ((خطوة في الضباب)) تضمن خطابا، ولم يكن مجرد نص مسرود. والخطاب في السرد يتحقق لدى تودوروف بخصوصية، فهو ((أي منطوق أو فعل كلام يفترض وجود راوٍ ومستمع وفي نية الراوي التأثير على المستمع بطريقة ما))([3]). فالنص لا يُنظر إليه لوحده منفصلا عن غيره، إنّما هو نص وسياق. والمتلقي يقع ضمن سياق النص، فهو ضمن مجمل الظروف المحيطة بالنص والعناصر المؤدية إلى الفهم. وهذا النص تضمّن خطابا. ولم يكن مجرد سرد؛ لأنّه تضمن راويا ومتلقيا، وفي نية الراوي التأثير فيه. بدليل أن النص اُفتتح بما يبيّن أنّه سيسرد للقارئ شيئا: ((كنتُ فيما يقال))، ثمّ يبدأ بالسرد. وهنالك شيء آخر وهو أنّ السرد يقدّم رؤية الراوي وموقفه، ولا يكتفي بسرد الأحداث بحيادية. (فالراوي مثلا، يقوم بالأفعال والأقوال: فهو يتلقى الصدى، ويطيل النظر، ويرى ظلّا، وينبّه جارة المرأة، ويدق الجرس، وهو في ممر القطار، ويرى وجهها، ويلتقي بها، وينبّه جارتها، ويغلق أجفانه، ويلتقي بها في فراشه، ويحمل جثّتها). وفي الأقوال هو حاضر في النص بقوّة من خلال تكرار كلمت (قلتُ) مخاطبا نفسه. وهذه الكلمة تكررت ست مرات في النص.
هذا النص ((خطوة في الضباب)) ثقافيا هو نصّ المدينة؛ من حيث النزعة والتشكيل. فمفرداته تداولية ابنة الحاضر المعيش، وإيقاعه هادئ ولا قافية تقرع نهايات سطوره الشعرية بقوة. والأهم من كلّ هذا أنّه نصّ يتضمّن تعبيرا عن حال إنسان المدينة، حيث الأحاسيس المركّبة، واختلاط الواقع بالكوابيس، واستلاب الصفاء وحضور الإرهاق والتشويش والتوتّر، ليكون شعورا رفيقا للإنسان في حياته، وفي نظرته للحياة.
ألاعيب السرد وإقناع المتلقي:
قدّم الراوي ذاته للمتلقي على أنّه- حين كان في زمن وقوع الحدث وتلبّس المرأة الشبح فيه- شخصية مشوّشة ومرهقة وتسيطر عليها تهيُّؤات، وهو من خلال اكتمال سرد الحكاية بيّن بأنّه كان يرى المرأة وهي لم تكن واقعا. والمتلقي يستشعر أنّ بعض ما يرويه ليس منطقيا، وليس متطابقا مع حركة الحياة ومنطقها الواقعي. وبناءً على هذا كان يحق للمتلقي أن يرفض السردية هذه. فهو يتلقى سردية من راوٍ يُعبَّر عنه في علم السرد بـ ((الراوي غير الثقة))، وهو الذي لا تتطابق في روايته رؤية المؤلف ورؤية الراوي ورؤية القارئ([4])، على الرغم من كون الراوي في القص ليس ذاتا واقعية، إنّما هو صيغة فنيّة وأداة يستخدمها القاص([5]). غير أنّ إحساس المتلقي بشعور الثقة بالراوي يبقى مهمّا لقبول الرواية، والسماح لها بالتسلل إلى ذائقته وذاته. ترى ما الذي صنعه الراوي لدى الشاعر في نص ((خطوةٌ في الضباب)) ليُقنع المتلقي بوقوع ما يروي؟.
استعمل الراوي أكثر من مدخل لإقناع المتلقي. أهمها؛ أنْ روى بضمير المتكلم. وهذا له دوره في مدّ جسور الثقة والدفع إلى التصديق. وهذه النقطة بحاجة إلى شيء من التفصيل. إذ يقسّم المعنيون بالسرد من حيث تعددية الضمائر المستعملة إلى ثلاثة أصناف ممكنة؛ فثمّة سرد بضمير الغائب (هو)، وسرد بضمير المخاطب (أنت) ، وسرد بضمير المتكلم (أنا)([6]).
والراوي في هذا النص يروي من خلال ضمير المتكلّم (أنا) الملتصق بـالكلمات: (أتوخّى، ظهري، كنتُ، أتلقّى، أُطيلُ، أُرامقُ، أرى، قلتُ، أمضي، أبصرتها، كنتُ منفردا، فإذا بي، التقيتُ، أمضي، أبصرتُها، أغلقُ، أنام، التقيتُ، أحملُ، أغِذُّ، أوقفوني). والسرد من خلال ضمير المتكلم يؤدي بالنهاية إلى أن يكون السارد شخصية مركزية، ويجعل المسرود مضمّخا بروح المؤلِّف الذي يسرد عنه، ويصير الراوي ملتصقا بالمؤلِّف. فضلا عن كونه يجعل المتلقي متعلّقا بالعمل السردي، متوهّما أنّ المؤلف شخصية حقيقية في تلك الحكاية، وهو يحيل السرد على ذات المؤلِّف أكثر من إحالته على الموضوع([7]). وكل هذا تحقّق في نص ((خطوةٌ في الضباب)) وكان من بين عوامل فاعلية النص، وكان من بين الآليات التي وظّفها الشاعر في نسج نصه، من خلال سلطة الراوي وحِيَلِه.
ومن بين آلياته في إقناع القارئ أنّ الراوي كان مشاركا في صناعة الأحداث. ولنا أن نستنير بتقسيمات علم السرد في هذا. فهم يقسّمون الراوي إلى أقسام عدّة، منها الراوي المشارك والراوي غير المشارك. وفي نص ((خطوةٌ في الضباب)) الراوي من نوع الراوي المشارك في صناعة الأحداث، وحاضر مع الشخصيات، ومشارك في صراع الشخصيات([8]). وهذا الواقع للراوي كان أحد عوامل الإقناع للقارئ بأن الراوي ثقة، فهو جزء من الحدث ومشارك مع الشخصيات في الصراع، وليس طارئا يتسقّط الأخبار عن الحدث والشخصيّات.
ومن آليات الراوي لإقناع القارئ أن كثّف الزمن، من خلال تكثيف القول. وهنا يكون من الضروري الإفادة من تقسيمات جيرار جنيت للزمن في السرد التي تفتح فضاءات لقراءة النص الذي فيه حضور كبير للسرد. ولاسيّما تلك الخاصة بعلاقة زمن السرد بزمن الحدث نفسه. فهذه العلاقة تنطوي على تقسيمات عدّة، منها ما قد يتساوى فيه زمن السرد مع الزمن الذي تطلّبه الحدث نفسه، وفي حالات أخرى يقل زمن السرد عن زمن الحدث، أي أنّ زمن القول تقلّص بسبب التكثيف في السرد([9])، وهذه الحالة الثانية كانت حاضرة كثيرا في نص ((خطوةٌ في الضباب))، وكانت إحدى آليات إقناع القارئ التي استخدمها الراوي. وكأنّه من خلالها يقول للمتلقي أنا لست معنيا بالتفاصيل، فلاحظ أيّها المسرود له بأنّي اختصر الزمن، وما يعنيني أن أُشركك في ردم الفجوات في السرد، فهذا شعر يهمّني فيه أن تكون أنت مؤوِّلا وفاكّا للشفرات وليس قارئا لنص ينتمي إلى جنس القصة.
وبناءً على هذا جاءت خصائص النص الشعرية لتؤكّد للمتلقي درجة شعرية هذا النص، فقد تعكّز الراوي في إقناع القارئ في سرده على ((الشعرية))، فهو يسرد للقارئ نصّا شعريا وليس قصة. ومن وسائل الإقناع بشعرية النص أن بُثت فيه الشعرية من خلال اللغة، فيجد القارئ صورا شعرية، مثل: ((يتقوّسَ في الحبس ظهري)) كناية عن طول الحبس وقسوة الظروف. و((انطواءِ النهار)) فالنهار صار كالثوب يُطوى، كناية عن انتهائه، وكأنّه كان منشورا فطُوي. و((أبصرتُها كالرداءِ المعلقِ في الحبلِ)) شبهها بقميص منشور على حبل تهزّه الريح فيتمايل. و((جارتَها تتسللُ في الثقبِ كالضوءِ أو كالدُخانِ)) فشبهها بما هو هلامي لا تحدّه صورة مادية. و((وأنام ساعةً، فلقد يتبدّدُ عني الغَمام))، والغمام السحاب الأبيض، وهنا شبّه ما يدور في رأسه بأنّه كالغمام، وهذا ضد الصفاء ويشوّش عليه الفهم والإدراك.
مثلما يجد المتلقي مفردات موظفة بطريقة شعرية تدغدغ ذائقته، وتدفع النص نحو صيغة الشعر لا النثر، مثل: ((ويبيـضَّ مني القَذال))، و((عَبْرَ نافذتي واتشاحِ الطريقِ الخريفيّ كنتُ أُرامقُ))، و((في ارتخاءِ الستارِ الخفيفِ المواربِ))، و((انصرفَ النُدلُ والطاعمون))، و((أرى وجهَها في الضباب الخريفيّ))، و((متمدّدةً تحت أغطيتي لا تَريم))، و((وأغِذُّ الخطى في العراء)).
ومن وسائل الشاعر/ الراوي في ضخ روح الشعرية في النص أن قدّمه القارئ محكوما بإيقاع شعري يمنحه بعض صفة الشعر التي اعتادت عليها ذائقة القارئ. فهو نص شعري يعتمد على توظيف صيغ بحر المتدارك (فاعلُن، فعِلن، فاعِلان، فَعِلَاتنْ)، في حين السرد في القصة مثلا لا يُوظِّف صيغ بحر شعريّ ليضبط الإيقاع الصوتي.
إنّ هذه الآليات المتنوّعة التي استعملها الراوي دفعت بالقارئ إلى أن يمدّ جسور الثقة مع الراوي؛ لأنّه يروي حدثا حصل له شخصيا، وبسرد متسلسل في إطاره العام، ولغته تدلّ على حضوره في الحدث، فهو يروي بصيغة المتكلم المشارك للشخصيات في الأفعال والأقوال. وهو يروي من خلال الشعر ويدرك خصوصية الشعر القائمة على بث روح المؤلف / الشاعر في النص للتأثير في المتلقي، وليس رواية أحداث وقعت وتُحيل على موضوع أكثر مما تحيل على ذات الشاعر.
بالنتيجة جاء النص شعرا مشبعا بروح الدراما وليس شعرا غنائيا، فهو على هيأة تشبه القصّة المتكاملة الأركان، فيه شخصيات ومكان وزمان وتسلسل في الأحداث، ثم نهاية أفضت الأحداث بالشاعر/ الراوي ليكون بيد الحرس ثم القضاء. وكان حضور السرد عنصرا رئيسا في بناء النص، وليس مقحما فيه. وكان هذا لسببين: الأول يعود إلى طبيعة الموضوع، فهي تستدعي وجود السرد؛ لأنّ النص يحكي حدثا سابقا لزمن كتابة النص ولابدّ أن يُروى. والسبب الثاني أنّ السرد بطبعه نظام انسيابي قادر على التغلغل في كلّ صيغ القول. وهو عابر لحدود الصيغ الأدبية كالشعر والمقالة والقصة (التي هي موطنه الأصلي). ويمكنه الولوج إلى كلّ الأجناس الأدبية بسلاسة، وكأنّه القاسم المشترك الممكن دائما.
لذا دخل السرد بفاعلية في نص ((خطوةٌ في الضباب))، غير أنّ المهيمن الشعري ظلّ حاضرا فيه، متمثّلا بخصائص الشعر. فهو جاء محكوما بإيقاع بحر شعري، وموجزا ومكتوبا بلغة مكثّفة، وفيه مفردات يحفل بها الشعر، وبُثّت فيه الصور الشعرية. وإن كان نوع الخيال الذي نسجه خيال كلّي تركيبي، من ذاك النوع الذي لا يقوم السرد إلّا من خلاله. ولم يكن في النص حوار تنطقه الشخصيات لتُحاور بعضها، على الرغم من كثرة الشخصيات فيه: (الشاعر/ الراوي، المرأة/ الشبح، المرأة الجارة، امرأة الشاي، الندل، الطاعمون، الحرس). لكن القارئ لا يجد سوى صوت الراوي، ولا يجد حوارا بصوت شخصية أخرى. لذا جاءت لغة النص على نسق واحد. فلا شخصيات متعدّدة تتحدث بأصوات متعدّدة، معبّرة عن مستواها الثقافي ومنحدرها الاجتماعي، لتكون لها لغتها الخاصة التي قد تختلف عن غيرها.
([1]) الفراشة والعكّاز (مجموعة شعرية)، حسب الشيخ جعفر، صدرت عن سلسلة ((كتاب الصباح الثقافي))، أصدرتها جريدة الصباح العراقية، بغداد، عام 2007.
([2]) بناء الشخصية (مقاربة في السرديات)، جويدة حماش، منشورات الأوراس، الجزائر، 2007: ص29.
([3]) اللغة والأدب، تودوروف، ضمن كتاب: اللغة والخطاب الأدبي، ترجمة: سعيد الغانمي، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء: ص48.
([4]) ينظر: الراوي والنص القصصي، دكتور عبد الرحيم الكردي، دار النشر للجامعات، القاهرة، ط2، 1996: ص94.
([5]) ينظر: المصدر نفسه: ص 94 .
([6]) ينظر: في نظرية الرواية، د. عبد الملك مرتاض، سلسلة عالم المعرفة، الكويت، 1998 : ص175-197.
([7]) ينظر: المصدر نفسه: ص184-185.
([8]) ينظر الراوي والنص القصصي: ص120.
([9]) ينظر: خطاب الحكاية (بحث في المنهج)، جيرار جنيت، ترجمة: محمد معتصم وآخرين، المجلس الأعلى للثقافة، ط2، 1997م: ص45-128.