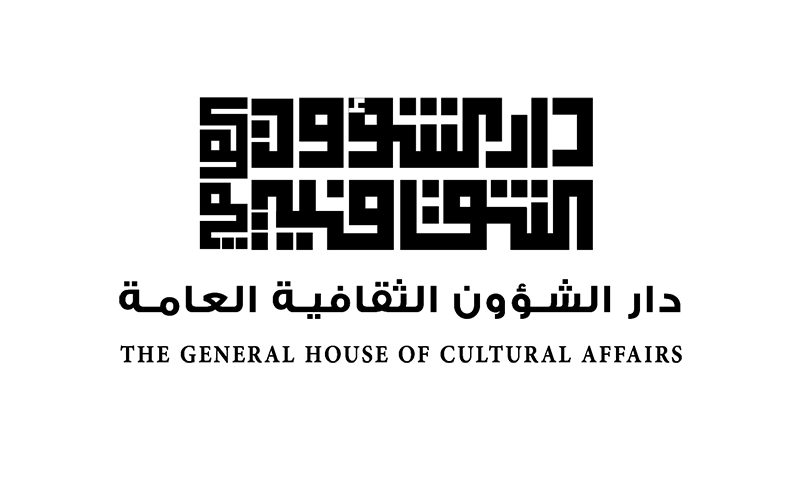الرئيسة
استِعادَة أودن
استِعادَة أودن
حنّة أرِن
ترجمة: غريب إسكندر
التقيتُ و. هـ. أودن في وقتٍ متأخر من حياته وحياتي - في عمرٍ لم يعد ممكنًا فيه الوصول إلى الصداقات السهلة والمميزة التي تنشأ في حياة الشباب، لأنّه لم يتبق ما يكفي من الحياة، أو يُتوقع أن يبقى لمشاركته مع شخصٍ آخر. وهكذا، كانت علاقتنا جيدة جداً ولكننا لم نكن أصدقاء حميمين. وفضلًا عن ذلك، كان هناك تحفظ فيه يثبّط الحميميَّة -الأمر الذي لم أعهده أبدًا معه. فقد احترمت تحفظه بسرورٍ، بوصفه سريّة ضرورية للشاعر العظيم الذي يجب أن يكون قد علّم نفسَه مبكرًا ألا يتحدث نثرًا، بصورةٍ فضفاضة وعشوائية، عن الأشياء التي كان يعرف كيف يقولها، بصورةٍ مُرضية أكثر، بكثافةٍ شعرية مركزة.
وقد يعود تحفظه الى طبيعة عمله شاعرًا. ففي حالة أودن، يبدو هذا أكثر احتمالًا لأنَّ الكثير من عمله، ببساطة شديدة، ينشأ من الكلمة المنطوقة، من تعبيرات اللغة اليومية -مثل: "Lay your sleeping head, my love, Human on my faithless arm". هذا النوع من الكمال نادر جداً؛ فقد نجده في بعض أعظم قصائد غوته، ويوجد، بالضرورة، كذلك في معظم أعمال بوشكين، والسمة المميزة لقصائد من هذا النوع هي أنَّها غير قابلة للترجمة. ففي اللحظة التي تُنتزع فيها من موطنها الأصلي، تختفي في سحابةٍ من الابتِذال. وهنا يعتمد كلُّ شيء على "الإيماءات البليغة" في "الارتقاء بالحقائق من النثري إلى الشعري" - وهي النقطة التي أكد عليها الناقد كلايف جيمس في مقالته عن كتاب أودن: (تَعلِيقة في كانون الأول (ديسمبر) من عام 1973). وإذ تتحقق هذه البلاغة، نقتنع وبطريقةٍ سحرية بأنَّ الكلام اليومي شاعري بشكلٍ خفي، وأنَّ آذاننا، التي درَّبها الشعراء، تنفتحُ على أسرار اللغة الحقيقية.
أنَّ عدم قابلية الترجمة لإحدى قصائد أودن هو ما أقنعني، منذ سنواتٍ عديدة، بعظمته. فقد جرَّبَ ثلاثة مترجمين ألمان حظهم وقتلوا بلا رحمة إحدى قصائدي المفضلة، "If I Could Tell You" (القصائد القصيرة 1927-1957)، التي نشأت بشكلٍ طبيعي من تعبيرين دارجين
"Time will tell" و "I told you so":
Time will say nothing but I told you so.
Time only knows the price we have to pay;
If I could tell you I would let you know*.
قابلت أودن في خريف عام 1958، لكنني رأيته من قبل، في أواخر الأربعينيات، في حفلٍ لإحدى دور النشر. وعلى الرغم من أننا لم نتبادل كلمة واحدة في تلك المناسبة، إلا أنني كما أتذكره جيدًا – كان رجلًا لطيف المظهر، وحسن الملبس، وإنكليزيًا للغاية، وودودًا ومُسترخيًا. الآن، وبعد مرور عشر سنواتٍ لم يكن بوسعي التعرف عليه لأنَّ وجهه يتسم بهذه التجاعيد العميقة والشهيرة، كما لو أنَّ الحياة نفسها قد رسمت مشهد الوجه هذا ليعرب عن "غضب القلب الخفيّ". وعندما تستمع إليه، فلا شيء يبدو أكثر خداعًا من مظهره هذا. فقد كان يستعمل مرحاض متجر الخمور القريب منه، لمراتٍ عدة، كما يبدو، عندما لا يكون قادرًا على التحمل أكثر لأنَّ شقته المتواضعة كانت باردة جدًا وأنابيبها المائية عاطلة. وكانت بدلته المبقعة والبالية والمُهَلهَلة لدرجة أنَّ سرواله ينزلق فجأةً وبسهولةٍ من أعلى إلى أسفل (لم يتمكن أحدٌ من إقناعه بأنَّ أيَّ رجلٍ يحتاج إلى بدلتين على الأقل، كي يتمكن من إرسال واحدة للتنظيف، وزوجين من الأحذية، كي يمكنه تصليح واحدٍ عند الحاجة: موضوع نقاش لا ينتهي استمر بيننا على مر السنين) - وكلما حدثت كارثة من هذا النوع، يدندن بنسخته المميزة جدًا من ترنيمة (عد بركاتك). ولأنَّه لم يتحدث أبدًا هراءٍ أو تكلم بسخفٍ ظاهر - ولأنني كنتُ على علمٍ دائمًا بأنَّ هذا كان صوت شاعرٍ عظيم جدًا - فقد استغرق الأمر مني سنواتٍ لأدرك أنَّ حالَهُ تلك لم تكن تظاهرًا مخادعًا. ومن الخطأ الفادح أن أنسب ما رأيته في أسلوب حياته إلى غرابةٍ بريئةٍ تصدر عن رجلٍ إنكليزي نموذجي.
لقد رأيتُ أخيرًا البؤس، وأدركتُ بطريقةٍ ما وبشكلٍ غامض حاجتَهُ الملحة لإخفائه وراء ترنيمة (عد بركاتك)، ومع ذلك وجدت صعوبة في فهم سبب كونه بائسًا للغاية وغير قادر على فعل أي شيء حيال الظروف السخيفة التي جعلت من حياته اليومية لا تطاق. وبالتأكيد لا يمكن أن يكون عدم الاعتراف به سببًا لذلك فقد كان مشهوراً إلى حدٍّ معقول، ومثل هذا الطموح، على أية حال، لم يكن له اعتبار كثير عنده، لأنه كان أقل نرجسية من بين جميع الكتّاب الذين قابلتهم على الإطلاق - محصنًا تمامًا من نقاط الضعف التي لا حصر لها للإطراء العادي. ليس لأنّه كان متواضعًا، بل الثقة بالنفس هي التي كانت تحميه من هكذا إطراء، وهذه الثقة بالنفس كانت موجودة عنده قبل الاعتراف والشهرة، بل قبل الإنجاز أيضًا. (أفاد جيفري غريغسون، في ملحق التايمز الأدبي، من الحوار التالي بين أودن الشاب الصغير وأستاذه في أكسفورد. الأستاذ: "وماذا ستعمل، سيد أودن، عندما تتخرج من الجامعة؟" أودن: "سأصبح شاعرًا". الأستاذ: "حسنًا - في هذه الحال ستكون دراستك اللغة الإنكليزية مفيدة جدًا". أودن: "أنت لا تفهم. سأكون شاعراً عظيمًا"). لم يتركه الشعر أبدًا، لأنه لم يحصل عليه بالمقارنات مع الآخرين، أو بالفوز في مسابقةٍ؛ كان الشعر بالنسبة له موهبة مترابطة، لكنها غير مُتَمَاثِلة، مع قدرته الهائلة على التعامل مع اللغة، وإنجاز ما يشاء بسرعةٍ.
(عندما طلب منه أصدقاؤه كتابة قصيدة عيد ميلاد تكون جاهزة في الساعة السادسة من مساء اليوم التالي، كانوا متأكدين من الحصول عليها؛ ومن الواضح أنَّ هذا يمكن فقط في حالة الثقة بالنفس). ولكنَّ حتّى هذا لم يبهجه، لأنه لم يدعِ، أو ربما حتى يطمح إلى، الكمال النهائي. كان يراجع باستمرار قصائده الخاصة، متفقًا مع فاليري: "القصيدة لا تنتهي أبدًا؛ هي تُهجر فقط". وبعبارةٍ أخرى، فقد كان متنعمًا بثقة نفسٍ نادرة من النوع الذي لا يحتاج إلى إعجابٍ وحسن رأيٍّ من الآخرين، بل ويمكنه أن يصمد أمام النقد الذاتي والمراجعة الذاتية من دون الوقوع في فخ الشك بالنفس. وهذا لا علاقة له بالغطرسة التي يسهل الخلط بينها وبينه. ولم يكن أودن متعجرفًا أبدًا إلا عندما يستفزه بعض الابتذال؛ فقد استطاع أن يحمي نفسه بما تتسم به الحياة الثقافية الإنكليزية من جفاءٍ شديد.
وأكد ستيفن سبندر، صديقه المقرب، أنّه "طوال تطور شعر [أودن] بأكمله... كان موضوعه الأساس هو الحب" (لِمَ لَمْ يخطر ببال أودن أن يُغيّر مقولة ديكارت "Cogito ergo sum" التي تُعرّفُ الإنسانَ بأنّه "مخلوق ذو دماغٍ فُقَّاعي" إلى "أنا محبوب إذن أنا موجود"؟)، وفي نهاية الكلمة التي ألقاها سبندر في ذكرى صديقه الراحل في كاتدرائيةٍ بأكسفورد أخبرنا عن سؤاله لأودن عن قراءة شعرية له بأمريكا: "أضاء وجهه بابتسامةٍ غيّرت خطوطه، وقال: "لقد أحبوني!" لم يعجبوا به، لقد أحبوه: هنا، على ما أعتقد، يكمن مفتاح تعاسته وعظمته الاستثنائيتين... حدّة شعره. والآن، عبر حكمة الاستعادة الحزينة، أرى أنّه كان خبيرًا في أنواعٍ لا نهائية من الحب غير المتبادل الذي يؤكده، بسخطٍ واضح، استبداله الحب بالإعجاب. ولابدَّ أنّ تحت هذه المشاعر كان هناك منذ البداية بَربَريّ حزين لا يمكن لأي عقلٍ أو إيمان التغلب عليه:
"رغباتُ القلبِ عَوجاءُ مثل المفاتيح/
ألّا يُولدُ الإنسانُ أفضل له/
الثاني في الأفضليَّة أمر شَكلِيّ/
مِعيار الرقص؛ ارقص وقتما تستطيع"
كما كتبَ في "صدى الموت" في (القصائد القصيرة). فعندما تعرفت عليه، لم يعد ليذكر "الأفضل"، لذلك اختار بحزم (الثاني في الأفضليَّة)، و(أمر شكليّ)، وكانت النتيجة ما أطلق عليه تشيستر كالمان ببراعةٍ "أكثر الأطفال المنضبطين فوضوية". وأعتقد أن هذا الحزن و"الرقص وقتما تستطيع" هو ما جعل أودن يشعر بانجذابٍ كبير إلى منزله ببرلين ذائعة الصيت في العشرينيات من القرن الماضي، حيث كان الاستمتاع بالحاضر يمارس باستمرار وفي أشكالٍ عدة. ولقد وصف ذات مرةٍ "إدمانه المبكر على العادات الألمانية" بـ "مرضٍ"، ولكن الأمر الأكثر بروزًا من ذلك، وكان يصعب عليه التخلص منه، هو التأثير الواضح لبيرتولت بريخت عليه الذي أعتقد أنه كان يشترك معه بأشياءٍ يصعب الاعتراف بها.
(في أواخر الخمسينيات، قام مع تشيستر كالمان بترجمة كتاب بريخت (صعود مدينة ماهاغوني وسقوطها) -وهي ترجمة لم تُنشر أبدًا حتَّى يومنا هذا، ربما بسبب صعوبات حقوق النشر. ولا أعرف إلى يومنا هذا ترجمة أخرى مقبولة لبريخت باللغة الإنكليزية). ومن الناحية الأدبية فقط، يمكن بسهولةٍ تتبع تأثير بريخت في قصائد أودن- فعلى سبيل المثال، في أواخر (أغنية بارنابي) الرائعة، حكاية المُهَرِّج الذي بعد أن كبر في السن والتقوى "كرّم السيدة العذراء" بهبوطٍ بهلوانيّ؛ أو قبل ذلك "قصة صغيرة/ عن الآنسة إيديث جي؛/ عاشت في كليفيدون تيراس/ رقم 83". وما جعل هذا التأثير ممكنًا هو أن كليهما ينتميان إلى جيل ما بعد الحرب العالمية الأولى، بمزيجه الغريب من اليأس وبهجة الحياة، وازدرائه لقواعد السلوك التقليدية، وميله إلى "اللعب بشكلٍ رائع"، الأمر الذي عبر عن نفسه بإنكلترا، كما أظن، في ارتداء قناع الغطرسة، بينما عبّر عن نفسه بألمانيا في تظاهرٍ شائع بالشر، وفي جزءٍ منه بمزاج (أوبرا البنسات الثلاثة) لبريخت. (في برلين، كان المرء يمزح عن هذا النفاق الملتوي العصري كما يمزح عن أي شيء آخر: "ربما يكون هذا هو كلّ الشّرّ الذي يمكنُهُ فعله". وبعد عام 1933، على ما أعتقد، لم يعد بإمكان أحد أن يمزح عن الشّرّ).
وفي حال أودن، كما هي حال بريخت، خدم النفاق الملتوي إخفاء ميلٍ لا يقاوم نحو الخير وفعله- وهو الشيء الذي يخجل كلاهما من الاعتراف به، ناهيك عن التصريح به. ويبدو هذا معقولًا بالنسبة لأودن، لأنّه أصبح مسيحيًا في النهاية، ولكن قد يكون صادمًا سماع ذلك عن بريخت مسبقًا. ومع ذلك، يبدو لي أن القراءة المتأنية لقصائده ومسرحياته تثبت ذلك على الأرجح. وليس هذا موجودًا فقط في مسرحيات مثل (الإنسان الطيب في سيتشوان) و(جان قديسة المسالخ) ولكن ربما بإقناعٍ أكثر، في هذه السطور من (أوبرا البنسات الثلاثة) التي تصور الأمر بسخريةٍ بالغة:
Ein guter Mensch sein! Ja, wer wär’s nicht gern?
Sein Gut den Armen geben, warum nicht?
Wenn alle gut sind, ist Sein Reich nicht fern.
Wer sässe nicht sehr gern in Seinem Licht?
أنَّ ما دفع هؤلاء الشعراء غير السياسيين بعمقٍ إلى المشهد السياسي الفوضوي في قرننا ]القرن العشرين[ هو مفهوم "الحماسة الرحيمة zèle compatissan" لروبسبيي ، الدافع القوي "للبؤس"، بوصفه مميّزًا عن أية حاجةٍ لفعلٍ موجه نحو السعادة العامة، أو أية رغبةٍ في تغيير العالم.
كان أودن أكثر حكمةٍ -وإن لم يكن أذكى بأي حالٍ من الأحوال - من بريخت، فقد عرف مبكرًا أنَّ "الشعر لا يصنع شيئاً". وبالنسبة إليه، كان محض هراء أن يدَّعي الشاعر بأنَّ له امتيازاتٍ خاصة، أو يطالب بصكوك غفرانٍ نمنحها له برضى تام بدافع الامتنان المطلق. لم يكن هناك شيءٌ أكثر إثارة للإعجاب بأودن من قدرته العقلية التامة وإيمانه الراسخ بها؛ مع أنَّ في عينيه تتمردُ أنواعُ الجنونِ بأسرها- "شَقِيّ، شَقِيّ"، كما كان يقول. كان الشيء الرئيس هو لا للأوهام ولا للتسليم بالأفكار -لا للأنظمة النظرية- التي من شأنها أن تعميك عن الواقع. لقد انقلب على معتقداته اليسارية المبكرة لأنَّ الوقائع (محاكمات موسكو، واتفاقية هتلر وستالين، وتجارب الحرب الأهلية الإسبانية) أثبتت أنَّها "غير شريفة" و"مخجلة" كذلك، كما أطلعنا، في تقديمه لــ"القصائد الأقصَر"، على ما كتبه ذات مرةٍ:
التاريخ للمهزومين
قد يقولُ وأسفاه لكنَّهُ لا يُغيثُ ولا يغفر.
وقول هذا، كما أشار هو، يعني "تطابق الخير مع النجاح". واحتج على أنَّه لم يؤمن أبدًا بـ"هذه العقيدة الشريرة" -عبارة أشكُ فيها، ليس فقط لأنَّ الأسطر جيدة ودقيقة للغاية بحيث لا يمكن إنتاجها فقط لأنَّها "فعّالة بلاغيًا" بل لأنَّ هذا كان المذهب الذي آمن به الجميع في العشرينيات والثلاثينيات. ثم جاء وقت
في كابوس الظلام
كلُّ كلاب أوروبا تنبح...
وصمةُ عارٍ فكرية
في وقتٍ بدا فيه الأمر لمدةٍ طويلة وكأن الأسوأ يمكن أن يحدث وأنّ الشر المطلق يمكن أن ينجح. كان تتجلَّى على كلِّ وجهٍ بشريّ
اتفاق هتلر وستالين نقطة تحوّل لليسار؛ الآن يجب على المرء أن يتخلى عن أيّ إيمانٍ بالتاريخ بوصفه حكمًا نهائيًا للقضايا الإنسانية.
أما في الأربعينيات، فقد كان هناك الكثير ممن انقلبوا على معتقداتهم القديمة، مع أنَّ عددًا قليلًا جدًا منهم فهموا خطأ هذه المعتقدات. وبعيدًا عن التخلي عن إيمانهم بالتاريخ والنجاح، قاموا ببساطةٍ، إذا جاز القول، بتغيير القطارات؛ من قطار الاشتراكية والشيوعية الذي كان خاطئًا، إلى قطار الرأسمالية أو الفرويدية أو الماركسية المصقولة بعض الشيء، أو إلى مزيجٍ متطور من الثلاثة. ولكن أدون، بدلاً من كلّ ذلك، أصبح مسيحياً؛ أي أنّه ترك قطار التاريخ تمامًا. ولا أعرف ما إذا كان ستيفن سبندر محقًا في التأكيد على أنَّ "الصلاة تتوافق مع حاجته العميقة" -أظنُ أنَّ حاجته العميقة كانت، ببساطةٍ، كتابة الشعر- إلا أنني متأكدة، عن تأملٍ، من أنّ أصالة آرائه، الإحساس الرائع العظيم الذي أضاء جميع كتاباته النثرية (مقالاته وعروضه للكتب) ترجع، بشكلٍ غير قليل، إلى الدرع الوقائي للإيمان؛ لأنَّ معناه المتماسك التليد الذي لا يمكن إثباته أو دحضه بالعقل قد وفر له، كما هو الأمر مع تشيسترتون، ملجأً مريحًا من الناحيتين الفكرية والعاطفية ضد هجوم ما أسماه "الهُراء"؛ الذي يعني حماقات العصر التي لا تعد ولا تحصى.
وبإعادة قراءة قصائد أودن بترتيبٍ زمني وتذكُّره في السنوات الأخيرة من حياته، عندما نما البؤس والتعاسة أكثر فأكثر من دون أن يؤثرا على الهبة الإلهية أو البراعة المباركة للموهبة، أصبحتُ متأكدة أكثر من أي وقتٍ مضى أنه "تأذّى في الشعر" أكثر من ييتس "إيرلندة المجنونة تؤذيك في الشعر"، وأنّه على الرغم من قابليته للتعاطف، لم تكن الظروف السياسية العامة، بالضرورة، تؤذيه في الشعر. فما جعله شاعراً كان قدرته الاستثنائية على التعامل مع الكلمات وحبّه لها، ولكن ما جعله شاعراً عظيماً هو الاستعداد غير المبرر الذي استسلم به لـ "لعنة" الضعف أمام "فشل الإنسان" على جميع مستويات الوجود الإنساني - الضعف تجاه اعوِجَاج الرغبات، وخيانات القلب، وظلم العالم.
اتَّبعْ أيُّها الشاعرُ، اتَّبعِ الحق
إلى أعماق الليل،
بصوتِكَ الحُرّ
الذي لا يزال يحُثُّنا على البهجة؛
احرثْ بيتًا من الشعر
واصنعْ كُرُومَ اللعنة.
غنِّ فشلَ الإنسان
بنشوةِ الشجن؛
في صحاري القلب
دعْ ينبوع السكينة يتفجر،
وفي سجنِ أيامِهِ
علِّمَ الإنسانَ الحُرَّ كيفيةَ الحمد.
الحمد هو الكلمة الأساسية لهذه الأبيات، ليس حمد "أفضل ما في العوالم الممكنة" - على الرغم من أنَّ الأمر متروك للشاعر (أو الفيلسوف) لتبرير خلق الله - ولكنَّ الحمد الذي يضع نفسه ضدَّ كلّ ما هو غير مرضٍ للغاية في شأن الإنسان على هذه الأرض، ويمتص قوته من الجرح: مقتنعًا بطريقةٍ ما، كما كان شعراء اليونان القديمة، أنَّ الآلهة تنسج التعاسة والأشياء الشريرة على البشر حتى يتمكنوا من سرد الحكايات وإداء الأغاني.
يمكنني (ولا يمكنكَ)
أن أبحثَ، بسرعةٍ كافية، عن أسبابٍ
لمواجهةِ السماء
وزئيرِ الغضب واليأس
حول ما يجري،
مطالبًا بذلك تسمية
مَنْ يقعُ عليه اللوم:
السماءُ ستنتظرُ فقط
حتّى تذهب كلُّ أنفاسي
وحينَئِذٍ تردِّد،
كما لو أنني لم أكن هناك،
هذا الأمر الغريب
الذي لا أفهم معناه،
باركْ ما هو موجود،
ما تجب طاعتُهُ،
ما صُنِعتُ أنا لأجله كذلك،
برضِى أو من دونه؟
وكان انتصارًا للشخص العادي أنَّ صوتَ الشاعر العظيم لم يسكت أبدًا، كان صوتًا صغيرًا لكنه نفذ إلى الحس السليم النقي العام الذي غالبًا ما تكون خسارتُهُ هي الثمن المدفوع مقابل الهدايا الإلهية. لم يسمح أودن لنفسه أبدًا أن يفقد عقله - أي أن يفقد "الشجن" في "النشوة" الأمر الذي نشأ عنه:
لا استعارة، تَذَكَّرْ، يمكنها أن تعبر
تعاسة تاريخية حقيقية؛
دموعُكَ لها قيمة بشرط ابتهاجنا؛
آه أيّها الأسى السعيد! هو كلُّ ما يمكن أن يقوله الشعر الحزين.
ويبدو، بالطبع، أنَّه من المستبعد جدًا أن يعرف أودن الشاب، عندما قرر أن يكون شاعرًا عظيمًا، الثمن الذي سيتعين عليه دفعه، وأعتقد أنّه من الممكن تمامًا في النهاية -حين لا تكون شدة مشاعره ولا موهبة تحويلها إلى حمد، بل القوة الطبيعية الشفافة للقلب التي تحملت كلَّ ذلك وعاشت معه إلى أن تلاشى تدريجياً-أن اعدَّ الثمن باهظاً. ونحن، على أية حال -جمهوره وقرائه ومستمعيه- لا يسعنا إلا أن نشعر بالامتنان لأنه دفع ثمنه حتى آخر قرشٍ مقابل المجد الأبدي للغة الإنكليزية. وقد يجد أصدقاؤه بعض العزاء في هَزله الجميل وهو في العالَم الآخر -وذلك لأكثر من سبب، كما قال سبندر، "اختارتْ نفسُهُ اللا واعية الحكيمة يومًا جميلًا للموت". أنَّ حكمة معرفة "متى تحيا ومتى تموت" لا تُمنح للبشر، لكنَّ ويستان، كما يود المرء أن يفكر، ربما يكون قد نالها بوصفها المكافأة العليا التي تنعم بها آلهة الشعر القاسية على أكثر أتباعها طاعة.
* ذكر أرِندت القصيدة كاملةً مثالاً عن الشعر اليومي الذي تصعب ترجمته، ولهذا السبب أمتنعت عن ترجمتها واكتفيت بذكر المقطع الأول منها فقط. (المترجم)
المصدر:
The New Yorker January 12, 1975hglw